النباهـــة والاستحمــــار(الحلقة الثانية)
- تم النشر بواسطة وليد مانع / لا ميديا
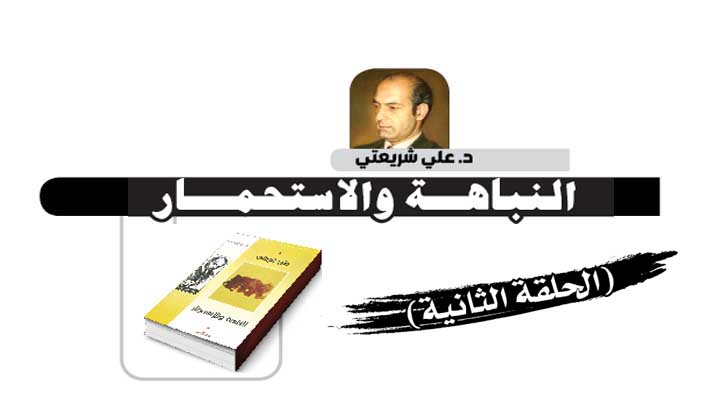
بسبب انبهارها وانجرارها وراء الغرب الاستعماري، ثقافياً وسياسياً على وجه الخصوص، فإن المنطقة العربية ما تزال شبه مغيبة عن الاطلاع على الإرث والأثر الفكري والعملي للدكتور الشهيد علي شريعتي، رغم شهرته الواسعة، ورغم حاجتها إليه.
فمن بين كل مفكري العالم، يكاد يكون شريعتي وحده الذي آمن بما لدى شعوب العالم المقهورة والمجتمعات المستضعفة، من ذخائر وكنوز روحية ومعنوية لا ينقصها سوى الالتفات إليها وحُسن استثمارها، لتجعل من أولئك المقهورين والمستضعفين قوة قادرة على مواجهة أعتى قوى العصر المادية، بجيوشها وأسلحتها وتكنولوجيتها وأموالها...
من هنا، اختارت صحيفة «لا» كتاب «النباهة والاستحمار» كي تقدم به لقرائها نموذجا من الإرث الفكري الجليل للدكتور الشهيد علي شريعتي.
في كل يوم
هذا الموجود ذو القيم الإلهية يسعى خلف رزقه اليومي. هذا الرزق القاتل للإنسان الحي، هو الهوة التي تغور فيها أعز قيم الإنسان الإلهية كل يوم.
في الحياة اليومية، تلك الحياة الدورية، التي فرضت وجودها على كل الكائنات الحية، من ذوات الخلية الواحدة والجراثيم، إلى الحيوانات الكبيرة والنباتات، توقع الإنسان في ذاك الدوران الأحمق؛ الدوران الذي يأكل فيه الإنسان، فينام، فيستيقظ، فيكدح ليأكل، ثم يأكل ليكدح، فيأكل من أجل أن يعمل، يعمل لوقت فراغه، فراغ لعمل إنتاج واستهلاك الإنتاج، أينما تنظر تراه دوران... كـ»الحمار» تماماً، يسير صباحاً، فيسير بجهد وتعب، يسير ويسير، فيرى أول الليل مكانه أول الصبح... دوران، فدوران، فدوران... هذه الدائرة الشنعاء هي مسيرة الإنسان وتاريخه في الوقت الحاضر والماضي، متحضراً كان أم غير متحضر، شرقياً كان أم غربياً. في هذا الدوران الباطل تطرأ على الإنسان مشاعر خاصة: فاقات، عقد، ضغائن، أهواء، أحساد، وآلام خاصة، إلى حد يُعجز الإنسان النبيه. قد ترون أحياناً أحداً يشكو ويتعب ويضج ويمهّد، ليعرب عن ألم... هو مضحك جداً! ينبغي أن يضحك من بلاهته! لو أعددنا قائمة لمجموعة من الأشياء التي نتمناها في حياتنا اليومية وننعم بها، أو نأمل الحصول عليها، أو نغبط الآخرين عليها، ونسعى للحصول عليها، فإن لاحظناها بوعي وانتباه لاستنكرنا أنفسنا، واستقبحنا وجودنا، واستعبنا حياتنا. فحين يدرك الإنسان هذه الأشياء تدريجياً ويدرك القضايا الخارجة عن إطار نفسه وبيته، يشعر براحة. مثلاً إذا كان في بيته شيء لم يكن له مثيل في بيوت الآخرين في منطقته، أو يبتاع قطعة قماش كانت وحيدة في نوعها عند البزاز وقد ساعدته الظروف على شرائها، ولو كان قد تأخر في حضوره عند البزاز، لخرجت من يديه، وابتاعها شخص آخر، فيلبسها في المحافل بدل أن يلبسها هو، وعندئذ وا ويلاه ما أبأسه وما أشقاه!
ثم ما أكثر اللذات والحسرات والتنكرات والمؤامرات، وبعدها التمهيدات، ثم التضحية بكل شيء لا يُقدَّر ثمنه عند الإنسان الذي يختال فخراً، ويعلو رأسه إلى عنان السماء ليصل إلى الله... نراه يتقبل الذل إلى حد يأباه الكلب، من أجل رتبة أو درجة دنيّة إلى أبعد الحدود ضمن إطار القيم! ومن هنا تعرف قابلية الإنسان في الصلاة والشقاء، إنها ما وراء كل الموجودات.
قد ترون أن إنساناً يكاد أن يصاب بنوبة تقضي على حياته من شدة فرحه، يجول في داره ويرقص لنفسه؛ لماذا؟! لأنه لمح سيادة الرئيس في الدائرة صباحاً، عندما كان يخطو على السلم، فرأى في نظرته إليه شيئاً من الرضى! نصف بسمة ظهرت على شفتي الرئيس، كما تظهر على شفتي صاحب الكلب حينما يقدم إلى كلبه اللذائذ!...
لو أعددنا قائمة بالأشياء التي توصف بأنها «لذيذة»، الأشياء التي ما زالت تجول في أذهاننا، ونسعى للحصول عليها، سواء كانت: ألبسة، سيارة، داراً، مقاماً، درجة دراسية أو صديقاً... لرأينا أي غال ونفيس نضحي به من أجلها! نضحي بالزمان والإنسان، بالذكاء والنباهة، بالقابلية والفخر الإلهي للإنسان، بإمكانية التمرد، بقابلية الانتخاب والاختيار الحر، بقابلية قوة الرفض، بقوة البناء والتشييد، بقوة التغيير وتبديل المصير، بقوة الرفض لكل ما حملنا واستبداله بما نريد، نضحي بكل هذه الأمور بدون أن نشعر، وبدون أن نملك لحظة من الزمان نتأمل فيها. وهكذا نجد الإنسان في حياته اليومية متجهاً إلى خارجه دائماً، ومقبلاً على ما يوفر له لذائذه، ميالاً إلى شهواته. ونجد «أنا»، تلك «الأنا» التي هي من الله، تهبط من العرش إلى حضيض الأرض، فتنغمس كالدودة في الماء المتعفن بالقذارات وتهش للجيفة.
ثم تتقطع «الأنا» ذات الوجود المتصل قطعةً قطعة، وتقع كل قطعة منها في مصيدة شهوة قذرة وهوى أجوف وأُمنية سخيفة!
والمحصلة هي: التضحية بأعز الأشياء من أجل الحصول على أسخف الأشياء وأقذرها!
هزّة
لا أريد أن أنصح أخلاقياً، فالإنسان يمضي ليصير إلى الفناء. ويزداد دمار قيمه الإنسانية بمرور الأيام. إن أكبر قيم الإنسان هي تلك التي يبدأ منها بـ»الرفض» و»عدم التسليم»، اللذين يتلخصان بكلمة «لا»، ومنها بدأ آدم أبو البشر. أُمِرَ أن لا يأكل من تلك الثمرة؛ لكنه أكل، فصار بعدئذ بشراً وهبط إلى الأرض، وإلا لكان مَلَكاً لا ميزة له، ولصار غيره آدم، ولفُرِضَ عليه أن يسجد أمامه؛ لكنه تمرد فصار آدم. وأول ما يبدأ آدم بهدمه في حياته اليومية فيضحي به هو «التمرد».
التمرد! هذا التمرد الذي جعله مشابهاً لربه في الكون؛ لماذا؟! قد يكون أحياناً من أجل دَيْن وقّع سندات للوفاء به خلال سنتين أو ثلاث أو أربع سنوات، فلا يمكنه الإنكار بعدها مهما بلغ به الأمر، ولا يسعه عند المطالبة إلا أن يقول: سمعاً وطاعة، لأنه دينه موزعاً على عدد السندات، وحسب راتبه ودخله وإمكانياته.
ومن هنا نرى أن صفته الإلهية تذهب ضحية من أجل دار أو سيارة. هذا الإنسان لا يدري أي شيء خسر، وأي شيء نال بدل الذي خسره! ولا يدري بأي شيء يتلذذ، وكم هو قدر لذته بنعمة السيارة التي ضحى من أجلها بعدم استسلامه، وبقابلية أُلوهيته، وكونه خليفة الله في أرضه، حتى يساوي لذة تمرده ورفضه!
لا شك أن من أدرك لذة التمرد والرفض والقيم الأخلاقية والنباهة، لن يبدلها بأي شيء، ولن يبيعها بأي ثمن. ولكن ماذا حدث حتى بدلنا ذلك بسهولة؟! المسألة هي أنه لا نباهة لنا، فنحن لا نستقيم إلا إذا اعتلتنا يد قوية، أو سوط قاس، يظل فوقنا مدى حياتنا. عندما نكون منشغلين بشدة في الليل والنهار، وحتى في نومنا، وفي غفلة شغلنا الإداري والعائلي، ترفعنا تلك اليد، فتهزنا من هذا الكرش الأحمق الذي ما زال يدور بنا، ولم نشعر بما مضى من الزمن، وما فات من العمر، وكم بقي منه، وكم سوَّفنا من الفرص، وكم ضيعنا من النعم والقيم والكمالات، لانشغالنا بغيرها! وتخرجنا تلك اليد من بين القذارات وتجففنا تحت أشعة الشمس، ثم تضربنا على الجدار بشدة وتقول لنا: أنت! أنت!
العبث
هذا إبراهيم الأدهم()، رجل لا خير فيه ولا جدوى، ذو ثروة عظيمة ومال طائل، عاطل، لا أُنس ولا عمل له غير الصيد. غيره يكدح وهو يأكل. ماذا يعمل؟! يذهب للصيد، اعتاد على الصيد حتى أنس إليه، وصار شغله الوحيد، يفرح إذا اصطاد من الوحش أماً أو أباً أو ابناً، فيمتلئ سروراً وقهقهة. لا حاجة له بلحمه أو جلده، سوى أنه يجد لذة لذلك. إنه داء قذر أن ينصرف إنسان بتلك العظمة كلها إلى عمل كمثل هذا لتحقيق لهوه. هذه هي فلسفة حياته. إنها اسطورة؛ لكنها أصدق من الواقع.
بينما كان يطارد صيداً ذات يوم، وقف شخص في وجه فرسه، فوقفت الفرس في مكانها، ولم تتحرك. وإذا بصوت هاتف كأنه الرعد يشق مسامعه: «يا إبراهيم! ألهذا خلقك الله؟!». أحجم إبراهيم، «انتبه»، توقد انتباهه! أنت! أنت!...
نحن -لا، «أنا»- غير منتبهين «أنا»! لسنا واعين لأمور ننسبها إلى أنفسنا كذباً، وفي الوقت نفسه «نحن» محرومون أكثر من أي شخص. أنت! كأنه ولأول مرة تتعرف على شخص اطلع على وجود عظيم. وقف، فرجع؛ لكنه رجع «إبراهيم الأدهم»، نعم إبراهيم الأدهم الذي يشعر الإنسان أمام رفيع درجته وعلو مقامه بالصغر والتضاؤل!
المتنعم بالدلال
هكذا كان! كان أميراً يعيش في قفص من ذهب أُعِدَّ له، وقد صبّ إليه كل شيء في حظيرته، كل شيء هُيّئ له. استحدثوا له غابة ووضعوا حولها صيداً ليكون جاهزاً له متى متى! وفي مكان آخر مسابح ذات ألوان مختلفة، وفي كل مسبح شجرة من النيلوفر بلون خاص. حدائق، قاعات، ملاهٍ، راقصات... خرج يوماً من القفص فرأى ميتاً.
ـ ما هذا؟!
ـ هذا مصير الإنسان.
ـ وأنا أيضاً؟!
ـ نعم!
ـ ما هو الموت؟!
ـ الموت حالة تصيب كل واحد في نهاية عمره.
ـ وبعدها كيف يكون؟!
ـ يصبح الإنسان جيفة، كل من كان وأينما كان.
وفي اليوم التالي رأى مريضاً:
ـ من هذا؟!
ـ مريض.
ـ ما هو المرض؟!
ـ المرض عرض يصيب الإنسان قبل موته، قليلاً أو كثيراً، شديداً أو ضعيفاً.
ـ أنا أيضاً يصيبني؟!
ـ نعم! المرض لا يهتم بحصار ولا جدار ولا حاجب.
وفي اليوم الثالث:
ـ من هذا المحنية قامته؟!
ـ هذا شيخ عجوز هرم.
ـ ما هو العجز والهرم؟!
ـ هو مصير محتوم لكل إنسان.
ـ وحتى أنا أيضاً؟!
ـ نعم! حتى أنت.
وفي اليوم الرابع:
ـ هذا سائل مسكين.
ـ ما هو السائل المسكين؟!
ـ هو الإنسان ذو الفاقة الذي لا يملك إلا حفنة الشحاذة ليكون طفيلياً عند هذا وذاك لشبع بطنه.
هذه الصدمات الأربع تُنبّه ذلك الرجل الذي يسرح ويمرح في جنة، يعيش في هدوء محض ورفاهية محضة وفي شبع وتمتع محض من كل شيء وفي جهل محض.
تنبهه هذه الصدمات الأربع التي لا تعرف أميراً ولا «بوذا» ولا... فيدرك فجأة في أي راحة قذرة، وأي لذائذ جوفاء كان يعيش، وأي شيء وأي ثروات مجهولة له ظلت منسية تحت ضجيج تلك اللذات الكاذبة! وعندها يتمرد؛ إذ «الشيء الوحيد الذي يستطيع الإنسان وحده أن يعمله، هو أن يفر منها جميعاً كوحيد القرن. يرحل بلا تشويش وبدون حسرة للعودة، أو تفكير في عطش أو حاجة للحياة في قصر بنارس! حرّا! حرّاً!»(). كرأس شجرة الخيزران، طليقاً من قيد الاعوجاج. أما أنت، الذي في أسر بيتك وثروتك وسعادتك، كشجرة مليئة بالثمار تدلت أغصانها إلى الأرض، وأوشكت على الانكسار، بينما رؤوس أغصان السرو الممتدة نحو الشمس لا تخضع لثقل، فهي حرة من كل اعوجاج كرؤوس الخيزران، كالنيلوفر، بعيدة عن درن المياه! يتفتح في الماء، لكنه يخرج منه، يخرج من الطين فيتفتح على الماء، ليصير كله فماً واحداً مقابلاً لأشعة الشمس، فيجف بعيداً عن بلل المياه وإن كان نموه فيه. وأنت! يا من تجلى الله فيك، أنت في دوامة خُلقت للحيوانات والنباتات! و»أنت» الذي خلقت منها كلها، أنت يا من خاصتك الـ»لا»، أنت! كالنيلوفر تحت أشعة الشمس، تشع داخل مجهول لا تعلمه، فاجعل وجودك كله واحداً مرتضعاً، لتنبذ كل المظاهر والجدالات والأهواء والجاذبيات التي مزقت حياتنا اليومية، ضحية لنا ولشهواتنا وأعدائنا وأحقادنا وحسراتنا اليومية... تلك الأمور السخيفة المنحطة المحقرة للإنسان، التي جعلته لعبة جسدت فيه خصائص حيوانات، كالفأر والذئب والخنزير، لأنه نسي سيادته وعزته وألوهيته وخلافته لله في أرضه.
نسي قابليته وقيمه التي لم تُعطَ لغيره، واستهلك نفسه وبذلها وضحّى بها وعبّدها لغيره، وتملّق بسهولة ولم يشعر أنه ضحى بكل إنسانيته بالثناء الكاذب على الغير، من أجل الحصول على بغيته. إنه خسران مهما ربح! لأن الإنسان إذا قتل شخصاً فإنه يبقى إنساناً وإن كان قاتلاً، بينما الذي يطأطئ رأسه أمام غيره أو يتملقه، لا يبقى إنساناً! لكنه لا يشعر. يعدّ السرقة والقتل أمراً قبيحاً، بينما لا يستقبح التملُّق؛ لأنه يخسر شيئاً في تعبده وخضوعه للغير لا يعرف ثمنه.

.jpg)
















المصدر وليد مانع / لا ميديا