النباهـــة والاستحمــــار (الحلقة الثالثة)
- تم النشر بواسطة وليد مانع / لا ميديا
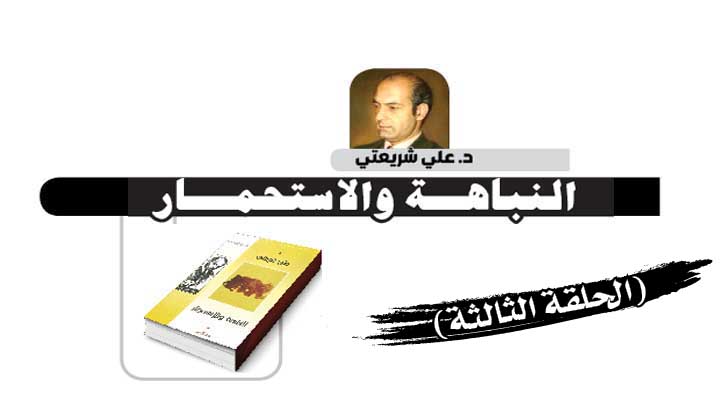
بسبب انبهارها وانجرارها وراء الغرب الاستعماري، ثقافياً وسياسياً على وجه الخصوص، فإن المنطقة العربية ما تزال شبه مغيبة عن الاطلاع على الإرث والأثر الفكري والعملي للدكتور الشهيد علي شريعتي، رغم شهرته الواسعة، ورغم حاجتها إليه.
فمن بين كل مفكري العالم، يكاد يكون شريعتي وحده الذي آمن بما لدى شعوب العالم المقهورة والمجتمعات المستضعفة، من ذخائر وكنوز روحية ومعنوية لا ينقصها سوى الالتفات إليها وحُسن استثمارها، لتجعل من أولئك المقهورين والمستضعفين قوة قادرة على مواجهة أعتى قوى العصر المادية، بجيوشها وأسلحتها وتكنولوجيتها وأموالها...
من هنا، اختارت صحيفة «لا» كتاب «النباهة والاستحمار» كي تقدم به لقرائها نموذجا من الإرث الفكري الجليل للدكتور الشهيد علي شريعتي.
أمثال وحكم
كان أحد المدرسين يعظني موعظة مليئة بسوء الأدب؛ لكنها بليغة جداً. كان يعظ ويقول إنه "لا ينبغي على الإنسان أن يكون شديداً على الآخرين، بل ينبغي عليه أن يكون ذكياً محافظاً على منافعه، وألا يسوّف في الفرص. وأنه لا مشكلة في أن يقول الإنسان: إن هذه اللحية –والتي هي من علامات شرف الرجل ووقاره– ليست ذات أهمية، قد تقتضي المنافع والظروف أحياناً أن يضعها الإنسان في ما تحت الحمار من أجل المنافع! ثم يخرجها، ويغسلها بالشامبو والصابون ويعطرها، فتكون لحية في محلها ولا شيء عليها! ولم ينقص منها شيء! بل تكون قد قضت حاجته» هذه هي فلسفة حياتنا اتضحت بوقاحة، لكن أعمالنا أوقح منها".
الوعي.. بين النباهة الفردية والاجتماعية
إن الشيء الذي يدعوني دائماً من خارج هذه المشاغل التي تجعلني ضحية لها، ويدفعني إلى نفسي، هو النباهة الفردية، أو النباهة الذاتية. تدفعني أمام المرآة كل مرة لأرى "ذاتي". نعم، لا أحد يرى صورته الحقيقية نصب عينيه، حتى أولئك الذين يقفون أمام المرآة كل يوم ثلاث أو أربع ساعات، ما اتفق أن رأوا أنفسهم!
المعرفة الذاتية أو الدراية أو نباهة الفرد عن ذاته، هي فوق المعرفة الفلسفية والعلمية وفوق الصنعة؛ لأن هذه كلها مجرد معرفة، وليست "معرفة ذاتية"، أي: ليست الشيء الذي يريني ذاتي، يستخرجني فيعرّفني ذاتي، الشيء الذي يلفت انتباهي إلى قدري وقيمتي... فقيمة كل شخص تكمن في إيمانه بذاته. كم حقرونا! انظروا إلى أنظمتنا التربوية والاجتماعية! لقد حقرونا إلى حد أن أصبحنا لا نؤمن بقدراتنا؛ أي أنه تم إنكارنا ذلك الإنكار الذي تأباه حتى صغار الحيوانات، فهي تأبى أن ترى ذواتها عاجزة إلى هذا الحد!
نحن عاجزون عن الانتقاد، عن الاستفسار، وحتى عن الكلام!... أصبحت سمتنا عدم الصلاحية، لا نجرؤ أن نتصور أنفسنا قادرين على أي عمل صغير! هكذا، وإلى هذا الحد نحن حقراء غير مؤمنين بأنفسنا!
ولا شك أن الجيل الذي يحتقر ذاته يغدو حقيراً بالفعل. فسياسة الاستعباد والاسترقاق تقتضي التحقير أولاً؛ تحقير ذلك الذي يراد استعباده، حتى يظن أنه من طبقة دنيا وأسرة منحطة، ثم يتقبل الذل والعبودية بكل ترحاب.
أصغر فأصغر
ماذا فعل بنا الغرب، نحن المسلمين، نحن الشرقيين؟!
احتقروا ديننا ولغتنا وأدبنا وفكرنا وماضينا وتاريخنا وأصلنا. كل ما عندنا وما لدينا استصغروه، حتى أخذنا نحن نستصغر أنفسنا. أما هم فقد فضلوا أنفسهم وأعزوها، ورفعوها حتى صدقنا أن جهودنا جميعها وآمالنا ومساعينا ليست إلا تقرباً وامتثالاً ومماثلة وطاعة لهم، وذهبنا نقلدهم في الأزياء والأطوار والحركات والكلام والمناسبات... وبلغ بنا الأمر أن مثقفينا يفخرون بأنهم نسوا لغتهم الأصلية!
ما هذه السخافة؟! هكذا يفخر الإنسان بسخافته وفقدان شعوره! أنه لأمر عجيب! لا يفخر فقط بأنه تعلم اللغة الأجنبية، بل يفخر بأنه نسي لغته الأصلية! ما أشبهه بالطفل الذي تهينه أمه وتضربه، فيلجأ إليها ليأمن سخطها! فالعنصر الأفضل، والشعب الأفضل، وحتى الإنسان الأفضل، يحقر قوما أو شعبا أو إنسانا آخر ليسيطر عليه ويستعمره! يحقر دينه وإيمانه وأدبه وفكره وكبار رجاله وماضيه... وكل ما لديه، فيفر المُهان من تلك الأمور التي سببت إهانته والاستخفاف به، ويلجأ إلى ذاك المصدر الذي شنع به وعابه، ويحاول الظهور بمظهره وعلى شاكلته، لئلا يقع تحت طائلة الاتهام والتشنيع.
ومن هنا نرى أن بعض الأشياء يتخذها الأجانب بضائع استهلاكية، بينما لا نعتبرها نحن استهلاكية، بل أشياء نموذجية! 15% من الأوروبيين يأنسون باللحن الكلاسيكي، أما الإيرانيون فكلهم يحفلون بكل أنواع الألحان! ومن ذا يجرؤ على ألا يأنس بذلك؟!
لماذا؟! لأنه نموذج الطباع الأفضل والذوق الأرقى، ولا يجرؤ أحد على عدم استحسانه! فللأجنبي أن يُعرب عن رأيه بسهولة، ويقول: اسكتْ صوت الراديو –مثلاً– إنه هذر يسبب الصداع!... أما الشرقي فإنه مجبر على استماع ما يريده الغربي إلى آخره. لماذا؟! لأن الغربي نموذجي وهو مثله الأعلى!
والسبب في هذا كله أن الإيمان بالذات، وبرغم أنه قد يسلب من الإنسان مقومات معينة، ولكنه يوفر له شيئاً واحداً هو الأهم من كل تلك المقومات المسلوبة، وهو "الوعي الذاتي"، وهو أن يعي ويعرف أولاً نسبه وأصله وعرقه وأمته وانتماءه وقيمه وتاريخه وحضارته وزمنه وآدابه وأمجاده ونبوغه... هذه عودة إلى "الوعي الذاتي"، أو "الوعي الوجودي"؛ الوعي الذي يجعلني أشعر بذاتي كإنسان، كموجود إنساني في ذروة ربانيته. أجد ذاتي بذلك الشكل فأعرفها تماماً وآنس بها، وعندها لا أتخلى عنها بأي ثمن؛ إذ لا يمكن المساومة على جزء من لحظات وجودي إن عرفت من "أنا"! هذه الـ"أنا" التي تباع بسهولة، تغدو عظيمة بعظمة كائنها، إن هو اكتشفها قليلاً، وبلغ وعيه الذاتي، نعم، وعيه الذاتي!
مجتمع النباهة
المسألة الثانية التي أُسميها "ثقافة" هي الوعي السياسي، ، لا بالمعنى الصحفي اليومي لكلمة "سياسي"، بل بالمعنى الأفلاطوني للبحث المنتخب الاختياري؛ أي: شعور الفرد بمرحلة المصير التاريخي والاجتماعي للمجتمع، وعلاقته بالمجتمع والمقدرات الراهنة بالنسبة إليه وإلى مجتمعه، وعلاقته المتقابلة بأبناء شعبه وأمته، والشعور بانضمامه وارتباطه بالمجتمع، وشعوره بمسؤوليته كرائد وقائد في الطليعة، من أجل الهداية والقيادة والتحرير والحركة الشاملة تجاه شعبه وأمته، الأمر الذي يجعل هذا بمثابة مسؤولية ثانية للإنسان. فثقافة الإنسان، وتمسكه بما قد يستلب منه، شيء واحد.
مراوغة
إذن، النباهة نوعان: "نباهة ذاتية أو فردية"، و"نباهة اجتماعية"، وهذه الأخيرة هي التي نأتي ببيانها الآن.
نقف الآن على نقطة أساسية هي وضوح الأمر وانكشافه؛ فعدوِّي "أنا" كإنسان، وعدونا "نحن" كمجتمع إنساني أو عقائدي أو شعبي، أو كطبقة لا فرق، أكان هذا العدو شخصاً أم أداة، فهو يسلب منا "الوعي الذاتي" و"الوعي الاجتماعي"، إن لم يُبدلنا بهما جهلاً أو فقراً أو ذُلاً، بل حتى لو أبدلنا بهما معرفة! فإنه يبقى عدواً في كل الأحوال. هذا العدو حتى إذا أعطانا معرفة فلسفية أو فنية أو علمية، وسلب منا "النباهة الذاتية" وأيضاً "النباهة الاجتماعية"، تلك النباهة التي اختص بها الأنبياء في التاريخ()، أو عمل على إضعافها فينا، فهو عدونا "نحن"، وعدوي "أنا". هذه هي المسألة الأساسية والمركزية في وجودنا التاريخي، إن قبلناها فإن سائر القضايا الأخرى ستغدو واضحة، وستفيدنا في تخمين وقياس كل الأمور التي تحيط بنا.
إن العدو اليوم ليس كالسابق، فهو لا يأتينا بلأمة الحرب القديمة، كالخوذة والسيف، فيقتل ويذبح ثم يعود من حيث جاء، وسريعا ما نعرف أنه عدو. لا، ليس كما يظن كثيرون. عدونا اليوم يظهر في أكمام ثيابنا، نعم، في كُمّ الثوب!
وليس كما مضى أيضا، يأتي حاملاً سوطه، ويسوق الناس إلى صناديق الاقتراع لأخذ الرأي، كما هو مع الغرب! فذلك السوط أصبح اليوم في دماغ العامل، يسوقه نحو صندوق الاقتراع! وقد سوَّاه على النحو الذي يمكنه من التصويت بحرية. لكن لم يتضح بعد لمن يريد هذا العامل أن يصوت؛ إما لـ"كَلدواتر" وإما لـ"جونسون"!... نعم، هو حر في تصويته؛ لكنه لا يريد –لا يستطيع أن يختار– غير واحد من هذين الاثنين! فالنتيجة محسومة إذن، وهي واحدة، لأيهما شاء أن يصوت!
اللعبة التوقيتية
كما تُصْنَع اليوم الأواني من المطّاط، بعد أن توضع مادتها الخام في جرّة فتذوب، ثم تُصَب في حُفَر مُعدَّة على أشكال الأواني المطلوبة، فينتج عنها الأوعية والأواني كالأبريق والقدح والكأس وغيره، وتعرض في السوق للبيع، كذلك أيضاً صاروا يصنعون الإنسان! يصنعون الجيل!
تُعقد جلسة يشترك فيها عالم النفس وعالم الاجتماع والمؤرخ وعالم الاقتصاد واختصاصي التربية والتعليم... فيجلسون معاً ويتذاكرون بينهم، ما لا يعوزهم من ثروة تمدُّهم وقوة تُساندهم:
• خططوا!
• سمعاً وطاعة! ولكن أي إنسان تريدون؟! تفضلوا كي نعمل!
• نريد في هذا المجتمع (الأفريقي أو الآسيوي أو الأمريكي اللاتيني) جيلاً غير قديم، وغير أبله يخضب رأسه بالحناء دائماً. فليس عندنا حناء! لدينا أدوات الزينة ولوازمها، نريد أن نوزعها هناك فلا يبقى شيء منها. نعم، نريد جيلاً لطيفاً، ظريفاً، جميلاً، مجرداً من الشعور والأحاسيس تماماً، طبقاً للمقاييس العالمية! نعم، هذا الذي نريده، لا أقل ولا أكثر!
• سمعاً وطاعة للمولى! سيجهز بعد أربع سنوات، فنضعه تحت تصرفكم!
(وفجأة، وخلال عشر سنوات، ما بين سنة 1945 و1955، نرى أدوات الزينة الأوروبية ولوازمها قد ارتفع مقدارها في طهران خمسمائة ضعف! وهذا بحسب إحصائيات دقيقة).
• جيد، كيف نصنع هذا الجيل؟!
• نحتاج إلى جيل يرفض الشكل القديم للحياة ويتنكر له، جيل بفكر جديد، لكن بالقدر المعتاد لا أكثر، فإنه إذا ازداد تجدُّد فكره ذرة واحدة سيكون مضراً! المطلوب أن يكون له طبع لطيف، فلا يشرب اللبن، بل يشرب الكوكا كولا... إلى هذا الحد فقط، أما إذا تجاوز هذا المقدار، فإنه سيسبب المخاطر والمشاكل ويحمّلنا مبالغ كبيرة! نعم، هذا المقدار يكفي! يكفي أن يتجدد إلى حد أن يكون لطيفاً فيخلع الأزياء القديمة ويلقيها في سلة النسيان، وأن لا يتجاوز شعوره إلى حد يجعله يبتدع أو يختار نوع أو لون أزيائه من تلقاء نفسه. إن الأمر لا يرتبط به! إنه ليس إنساناً حتى يختار! نريده أن يخلع ملابسه فقط لا أكثر...! نعم، يتجدد إلى حد إن قلنا: "هُو"، يقول أيضاً: "هُو هُو هُو"، وإذا قلنا: "ها"، قال أيضاً: "ها ها ها"، وألا يتفوه بكلمة من ذات نفسه! هكذا نحتاجه.
• سمعاً وطاعة! سنصنعه كما تريدون تماماً.
ويصنعون ذاك الإنسان في شكل يُضرب به المثل، على نحو يضاهي به ذلك الذي يبيع الثلاجات في الاسكيمو (كمرسل التمر إلى هجر)، فيبيعون سيارة "رينو" مصنوعة من الذهب لرئيس قبيلة أفريقية، يضعون السيارة "رينو" على ظهر جمل، ويحملونها إلى رئيس قبيلة لا توجد في أرضه جادة طولها كيلومتران، فيربط السيارة أمام قلعة!... نعم، هكذا يصنعون!
ولم نشعر بهذا الأمر حتى بلغت بنا الحالة بعد عشر سنوات هذا الحد! ولم نشعر بما خسرناه مقابل هذه التغييرات والتطورات؛ فأي شيء يمكن أن يلفت انتباهنا إلى أن الإنسان القريب من الله قد بلغ من الانحطاط حداً جعله يحفل ويأنس بالرذائل؟! ما الذي يمكن أن يلفت انتباهك إلى ما ضحيت به مقابل هذه التلهيّات والألاعيب؟! أي إنسان وأي نداء وأي صوت يمكن أن يُشعرنا، ينبهنا، يفتح أعيننا، ويهزَّنا؟! فإذا كانت العين والشعور والمعرفة وكل المقاييس تَرِدُنا منهم ويحملوننا عليها وعلى الأنس بها، فلا نستسيغ إلا الطعام الذي يستسيغونه لنا... فمن ذا يقدر بعد ذلك أن يُشعرنا بما خسرناه وبما بقي مجهولاً مقابل تلك الأمور؟!
إن الوعي الذاتي، النباهة، هي التي يمكن أن تُشعرنا بما فاتنا. النباهة هي التي يمكن أن تُشعر الإنسان -الذي بلغ هذا الحد من التقليد والاستهلاك- بحقيقة ما يُقدّم له. كما أن الوعي الاجتماعي هو الذي يمكن أن يشعره بما يهدد مصير مجتمعه في الخفاء! نعم، الشيء الوحيد الذي يمكن أن يُنجي الإنسان من هذه البلاهة المتطورة الحديثة المغرية هما هاتان الدرايتان فقط.
نعم،! الآن عرفت الاسمين اللذين يطلقان على هذين المعنيين: الأول: النباهة الفردية، والثاني: النباهة الاجتماعية. حسنٌ، لقد وجدتهما!

.jpg)
















المصدر وليد مانع / لا ميديا