د. حمزة الحسن، عضو الهيئة القيادية في حركة «خلاص»:النظام السعودي اليوم في أضعف حالاته وإفراطه في استخدام العنف دليل على ذلك
- تم النشر بواسطة زينب فرحات / لا ميديا

زينب فرحات / لا ميديا -
بعد 41 ربيعاً، تؤكد انتفاضة المحرم المجيدة لعام 1400هـ الموافق 1979م، التي سجلها تاريخ "القطيف والأحساء"، أنها ليست مجرد حدث عابر أو ذكرى يتم إحياؤها. انتفاضة ليست صغيرة الحجم وسط الظروف التي كانت تحيط بها، خرجت من رحم المعاناة والكبت والحرمان، المستمر لعقود طوال، فكانت الانتفاضة على شاكلة انفجار ثوري استلهم معانيه وأهدافه وشعاراته من ثورة الإمام الحسين (ع) على الظلم والاستبداد وبذل الدم من أجل إعلاء صوت الحق مهما بلغت التضحيات، فكانت أيام عاشوراء من عام 1400 للهجرة أياماً مفصلية قلبت موازين الواقع وبدلته إلى جعل سلطات بني سعود في مهب الخوف والحذر الدائم من أبناء المنطقة، وشكلت قاعدة انطلاقة لكل أساليب المواجهات المختلفة والمستمرة مع النظام السعودي، المصرّ على استخدام سياساته التمييزية والقمعية ضد أهالي المنطقة، ويلقي على عاتقهم الكثير من الانتقام على أساس طائفي مذهبي، تتزايد وتيرته عند كل مفترق، ما يجعل قناعة أبناء الجزيرة متيقنة بأن هذا النظام غير قابل للإصلاح.
عضو الهيئة القيادية في حركة "خلاص"، د. حمزة الحسن، يجزم بأنه مع مرور الزمن، يتأكد دور انتفاضة المحرم في رسم معالم ترسيخ دور المعارضة لنظام الحكم السعودي، معارضة يشتد عضيدها وتتفاعل أدوارها منذ أربعة عقود حتى اليوم، لمواجهة محصلة عقود من الاضطهاد والتمييز الطائفي.
وأشار إلى المقاربة التي تجمع مميزات انتفاضة 1400هـ، مع ما جرى من أحداث في القطيف والأحساء، كان من شأنها أن تبرز مكامن مشكلة النظام الذي يعيش الأرق ليس من المعارضة فحسب، بل وإن المشكلة الكبرى هي مع الطائفة الشيعية.
ويصف د. الحسن، وهو أحد الكوادر في انتفاضة المحرم، هذه الانتفاضة بأنها هبّة غير مسبوقة سجلها التاريخ، لافتا إلى أن "النظام السعودي، وحكم الأقلية النجدي الوهابي، لم يكتفيا بالسيطرة على مفاصل الدولة، واحتكار خيراتها، بل سعى إلى حرمان الآخرين من أبسط حقوقهم، وعمل على تغيير عقائد المواطنين، وإجبار الأكثرية (صوفية، شيعة، إسماعيلية، ومذاهب المسلمين الأخرى) إلى تبنّي الوهابية، باعتبارها أيديولوجية الحكم، وأنها المشرعن لبقاء الحكم السعودي الأقلي، وهي توفر الضمانة المستدامة أمام المعارضين له". ويتابع أن "الأكثر ولاء واقتراباً من الوهابية، ومن المحيط النجدي وثقافته، هو الأكثر ولاءً وضماناً في عدم انقلابه على حكم سعودي هو بكل المقاييس فاسد ومفسد، بمقاييس الأرض والسماء".
ويروي د. الحسن مجريات الأحداث إبان الانتفاضة التي شارك فيها عدد مهول من الجماهير، وشاركت المرأة فيها بشكل غير مسبوق في التظاهرات، وفي إعداد قنابل المولوتوف، وفي التحريض على النظام، والتشجيع على مواجهته. ويستعيد مشهدية الانتفاضة المباركة، ويحاول اختيار مشهد من ذاكرة الأحداث التي عايشها، ويلفت إلى أن المشهد الأكبر الذي لا يذهب من الذاكرة، هو "طوفان بشري تجمّع تلقائيا على أبواب مقبرة مدينة صفوى، عند سماع المواطنين باستشهاد سعيد مدن في القطيف في مظاهرات ليلة التاسع من المحرم. وكان الجميع بانتظار جثمان الشهيد، وكانت مئذنة المسجد المجاور تلهج بذكر الله، والطعن في نظام بني سعود الفاسد". ويتابع: "حين جيء بجثمان الشهيد، لم يؤخذ إلى داخل المقبرة، وإنما حُمل على الأكتاف والأعناق. آلاف النساء والرجال كانوا يهتفون ضد بني سعود وسياسات التمييز والقتل التي ينتهجونها. كان الشارع الرئيس يومها يكاد لا يتسع للبشر المتدفقين من الشوارع الفرعية والمنازل القريبة، حيث التحقوا بالتشييع الذي أشبه ما يكون بتظاهرة كاملة المعالم".
لا يغيب على من عايش الانتفاضة "صوت الرصاص الذي صوب ناحية المواطنين، وسقوط عدد من الشهداء وعشرات الجرحى، مشهد لا يمحى من الذاكرة". ويقول د. الحسن: "أتذكر أمامي ثلاثة من المصابين أُخذوا إلى أحد المنازل المجاورة. كان أمام ناظري، الشهيد مالك عبدالرزاق، وقد فارق الحياة برصاصة في الصدر. وكان إلى جانبه مكي علي ناصر دخيل، وكان زميلاً قديماً في الدراسة الإبتدائية، وكان وحيد أمّه، رأيته يبصق دماً، ولم أكن أتوقع أنه سيعيش إلا لحظات". وينبه إلى دور الانتفاضة في تحول المجتمع بشكل نوعي، قائلا: "ما قبل الانتفاضة شيء، وما جرى بعدها شيء آخر، سياسياً وثقافياً واجتماعياً"، مشيراً إلى أن كل ما جرى في المنطقة منذ الانتفاضة من أحداث سياسية موصول بها بشدّة، وقد يكون أحد أهم ثمارها انتفاضة الكرامة عام 2011.
ويشير الباحث السياسي إلى أن ارتفاع منسوب الثقافة الجهادية لدى المجتمع، إلى جانب تزايد منسوب الوعي السياسي بشكل عام، كان منتجاً من منتجات تلك الانتفاضة، معتبراً أن "ما يجري اليوم من تحولات وأحداث سياسية يمثل تراكماً وإضافة لتلك الانتفاضة التأسيسية. لهذا نحن مدينون لها، ولكل من شارك فيها، ولمن اعتقل بسبب ذلك، ولمن استشهد فيها بالرصاص الغادر، ولمن ساهم في إشعالها وخطط لها وقادها. قليلة هي المنعطفات التأسيسية في حياة الجماعات والشعوب. وبالنسبة لنا، فإن انتفاضة المحرم حدثٌ غيّر حياتنا إلى الأبد".
هدف انتفاضة 1979 التغيير الجذري
هذا، ويضيف الباحث الحجازي أن تطلعاّت البشر لا حدود لها، ذلك أنه كلما حقّق الناس شيئاً طالبوا وسعوا لغيره، هذه طبيعة بشرية فطرية، وبالتالي فإن انتفاضة 1979، كانت بمثابة انفجار بعد احتقان طويل، إذ كان طموح الناس العاديين هو: إلغاء التمييز الطائفي في مستوياته السياسية والاجتماعية والثقافية والدينية، وكانوا يتطلعون إلى المساواة وإلى معاملتهم كمواطنين أنداد لغيرهم.
وتساءل د. الحسن: "لكن كيف يتم ذلك؟"، مردفاً: "لا بد من عمل منظّم. وكي لا تضيع دماء الشهداء لا بدّ من تأسيس منظمات ثقافية وعمل شعبي يدعم أهدافاً محددة. كان لا بد من تأسيس عمل حقوقي للدفاع عن المعتقلين السياسيين. ولهذا كان أول جهد على مستوى المهلكة السعودية في هذا الميدان الحقوقي قد تمّ على يد أبناء الانتفاضة الأولى، إذ وجد المواطنون -من خلال رد الفعل الأعمى بالرصاص- أن النظام طائفي غير قابل للإصلاح، وليس في نيته التراجع والتغيير. لهذا كان التغيير الجذري للنظام السعودي هدفاً، وليس الإصلاح السياسي الذي كان هو الآخر بعيد الاحتمال والوقوع".
وينوه بأن الانتفاضة الثانية أو حراك 2011، قد أكّد على الموضوعات والأهداف ذاتها التي أثارتها الانتفاضة الأولى، واستخدم الآليات ذاتها (تحريك الشارع) كأساس، إضافة إلى آليات جديدة بسبب تطور التكنولوجيا، ويمكن القول بأن "حراك 2011 يمثل نسخة مطوّرة من انتفاضة 1979، وإن كانت لها خصوصياتها المكانية والقيادية والزمانية". ويشير إلى أن النظام يتمرّس في قمع المعارضين، بدلاً من البحث عن أخطائه وإصلاحها أو تعديل بعض سياساته على الأقل، ويتمرّس المعارضون في التغلّب على وسائل القمع.
إلى ذلك، يشدد الباحث السياسي على أن الفكرة العامة لدى بني سعود وجهاز مباحثهم الأمني تقول بضرورة "كسر الناشطين الشيعة بعنف ودموية بشعة إلى حد يجعلهم غير قادرين على الاعتراض، على الأقل لعشرين سنة قادمة". هذا ما فعلوه في 1979، وهو ما فعلوه ويفعلونه اليوم"، مستطرداً بالإشارة إلى أنه "يغيب عن بالهم أمور عديدة، وهي أن إرادة التغيير والمواجهة مع بني سعود لم تنكسر في السابق ولا في اللاحق، وأن الفاصلة الزمنية التي يتوقعونها لن تكون أكثر من التقاط أنفاس والاستعداد مجدداً لمقارعة الطغاة في الرياض، وثالثاً فإن العنف قد يكون لدى شعوب معينة مدعاة للانكسار والجلوس وتغيير التوجه أحياناً، ولكنه لدى شعوب أخرى يكون محفّزاً أكثر على النهوض من بين الركام، وكما قيل: الضربة التي لا تكسر ظهرك تقويك. صار لدينا جلد خشن يتحمّل الضربات والطعنات المادية والمعنوية. لم نكن ولن نكون مكسورين يائسين غير قادرين على الفعل. هذا حلم النظام".
ضعف النظام سبب بطشه
ويضيف الباحث السياسي: "الحقيقة هي أن النظام هو المكسور، وهو الذي يتراجع ويترنح، ولو لم يكن كذلك لما قام بما قام به من عنف وبطش ودموية". ويتابع: "شعوره بالضعف كان أهم سبب للعنف الذي قام به، فهو يريد أن يقنعنا بأنه قوي وباطش، ونحن مقتنعون بأنه ضعيف وساقط. وحتى لو لم يكن كذلك (وهو كذلك الآن) فإن الذي حدث لم يكسر المواطنين الشيعة رغم ممارسة الرعب. ولهذا فنحن لا فقط نتوقع مواجهة قادمة مع النظام، بل نحن الآن كما في الماضي نعيش المواجهة ذلك أن القضية ليست في توقع انتفاضة أخرى، إنما القضية تكمن في أن هناك مبررات أكبر لمواجهة هذا النظام الطاغي الشرس الدموي".
ويخلص د.الحسن إلى التأكيد أن "الأنظمة تستطيع، في فترات زمنية معينة، أن تمنع تمظهر المعارضة لديها عبر القمع بشتى أشكاله، لكنها إن لم تُزل مبررات الاعتراض فإن الشعب وفي أي لحظة انكسار أو تحوّل سياسي سيقلب لبني سعود ظهر المجن، ويجد ما لا يتوقعه". وتابع: "تجارب الشعوب تدلنا على ذلك، ومعركتنا مع بني سعود ليس لها وجه واحد، أي التظاهر فحسب، إنما هذا الأسلوب هو واحد من أساليب عديدة، والشعوب عامة لا ينقصها الإبداع في وسائل نضالها لانتزاع حقوقها. النظام السعودي اليوم، رغم عنفه، هو في أضعف حالاته منذ قيامه. نحن وشعبنا نعمل، وممتلئون بالثقة والأمل بنصر الله القريب".

.jpg)











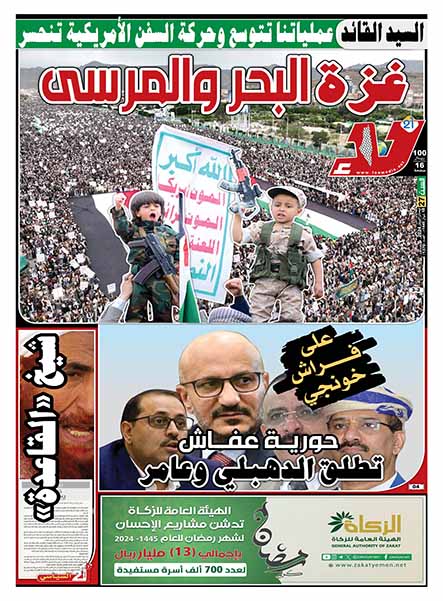




المصدر زينب فرحات / لا ميديا