النباهـــة والاستحمــــار (الحلقة الأخيرة)
- تم النشر بواسطة وليد مانع / لا ميديا
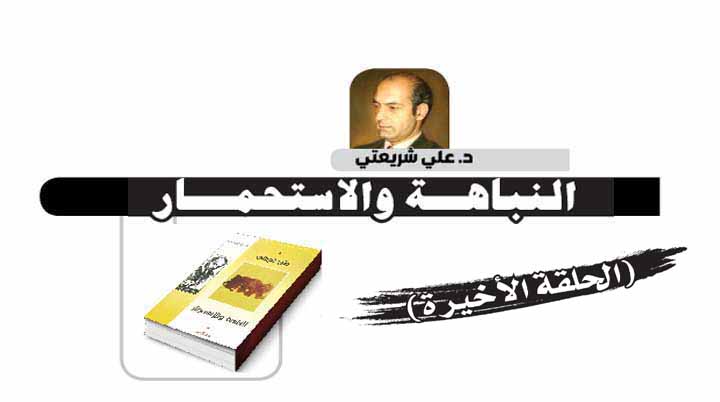
التجدُّد
يمكن أن تكون الحضارة والتقدم دافعاً للاستحمار. ففي المملكة السعودية –مثلاً– نماذج كثيرة من هذا التقدم الاستحماري. فالعربي البائس هناك هو سائق السيارة. ثمن السيارة "كاديلاك" هناك 22000 تومان؛ في أن ثمنها في أمريكا 3000 تومان فقط! أي أنها في السعودية أغلى كثيرا منها في أمريكا؛ إذ لا تُفرض الغرامة في السعودية على المتخلفين في القيادة. كما أنه لا توجد لديهم مقررات ونظام محدد للقيادة والسائقين؛ لأنه "مذموم شرعاً"، ولا يخلو من إشكال! وبدلاً من الغرامة، فإن الشرطي هناك يحمل هراوة حديدية يضرب بها على غلاف السيارة المخالفة.
ومعلوم أن السيارة التي تتصدع في مكان أو مكانين تُستهلك قبل أوانها. ثم إنه لا يوجد هناك مصلح لصفائح السيارات. وفي النتيجة تصبح السيارة بعد سنة أو سنتين غير صالحة للاستخدام، لما أصابها من صدمات بدلاً من الغرامة "المذمومة شرعاً". النتيجة لصالح من؟! نعم، يجلس ذاك السائق البدوي بقدميه المشققتين خلف مقود سيارة "كاديلاك" أو "شفر" ويفخر ويتباهى لدرجة لا يجرؤ عليها الأمريكي نفسه، جاهلاً مدى خسارته ووقوعه في مكر عدوه()، ناسياً أنه كان قبل سنة يرعى الإبل في البادية، وقد تعلم الآن القيادة! إن هذا التفاخر والتباهي ليسا سوى "الحضارة الاستهلاكية". ويجدر أن أقول لكم إن هذه الحضارة الاستهلاكية هي أسوأ وأقبح من الوحشية والهمجية! نعم، إن الذي يتحضَّر في الاستهلاك فقط هو دون الوحشي. لماذا؟ لأن الوحشي يظل هناك أمل في تحضره عن طريق الإنتاج؛ لكن المستهلك من غير إنتاج ينعدم الأمل في تحضره بالطبع.
إن السائق السعودي هذا كان له سبعة أو عشرة جِمال في البادية، باعها ليوفي القسط الأول من قرض شراء سيارة "الكاديلاك" الأمريكية. تأملوا أي ثروة تنعدم وتخرج من تلك البلاد الفقيرة التي رأسمالها وكل ما فيها تلك الإبل! ثم أخذ يكدح ويتعب حتى تمكن من سداد الأقساط الباقية. لكن ماذا لديه الآن؟! مجرد قطعة حديد كانت سيارة لبضعة أيام، وأصبحت الآن صفائح ممزقة، تلافياً لأخذ الغرامة! باع الجِمال وجلس عدة أيام في "الكاديلاك". بدلاً من ركوب الجمل يركب السيارة فيشغل الراديو ويطفئه متى شاء! أمر أن تُصنع لها مقاعد من الليف وتعطى ألف شكل وصبغة لتكون سيارة! أما الآن فقد بقي هو وقطع من الحديد و... لا شيء! ولا يسعه إلا أن يذهب فيفتش عن مكان للسرقة أو يكون شحاذاً أو خادماً أو ينتظر الموت في مكان فيريح نفسه! هذا مصيره المحتوم! أين؟! في بلاد مساحتها تعادل ضعف مساحة إيران، ويوجد فيها الآن خمسة آلاف جمل، بينما كانت مركزاً لتجمع الجمال وترتبط حياة كل الشعب بها. وهذا العدد القليل من الجمال في طريقه إلى الفناء، في سبيل إعفاء السيارات الأمريكية من غرامات المخالفة! هذا مفاد الحضارة والتجدد، أي الصنعة، أو الوحشية، وخزن قطع الحديد من السيارات الأمريكية المتلفة! أيهما؟! ما أبأسهم وهم فرحون ويشكرون ويحمدون! يقولون: لقد أصبحنا في جنة! لو دخلت بلادنا قبل خمس سنوات لما رأيت سيارة قط، كل ما يمكن أن تراه جِمالاً وشقاءً وتعباً، وسيرنا وترحالنا كله على الجمال، أما الآن فلله الحمد، طائرات بوينغ وسيارات مكيفة و...! حتى أصبح أحدهم يعيب ويحتقر نفسه عندما يراك وهو جالس في سيارة "بيجوت" مثلاً؛ لأن السائقين العاديين هناك يمتلكون "كاديلاك" و"شفروليه" 71 و72، فكيف...؟!
نعم، تقدمنا! تَقدُّمنا ظاهر!
نعم، لا شك أنكم تقدمتم!!!
عندما يدخل أمريكي أو أوروبي الرياض هذا اليوم يندهش من التجدد! السيارات كلها حديثة مائة بالمائة من طراز 59 إلى 72! لا يوجد لها مثيل في أي بلد من بلدان العالم! فمن أمريكا إلى الشرق الأوسط، كل بلد متخلف اقتصادياً تراه أكثر تجدداً وتجملاً من غيره! فعندما تقلع بك الطائرة من باريس وتهبط في العاصمة التنزانية "دار السلام"، تندهش من الجمال والجلال وعظمة البنايات وحداثة العمارات والسيارات التي هي من أحدث طراز!!
ما هو التجمُّل؟ هو التقدم في الاستهلاك، الشيء الذي يقضون علينا من أجله، ليسلبوا منا أمل الإنتاج وطالعه، من الناحية الفكرية والاقتصادية والفنية!
نعم، الشرق كله ضحية الإنتاج الاستهلاكي. كيف؟ وبماذا؟ بالاتباع، والتقليد الأعمى!
الحريات الفردية
الحرية الفردية أداة تخدير كبرى لإغفال الحرية الاجتماعية، حيث النباهة الاجتماعية القضية ذات الأهمية الكبرى. إنهم ينادون بالحرية الفردية، ويدعونك إليها، من أجل تمويه الأذهان، والغفلة عن "النباهة الاجتماعية"، حيث يرى الإنسان نفسه حراً من الناحية الفردية، في غذائه وشهواته. الحرية الفردية هنا كقفص فيه طير، وقد وُضع في صالة مغلقة تماماً، ثم فُتح باب القفص. إنه شعور كاذب بالحرية؛ لأن الأسير الذي يعلم أنه أسير، يحاول أن يطلق نفسه، ويتحرر من الأسر، بينما الذي لا يعلم أنه أسير، ويشعر بالحرية، فشعوره وهم وكذب، وهو يشكر الله ويحمده على تلك الحرية الزائفة.
حرية الجنس
حرية الجنس صنفان:
أحدهما –والذي سنتحدث عنه هنا– هو ذاك الذي يقدمه الغرب هدية للشرق، واسمه "حرية الجنس"، مقابل ما يسلبه من المواد الخام! فالغرب يرى أن عليه أن يتحف الشرق مقابل ما يأخذه من المواد الخام، ولذا يسمح للشرقيين بأن يكونوا "أحراراً" جنسياً، بلا قيود ولا موانع. وبعد ذلك، تأتي أجهزة الدعاية والإعلام ووسائل التواصل في الشرق لتدعو إلى "الحرية الجنسية" عند جيل يتراوح عمره بين 18 و25 سنة. وعلى هذا، رأى الغرب أن من اللازم عليه أن يُلهي هذا الجيل ويشغله بـ"الحرية الجنسية". وفي اعتقاده أن هذا الجيل يتعرض لحالتين من الاضطراب: إحداهما من أجل "الحرية الاجتماعية"، والثانية حالة الاضطراب والتشويش الناتجة عن "الأزمة الجنسية". وهكذا، رأى الغربيون أن الأحرى به إفساح المجال أمام هذا الجيل ومنحه "حرية الجنس"، ليفقد الشعور بحاجته إلى "الحرية الاجتماعية" الزائدة! نعم، إن بإمكانهم أن يُلهوه خمس أو ست سنوات، أي طيلة "الأزمة الجنسية" التي تضغط عليه، حتى ينشغل عن "الحرية الاجتماعية"، فيتلهى بأهوائه ونزواته، إلى حد يفقد معه شعوره، وبعد انقضاء هذه المدة يرتفع الخطر.
حرية المرأة
ماذا يقصدون بحرية المرأة؟! القصد هو فقط الحرب التمويهية، من أجل الإثارة، وفتح باب الجدل والاختلاف بين الرجل والمرأة، وإلهائهما عن القضايا العادلة الأساسية، عن حقوقهما، عن مشكلة الشرق والغرب، عن مشكلة المستعمرين والخاضعين للاستعمار...
التقليد والتبعية
لقد قيل الكثير في هذه القضية؛ لكن الشيء الذي لم يتطرق إليه أحد هو "دور المرأة في قضية التقليد". إن أكبر عنصر يلعب دوراً أساسياً في "الحضارة الاستهلاكية" هو المرأة، حيث لها النصيب الأوفر، والدور الكبير، من نشر وإشاعة الحضارة الاستهلاكية، وتطور الأنواع والفِرَق والجماعات والعلاقات العائلية والروابط الاجتماعية والسياسية في الثلاثين عاماً الأخيرة، مما يقتضي بحثاً خاصاً لا مجال له هنا؛ لكني فقط سأضرب مثلاً في التبعية وتقليد الآخرين.
المثل مأخوذ من أوروبا، حيث يذهب الأوروبيون إلى الغابات لصيد القردة حية سالمة، فيضع الصيادون إناءً مملؤاً بالصمغ اللزج تحت الأشجار، أو على ضفاف الأنهار، في ممر القردة، وإناءً آخر في زاوية أخرى، يشبه الإناء الأول، لكن فيه ماء! ويجلسون إزاءه بانتظار مرور القردة. وعندما تأتي وتقف قبالة الإناء المليء بالصمغ، يرفع الصيادون أيديهم، فترفع القردة أيديها، يغمس الصيادون أيديهم في الأواني المليئة بالماء، فتغمس القردة أيديها في الأواني المليئة بمادة الصمغ اللزج، يخرج الصيادون أيديهم، ويضعونها على جباههم كحالة اليتيم، فتعمل القردة مثلهم تماماً، يمسح الصيادون بأيديهم على وجوههم وعيونهم، فتسمح القردة أيضاً على الوجوه والعيون! يقف هؤلاء مقابل الشمس، فتقف القردة مقابل الشمس!! يجف الصمغ على وجوه القردة، فتلتصق أجفانها ويتعذر فتحها، فيذهب الصيادون إليها ويلقون القبض عليها بسهولة!!
الخلاصة
في النتيجة، يعمل الاستعمار القديم على أن يشغل الشعوب ويلهيها عن "النباهة الإنسانية" و"النباهة الاجتماعية"، لينشأ جيل مطابق لمقاييسه وحساباته، كأن يكون وزنه أربعة مثاقيل، وطول باعه أربعة سنتمترات فقط، وطريقته المثلى: لحية من الأمام، عباءة من الخلف، كتاب أدعية، مسجد، صلاة، صيام، وتعزية! هذا برنامجه اليومي والسلام.
هذا جيل ينشئه الاستحمار القديم، جيل فارغ، مضطرب، لا يتحمل أي مسؤولية!
أما الاستحمار الجديد فإنه يسلبنا "النباهة الإنسانية" و"النباهة الاجتماعية" بـ"عقلية" وسيارة "بيجوت" ورزمة مناديل "كلينكس" وقدر من "المتاع" و"محفظة سفتجات" و"ديون" والسلام! لا فكر ولا تعب، لا هم ولا نصب، ولا هم يحزنون. هذا هو، لا أكثر!!
أعيدوا النظر في فتياتكم اللواتي تزوجن، واللواتي لم يتزوجن بعد، وانظروا إلى ما كتبن عن أنفسهن، وكيف عبّرن عما يجول في بواطنهن، حين كن في الصفوف الثانوية الخامسة والسادسة، من سن الـ18 إلى ما فوق، تجدوا تشاؤماً وفلسفة... رباه! لِمَ خلقتني، أيها الموت لِمَ لا تأخذني؟! ألا موتاً يباع فأشتريه؟!... كلام مليء بالعواطف الخالية والعبارات الروائية ورِقَّة، النفس... إنها تظن نفسها سهرت الليل كله من شدة المرض! ولقد أرادت أن تنتحر، أو عزمت أن تلقى في بئر... و... و... وغير ذلك من هذه الخيالات والتصورات.
لكنها الآن، بعد أن تزوجت، أضاعت "طرقها المثلى" كلها في الشهرين أو الثلاثة الشهور الأولى من زواجها، وأعطت طومار ذكرياتها لشخصٍ يقرؤه، ولم تذهب لتسترده، كما أنها تستحي أن تفتحه، لماذا؟! لأن الأقساط والديون أمرضتها، وأفلجتها تماماً، وليس من شفاء لآلامها سوى بطاقات اليانصيب، واقتراع جوائز بنك العمران! وما أسرع ما يلتقي طرفا دائرة عمرها، فتخيب آمالها وتذهب هباءً!!
هذا جيل الاستحمار الحديث، وذاك جيل الاستحمار القديم؛ الاستحمار الذي بات يرصد كل واحد منا. نخرج أنفسنا من شكله القديم، فيتلقانا بشكله الحديث. نتمرد عليه في مكان، فيلهينا ونقع في حبائله في مكان آخر. نرفضه من ناحية، فيسخرنا من ناحية أخرى. نتنبه إلى جانب منه، فيشغلنا في جانب آخر. نكتشف حرباً إيهامية، فيوقعنا في حرب إيهامية أخرى... وهكذا دائماً!!
وعلى هذا، فإن جيلنا أسيرٌ في أيدي تلك القدرات، إلى حد يمكنها أن تصنعه كيفما شاءت، وطبقاً لمقاييس معينة، تنتجه كما تنتج من مادة المطاط أو البلاستيك أنواع الأواني والسلع! إنهم أهل علم وصنعة، ولديهم تلفزيون وصحف ومعارض ومسرح وفنون... وإلى جانب هذا كله، استخدموا الترجمة والعلوم، وعلم الاجتماع. كما أن وحدة القياس العالمي لهم أيضاً. فكيف نطمئن إذن إلى عدم الوقوع في أسر "الاستحمار القديم" أو "الاستحمار الجديد"؟! كيف ونحن الصغار البسطاء الغافلون نحزن ونصاب بعقدة لأجل أي شيء بسيط وتافه، ونفرح لشيء أو أمر جزئي؟! أحزاننا وأفراحنا ومُثُلنا العليا يسيرة جداً!
إن أي قضية، فردية أو اجتماعية، أدبية كانت أم أخلاقية أم فلسفية، دينية أو غير دينية، تُعْرَضُ علينا، وهي بعيدة عن "النباهة الإنسانية" و"النباهة الاجتماعية"، ومنحرفة عنهما، هي استحمار، قديم أو جديد، مهما كانت مقدسة؛ والسلام.

.jpg)
















المصدر وليد مانع / لا ميديا