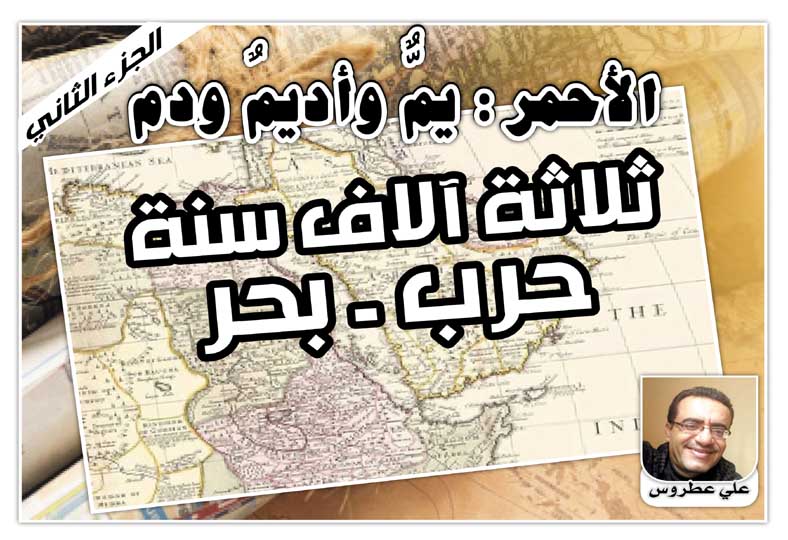
علي عطروس / «لا» 21 السياسي -
في الـ20 من كانون الأول/ ديسمبر 2023 وقف وزير الحرب الصهيوني، المجرم يوآف غالانت (البولندي الجينات والعينين والجلد)، على رصيف ميناء أم الرشراش الكنعاني العربي - «إيلات» الفارغ من السفن والبضائع، مرعداً ومزبداً ومهدداً من يهاجم مستوطنته و»حرية الملاحة في مضيق باب المندب» (على بعد 2000 كيلومتر من «إسرائيل»)(1) شاكراً صديقه (وزير الدفاع الأمريكي) لويد أوستن، الذي استضافه في «إسرائيل» قبل بضعة أيام، لقيادته -نيابة عن الولايات المتحدة- القوة المتعددة الجنسيات المكلفة بضمان حرية الملاحة للجميع، في مضيق باب المندب(2).
وفي مداولة ومناولة تاريخية لافتة وقبل 1910 سنة من رغاء يوآف غالانت، أطل أحد أسلافه، الإمبراطور الروماني ترايانوس، مع جيشه (سنة 113م) قرب المكان نفسه الذي وقف فيه يوآف، وتنهد متحسراً لأنه لن يكون قادراً على البقاء هناك ولن يستطيع الذهاب جنوباً بعد أن كانت جيوش الإمبراطورية الرومانية قد وفدت على أراضينا منذ عام 27 في القرن الأول قبل الميلاد، حيث سجل التاريخ محاولات رومانية عديدة للسيطرة على الجانب الشمالي الغربي من شبه الجزيرة العربية المطل على خليج العقبة والشاطئ الشرقي من البحر الأحمر، لدى احتلال الإمبراطور ترايانوس مملكة الأنباط في شرق نهر الأردن بعدما قضت روما على دولة البطالمة في مصر عام 31 ق. م. وقد سارعت حينذاك إلى إرسال حملة، عام 24 ق. م، للاستيلاء على اليمن، لكن الحملة الرومانية بلغت اليمن ودُحرت مهزومة.
وكما هُزم أسلافه بين شمال البحر الأحمر وجنوبه قبل وبعد الميلاد سيُهزم غالانت ونتنياهو وغانتس وبقية مجرمي الاحتلال والإحلال الصهيوني بعد «طوفان الأقصى» وبعد حصار اليمنيين لكيانه المهزوم فعلاً.
منذ زمن موغل في القدم، وقع البحر الأحمر وعرب شبه الجزيرة العربية في خضم الصراع الدولي بين القوتين العظميين آنذاك، قوى الغرب الزاحفة إلى الشرق المتمثلة بالإسكندر ثم روما وبيزنطية من جهة، وقوى الشرق الإيرانية من بارثيين وساسانيين من جهة أخرى.
في القرن السادس قبل الميلاد أرسل داريوس الأول من بلاد فارس بعثات الاستطلاع إلى البحر الأحمر، كما أرسل الإسكندر الأكبر في أواخر القرن الرابع ق. م رحلات يونانية بحرية إلى جنوب البحر الأحمر تجاه المحيط الهندي. واصل البحارة اليونانيون استكشاف وجمع البيانات من البحر الأحمر. جمع المؤرخ اغاثارشيدس المعلومات حول البحر في القرن الثاني ق. م.
يبين الدليل (Periplus of the Erythraean Sea)(3)، الذي كتبه الأغريق في القرن الأول وصفا تفصيليا لموانئ البحر الأحمر والطرق البحرية. يصف أيضاً كيف اكتشف هبالوس لأول مرة الطريق المباشر من البحر الأحمر إلى الهند.
فقد كان البحر الأحمر وما يزال هدفاً حيوياً يدخل في سياسات الدول الكبرى والشعوب المطلة عليه، ومنذ القديم كان التنافس المباشر بين اليمن والحجاز والأحباش في السيطرة عليه يعكس صورة الصراع البيزنطي الفارسي آنذاك.
وللبحر مكانة ذات أهمية قصوى في الصراعات الدولية التي نشبت في القرن الميلادي السادس، وتشكلت أرضيتها من ثلاثة أضلاع، هي الدولة الحميرية في اليمن وإمبراطورية الروم ومملكة الحبشة المعروفة اليوم بإثيوبيا، وحيث عبرت جيوشها البحر الأحمر وفرضت سيادتها على اليمن لعقود من السنين.
«احتلت الإمبراطورية البيزنطية (منذ العام 395م حتى العام 634م) المنطقة بأسرها، ومنها فلسطين. ودفعت وكلاءها الغساسنة ملوك الشام من أجل غزو خيبر التي كانت يهودية، في ما سمي «مفسد خيبر» في الحوليات العربية الكلاسيكية، ومن أجل نصرة الأوس والخزرج في يثرب على اليهود، بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة في العام 567م، لأخذ الأمور من أيديهم في المدينة؛ فيما كانت الدولة البيزنطية هذه تنصر في الوقت ذاته أبرهة الحبشي في استيلائه على اليمن، وفي محاولة هدمه الكعبة في مكة في عام الفيل 570م، من أجل إطباق سيطرة البيزنطيين ووكلائهم على الشواطئ الشرقية من البحر الأحمر، نزولاً من بلاد الشام جنوباً؛ وصعوداً من اليمن شمالاً»(4).
«كان الاحتلال الغربي لبلاد المشرق العربي إعراباً صريحاً عن الطمع بمفاصلها الاستراتيجية، وعلى رأسها فلسطين، وكان سابقاً حتى لحكم الرومان والبيزنطيين. فبعد الغازي المقدوني الإسكندر واجتياحه الكاسح للمنطقة، في العقد الرابع من القرن الرابع قبل الميلاد، تولى الحكم في منطقة المشرق العربي السلوقيون في بلاد الشام وامتداداتها الجنوبية شرقاً، والبطالمة في مصر غرباً»(5).
حتى ظهور الإسلام كانت الدولة الفارسية هي الخصم الشرقي الأول لهذه الأطماع الغربية.
و»شهد القرن الميلادي السادس على طوله، حروباً مباشرة بيزنطية - ساسانية، في بلاد الشام، أو حروباً بالوكالة، بين الغساسنة وكلاء بيزنطة في بلاد الشام، واللخميين المناذرة في العراق حلفاء الساسانيين؛ أو حروباً بالوكالة أيضاً بين الحبشة حليفة البيزنطيين، والحِمْيَريين في اليمن، الذين حالفوا الفرس الساسانيين محالفة مهزوزة»(6).
هذه الحروب المتواصلة في بلاد الشام أحدثت اضطراباً شديداً في الطريق التجارية الدولية، التي كانت تأتي بالحرير الصيني والتوابل الهندية وغيرها، مع سفن المحيط الهندي والخليج، عبر نهر الفرات، حتى مرفأ فولوغاسيا (بابل)، ثم إلى تدمر براً، وصولاً عبر حمص إلى شواطئ البحر المتوسط... (لم تكن الطريق التجارية الأساسية الثانية عبر البحر الأحمر أفضل حالاً، إذ إن الحبشة حليفة بيزنطة كانت في حرب مزمنة أخرى مع حِمْيَريي اليمن، عند الجانب الشرقي من باب المندب. وبذلك اضطرب حبل هذه التجارة الدولية التي كانت تأتي بالبضاعة «الاستراتيجية» من المحيط الهندي إلى البحر المتوسط»(7).
حين ظهر الإسلام وتمكن المسلمون في فجر الإسلام من تحرير المدخل الشمالي إلى البحر الأحمر، من جانبيه الشرقي والغربي ومع الهزيمة التي لحقت بالدولتين العظميين في ذلك العصر استتب الأمر في أيدي المسلمين وأضحى البحر الأحمر بحراً عربياً.
وبقي الأمر على هذه الحال حتى «تحركت في الإقطاعيات الأوروبية شرارة الحمية لـ»الأراضي المقدسة» أي فلسطين، وهي حمية كان التجار أشد المتحمسين لها ولتمويلها وتجهيزها مع مباركة بابا روما، أوربان الثاني. وحين دخلت الحملة الصليبية الأولى بلاد الشام عام 1099، تفاوض الصليبيون مع الفاطميين وأبدوا استعدادهم لترك سورية للفاطميين، لكنهم تمسكوا بفلسطين. وفي عام 1182، أطلق رينالد دي شاتيون (أرناط) أمير شرق الأردن الصليبي، أسطولاً من السفن على البحر الأحمر من أجل شن غارات على موانئ المسلمين فيه ومهاجمة مدن مكة المكرمة والمدينة المنورة. غير أن المسلمين والعرب ما لبثوا أن ردوا الصليبيين على أعقابهم، وعادت فلسطين إلى عروبتها»(8).
في عام 1513، فرض ألفونسو دي ألبوكيرك الحصار على عدن لمحاولة تأمين تلك الطريق إلى البرتغال؛ لكنه اضطر إلى التراجع. وطاف البحر الأحمر داخل باب المندب، وكان الأسطول الأوروبي أول من أبحر في هذه المياه.
وهكذا «كان البحر الأحمر والمداخل إليه الهدية الكبرى لكل الغزوات الغربية لهذه المنطقة، التي كانت -ولا تزال- تتفوق بموقعها الجغرافي الاستراتيجي المركزي، على معظم المناطق الاستراتيجية الأخرى في العالم، على الأقل، حتى عام 1492، حين «اكتشف» كريستوف كولومبوس للتجار الأوروبيين منفذاً آخر إلى المحيط الهندي، غير منفذ البحر الأحمر، حين كان يظن أنه مُبحر بسفنه من المحيط الأطلسي غرباً إلى الهند مباشرة»(9).
«بل إن السيطرة «الإحلالية» التي أتت آخر نسخة منها مع «إسرائيل»، لم تغب عن هذه الغزوات الغربية لمنطقتنا العربية، وأشهرها إسكان (فلنقل: إحلال) الإسكندر مستوطنين من المقدونيين وغيرهم في جزيرة سقطرى من أجل إطباق السيطرة على البحر الأحمر من مدخله الجنوبي، بعدما سيطر على المداخل الشمالية إليه، وعلى شط العرب عند شاطئ الخليج، المطل هو الآخر على بحر العرب والمحيط الهندي»(10).
ومن المعروف تاريخياً أن ما بين القرنين الخامس والرابع قبل الميلاد كان شأن اليونان قد علا وسطع. وفي الربع الأخير من القرن الرابع، اجتاح الإسكندر المقدوني مدينة صور الفينيقية وأحرقها (332 ق. م)، ثم اجتاح مصر وتولى عليها أولا (333 ق. م)، ثم آلت إلى خلفائه البطلميين، وبعد توغله في بلاد فارس والهند سعى ليبسط نفوذه على الجزيرة العربية من خلال منفذين، نهر الفرات والبحر والأحمر، ويشرح هذه التفاصيل المؤرخ الإغريقي سترابو (ت: 70 ق. م) في كتابه «الجغرافيا»، بقوله: «إن الإسكندر أراد أن يجعل من العربية مقره الملكي بعد عودته من الهند لكن خططه انهارت بعد وفاته المفاجئة، وعلى أية حال فقد قضت واحدة من خططه باستطلاع ما إذا كان العرب سيقبلون به طوعا. وحين رأى أن العرب لم يرسلوا له سفراء لا قبل حملة الهند ولا بعدها، أخذ يستعد للحرب». وفي حمأة استعداده لتلك الحرب، وكما جاء في «حملات الإسكندر» للوقيوس أريانوس (ت: 160 ب. م)، أن «الإسكندر كان يخطط لاستيطان ساحل البحر المجاور للخليج العربي ـ البحر الأحمر، وكذلك الجزر الموجودة في هذا البحر، لأنه تراءى له أن هذه الأراضي ستصبح على درجة من الرخاء لا تقل عن فينيقيا، وقد قام الإسكندر بهذه الترتيبات الخاصة بالأسطول لمهاجمة الجزء الأكبر من السكان العرب بدعوى انهم كانوا الأجانب الوحيدين في هذه المنطقة الذين لم يرسلوا سفارة له». ووفقا لأريانوس أيضا «سمع الإسكندر أن العرب يتعبدون فقط لمعبودين، أورانوس وديونيسوس، أورانوس لأنه مرئي ويضم الكواكب السماوية وخصوصا الشمس، وديونيسوس بفضل شهرة حملته على الهند، ولهذا، فالإسكندر اعتقد أنه يستحق أن يتخذه العرب معبودا ثالثا، لأنه قام بإنجازات لا تقل مكانة عن أعمال ديونيسوس، ولذلك أرسل أرخياس (قائد بحري) على متن سفينة ثلاثية لاستكشاف الطريق البحري إلى بلاد العرب، وبعده أوفد اندروسثينيس وأبحر حول خليج ما للعرب، ثم هيرون، وهو ربان أمهر من الذين سبق إرسالهم، وكانت التعليمات إليه أن يبحر حول خليج العرب حتى يصل إلى الخليج العربي ـ البحر الأحمر، المجاور لمصر بمحاذاة مدينة هيرو بوليس.
وكان من بين الطامعين الغربيين الأحدث زمناً في احتلال الأرخبيل السقطري، المستعمرون البرتغاليون الذين وصلوا في عام 1507 وأنزلوا جنودهم في جزره»(11).
وقد سيطر المماليك على الشام ومصر والحجاز وبعض أجزاء اليمن في نهاية العصور الوسطى بين 1250-1517، مما مكنهم من ربح أموال طائلة بسبب الضرائب الكثيرة التي يفرضونها على السلع لتمر من أراضيهم، وقد حصروا تجارة التوابل لهم فقط.
«ظهر التنافس الإنكليزي الفرنسي على البحر الأحمر ومضيق باب المندب في القرن الثامن عشر، عندما أخذ كل من بريطانيا وفرنسا بتهديد مصالح الأخرى عبر الطرق المؤدية الى الهند، وأهمها طريق البحر الأحمر وخاصة بعد تجديد معاهدة 1536 التي نصت على حق فرنسا في حماية المسيحيين الكاثوليك في أرجاء الدولة العثمانية مما أزعج الإنكليز. كما كانت الحملة الفرنسية بقيادة نابليون بونابرت على مصر بمثابة الصراع العلني بين بريطانيا وفرنسا حول البحر الأحمر، فقد اتجه الفرنسيون إلى تجميع أسطولهم في السويس بهدف قطع الطريق على بريطانيا إلى السنغال عبر الشرق الأوسط وإلى الهند، فقام مهندسون فرنسيون بدراسة وصل البحر الأحمر بالبحر المتوسط. ومُنيت الخطة الفرنسية بالفشل بعد تمكن الأسطول الإنكليزي من توجيه ضربة إلى الاسطول الفرنسي وتحطيمه في أبو قير في آب/ أغسطس 1798»(12).
«وحصلت اتفاقات بريطانية روسية عثمانية لإجلاء الفرنسيين في كانون الثاني/ يناير 1799؛ لكن بريطانيا أرادت الحفظ على مصالحها الحيوية في مصر، فأرسلت قوات بحرية تطوف البحر الأحمر في عملية استعراض قوة. وفي العام نفسه قامت قوة بحرية قوامها 300 جندي أوروبي وهندي بقيادة جون موراي بالتوجه نحو المدخل الجنوبي للبحر الأحمر، واحتلت جزيرة ميون التي تبعد عن عدن حوالى 500 ميل بحري فقط مما يجعل أي قوة تسيطر عليها تهدد بالتالي قاعدة عدن»(13).
«بلغ الصراع ذروته حين دخل الجيش المصري بقيادة محمد علي إلى اليمن أثناء مطاردته الوهابيين، وتم الاستيلاء على ميناء المخا في 13 كانون الأول/ ديسمبر 1833، مما شكل تهديداً خطيراً للمصالح البريطانية في الجزء الجنوبي من البحر الأحمر ومضيق باب المندب، وشكل حافزاً للبريطانيين في محاولة السيطرة على عدن. وسقطت عدن بيد البريطانيين في 19 كانون الثاني/ يناير 1839، وشكل ذلك تنفيذاً لسياستها الاستعمارية في منطقة البحر الأحمر، وتثبيت نفوذها عند مضيق باب المندب، وإلى تقوية نفوذها في مصر إضافة إلى محاولتها إبعاد أي نفوذ محلي أو أجنبي عن هذا الممر الملاحي البحري الهام»(14).
هكذا و»بعد افتتاح قناة السويس العام 1869، وقع البحر الأحمر مباشرةً تحت تأثير سياسات دول أوروبا الاستعمارية التوسعية في حينه، وهي بريطانيا وفرنسا وإيطاليا؛ لكن خروج الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي من الحرب العالمية الثانية دولتين عظميين جعلهما يحلان محل هذه الدول الاستعمارية تدريجاً في الشرق الأوسط، ويدخلان في نطاق الصراع والتنافس على البحر الأحمر، لتجسيد نفوذهما في هذه المناطق والاستفادة من مزاياها الاستراتيجية والسياسية والجغرافية والاقتصادية»(15).
«ووجدت الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي في الصراعات الإقليمية في البحر الأحمر ما يحقق مصالحهما، ويستدعي تَدَخُلُهما. ولعل أهم أوجه هذه التدخلات كان استخدام المساعدات السياسية والاقتصادية والعسكرية كطريقة فعالة لجذب الدول المتصارعة إلى معسكرهما. وبالمقابل كانت الدول الضعيفة غالباً ما تلجأ إلى طلب المساعدات العسكرية من الدول الكبرى التي بدورها يمكن أن تلبي ذلك إذا ما رأت في ذلك خدمةً لمصالحها، فتتحول الصراعات المحلية والإقليمية آنذاك إلى تدخل دولي»(16).
ومنذ خمسينيات القرن العشرين بدأت الولايات المتحدة تعتبر أمن البحر الأحمر عنصراً حيوياً في سياساتها، فسعت بعد رحيل القوى الاستعمارية عنه إلى السيطرة على هذه المنطقة من خلال «بناء قواعد عسكرية وتكوين أحلاف للحفاظ على مصالحها»(17).
وعملت على وضع حقول النفط في البحر الأحمر والخليج العربي تحت نفوذها لتأمين حاجاتها النفطية وتسهيل مرورها إلى أوروبا والغرب. كما عملت أيضاً على «الحيلولة دون وصول الاتحاد السوفييتي إلى المياه الدافئة في المحيط الهندي من خلال هذا المنفذ البحري الاستراتيجي»(18).
وقد ترجمت الولايات المتحدة استراتيجياتها في البحر الأحمر «باعتماد سياسات موالية لإسرائيل، وتأييد الاتحاد الفيدرالي بين إثيوبيا وإريتريا العام 1952، وتشييد محطة اتصالات في أسمرة في إريتريا العام 1953، واستخدام موانئ إريتريا على البحر الأحمر، والحصول على قاعدة الظهران في السعودية، والاعتماد على المنظومة المحافظة في البحر الأحمر لحماية مصالحها»(19).
كما سعت الولايات المتحدة إلى إقامة علاقات طيبة مع الدول العربية المشاطئة للبحر الأحمر مثل السعودية والأردن ولاحقاً مصر والسودان، إلا أن مساعداتها لهذه الدول لا تضاهي ما كانت تقدمه من دعم لـ»إسرائيل».
والعام 1977 حصلت تغييرات مهمة في التحالفات الدولية والمواقع السياسية في البحر الأحمر نظراً إلى وقوع بعض «أنظمة الدول المشاطئة للبحر الأحمر تحت تأثيرات تقدمية وراديكالية ووطنية»(20).
فقد أقدم زعيم إثيوبيا الماركسي مانغستو هايلا ميريام على قطع علاقات بلاده مع الولايات المتحدة، وبالمقابل طردت مصر الخبراء السوفييت من أراضيها في تموز/ يوليو العام 1972(21).
وتبعها السودان في خطوة مماثلة العام 1977، كما سار الصومال على خطى الاثنين فطرد السوفييت رداً على دعمهم إثيوبيا في الصراع الصومالي - الإثيوبي على منطقة أوغادين. وهكذا صارت صورة البحر الأحمر الدولية بعد 1977 مقسمة بين القوتين العظميين، فقد كانت دول شمالي البحر الأحمر (مصر والسودان والأردن والسعودية و»إسرائيل») موالية تماماً للولايات المتحدة، أما في جنوب البحر الأحمر فقد وقفت الصومال وجيبوتي واليمن الشمالي في وجه حلفٍ يضم الاتحاد السوفييتي وكوبا وإثيوبيا، يساندهم اليمن الجنوبي.
إلا أن الولايات المتحدة عززت وجودها السياسي في محيط البحر الأحمر باعتمادها سياسة تسليح الدول المنضوية إلى محورها، فقد استمرت في تسليح السعودية والأردن و»إسرائيل»، بينما توقفت العام 1977 عن تقديم السلاح إلى إثيوبيا. وبالمقابل أصبحت الولايات المتحدة مورداً رئيساً للسلاح لمصر والسودان واليمن الشمالي، بعد تحولها عن الاعتماد على الاتحاد السوفييتي في تسلحها في أعقاب الحرب العربية – «الإسرائيلية» العام 1973، بينما كانت المساعدات العسكرية الأمريكية للصومال لا تكاد تذكر إذا ما قيست بمساعدات السوفييت وكوبا لإثيوبيا. والثابت أن سياسة التسليح الأمريكية لدول البحر الأحمر كانت تتأثر دائماً بالصراع العربي - «الإسرائيلي»، فقد بقي الميزان يميل دائماً لمصلحة العدو «الإسرائيلي»، وهذا ما دعا السعودية والأردن واليمن الشمالي إلى اعتماد سياسة «تنويع مصادر سلاحها»(22).
أما الاتحاد السوفييتي، فقد اتبع سياسة القياصرة الروس في سعيهم الدائم للوصول إلى المياه الدافئة، وأصبحت نظرته إلى البحر الأحمر تكمن في كونه حوضاً مائياً استراتيجياً يمر فيه نفط الخليج، وتُنْقل عبره معوناته إلى حلفائه دول البحر الأحمر وغيرها. إضافة إلى ذلك، يُشَكّل البحر الأحمر «طريقاً قصيراً وسريعاً بين موانئ البحر الأسود السوفييتية وبين الأسطول السوفييتي في المحيط الهندي. كما أصبحت أعماقه والمناطق المتاخمة له محط اهتمام السياسة السوفييتية، لأنها مناطق غنية بالموارد الاستراتيجية ومنها: النفط والنحاس والزنك والفضة والذهب وغيرها من المواد النفيسة»(23).
ويبدو أن الاتحاد السوفييتي استفاد من الظروف الدولية السائدة منذ خمسينيات القرن العشرين للتغلغل في منطقة الشرق الأوسط وبسط نفوذه إلى البحر الأحمر، فاستخدم الصراع العربي - «الإسرائيلي» لتوطيد مركزه في هذه المنطقة واتبع سياسة تقديم معونات عسكرية وإقتصادية لبعض الدول العربية، كما وفرت حركات التحرير الوطنية فرصة له لنشر نفوذه على ضفتي هذا البحر.(24).
ومنذ منتصف الخمسينيات، استفاد السوفييت من انتصار الثورة المصرية ودخلوا مصر، ومنها تمدد نفوذهم باتجاه البحر الأحمر والقرن الأفريقي. والعام 1955 أبرم الاتحاد السوفييتي معاهدة صداقة مع اليمن الشمالي. والعام 1962 أغدق معوناته الصناعية والزراعية والعسكرية عليه بعد نجاح ثورة الجمهوريين على الحكم الملكي فيه، وعَرَضَ توسيع ميناء الحديدة وإنشاء مطارات فيه. لكن السوفييت تحولوا عن اليمن الشمالي ليساندوا اليمن الجنوبي الذي أصبح جمهورية اليمن الديمقراطية الملتزمة النظام الاشتراكي الموالي لهم(25).
ومنذ ثمانينيات القرن العشرين، بدأ المسرح العالمي والشرق أوسطي يشهد أحداثاً وتطورات سياسية ضخمة أرخت بظلالها الثقيلة على منطقة البحر الأحمر. فقد أنزلت الثورة الإسلامية في إيران العامين 1978 و1979 ضربة قاصمة بالاستراتيجية الأمريكية والمصالح الغربية باقتلاع نظام الشاه. ثم تسارعت الأحداث بعد ذلك، فاندلعت مباشرةً حرب عراقية إيرانية طاحنة دامت ثماني سنوات (1980-1988)، أعقبها قيام العراق بغزو الكويت في آب/ أغسطس 1990 وسبقها إعلان إعادة الوحدة بين شطري اليمن في أيار/ مايو 1990. وفي كانون الثاني/ يناير 1991 قادت الولايات المتحدة حلفاً دولياً شارك فيه العرب، وأطلقت عملية «عاصفة الصحراء»، رداً على غزو الكويت، إنتهت باحتلال العراق في آذار/ مارس من العام عينه.
أما العام 1991 فقد مهد قدوم الرئيس السوفييتي ميخائيل غورباتشوف إلى الحكم حاملاً معه البروسترويكا إلى انهيار الاتحاد السوفييتي السلمي، وتفكك المنظومة الاشتراكية العالمية التي تدور في فلكه. وكان من الطبيعي أن يَنْجُمَ عن هذه التطورات العالمية المتسارعة تداعيات ضخمة في منطقة الشرق الأوسط، أصابت دول هذه المنطقة، ولاسيما المشاطئة للبحر الأحمر، فعمدت في ضوء هذه التحولات، إلى تعديل نظمها السياسية وسياساتها الاقتصادية والعسكرية.
الهوامش:
(1) وكالات أنباء.
(2) وكالات أنباء.
(3) دليل (Periplus of the Erythraean Sea).
(4) فكتور سحاب: طوفان الأقصى الصراع على البحر الأحمر: قصة طويلة – «الأخبار» اللبنانية.
(5) المرجع نفسه.
(6) المرجع نفسه.
(7) المرجع نفسه.
(8) المرجع نفسه.
(9) المرجع نفسه.
(10) المرجع نفسه.
(11) نسيب شمس: باب الدموع... مضيق دولي استراتيجي - موقع الخنادق.
(12) المرجع نفسه.
(13) المرجع نفسه.
(14) المرجع نفسه.
(15) العميد الدكتور محمد صبحي الحجار: الصراع على البحر الأحمر: حقبة ما قبل 1980، موقع الجيش اللبناني.
(16) المرجع نفسه.
(17) الإسلامبولي عبد الحميد: تدويل البحر الأحمر مؤامرة ترفضها مصر، ص137.
(18) شديد كمال: البحر الأحمر في الميزان العربي والعالمي، ص43.
(19) السلطان عبد المحسن عبدالله: البحر الأحمر والصراع العربي «الإسرائيلي»، ص 137.
(20) محمود محمود توفيق: البحر الأحمر في الاستراتيجية الدولية، ص 39.
(21) الخوند مسعود: الموسوعة التاريخية الجغرافية، الجزء الثامن عشر، ص271.
(22) السلطان عبد المحسن عبدالله، مرجع سابق، ص14.
(23) المرجع نفسه، ص 149.
(24) العميد الدكتور محمد صبحي الحجار، مرجع سابق.
(25) المرجع نفسه.

.jpg)





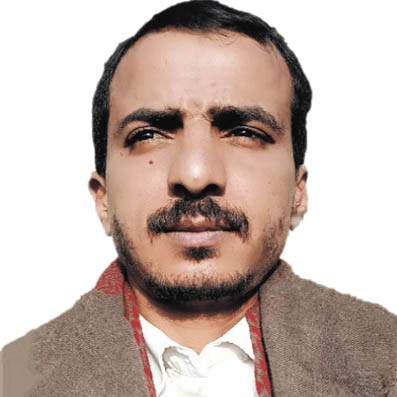


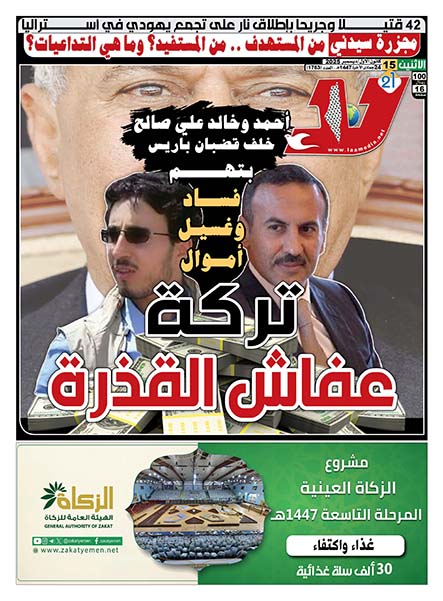

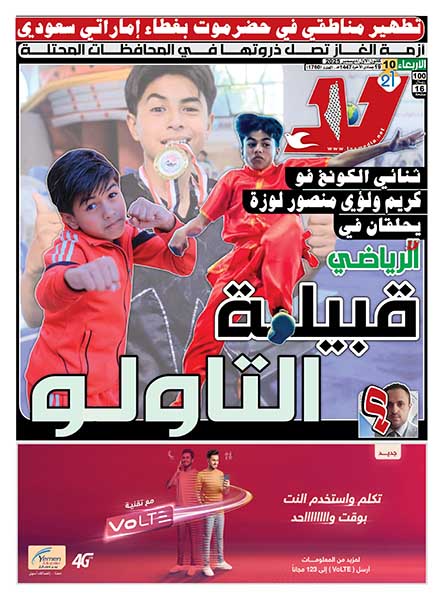
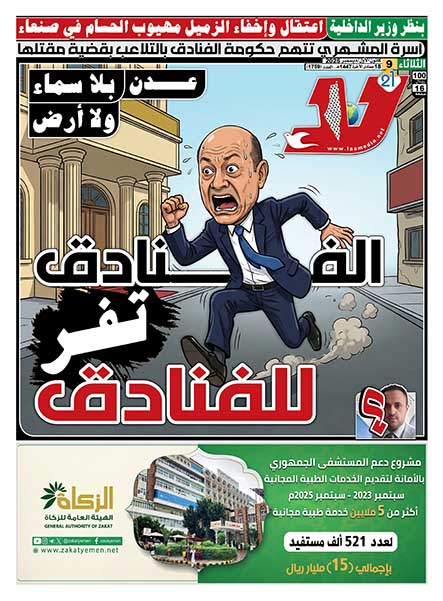
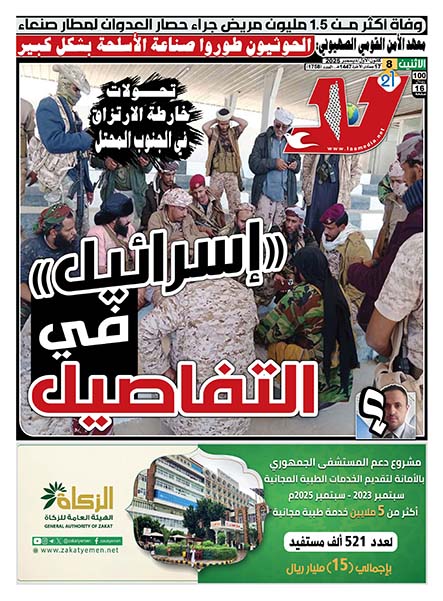
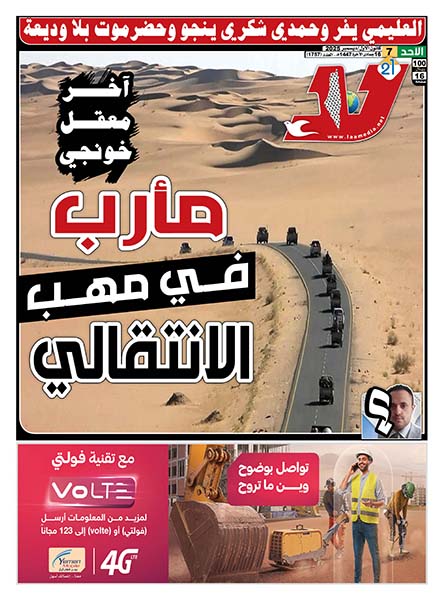

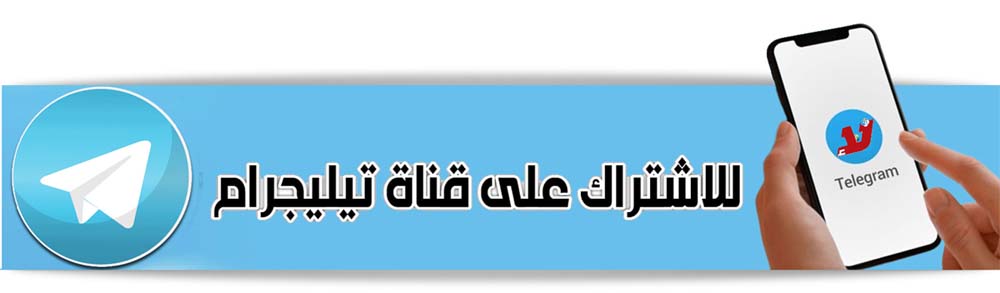
المصدر علي عطروس