الخلـيج من السلفية إلى الرياضة
- موفق محادين الأحد , 22 يـنـاير , 2023 الساعة 7:02:23 PM
- 0 تعليقات
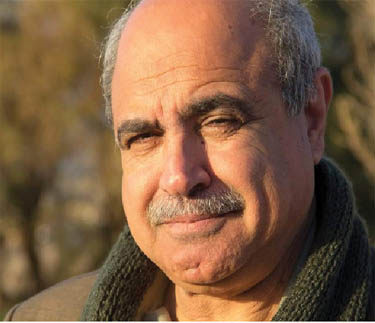
د. موفق محادين / لا ميديا -
قبل المضي في تقصي الخلفية العامة لما صارت تحتله رياضة كرة القدم في السياسات الخليجية، من مونديال قطر إلى شراء السعودية نجوماً دوليين في كرة القدم، نذكّر بأن السياسة تقترب يوماً إثر يوم من عالم الألعاب وقواعدها، بل إن المدارس اللغوية والألسنية لم تكن بعيدة عن هذا العالم، كما تظهر المقاربات اللغوية لفلاسفة مثل: كارناب، ليوتار، فيتخنشتاين، وغيرهم من أنصار الوضعية والرسلية الجديدة (نسبة إلى رسل).
وهو العالم الذي كان حاضراً أيضاً عند استراتيجيين كبار، مثل بريجنسكي، وخاصة في كتابيه: "رقعة شطرنج" و"خطة لعب"، ومثل الإعلامي المصري المعروف محمد حسنين هيكل، الذي كثيراً ما استخدم لغة الألعاب في مقاربات سياسية عديدة، ناهيك عن دبلوماسية "البينغ بونغ" التي مهّدت الطريق للحوار الذي أطلقه كيسنجر مع الصين.
غير أنه لا لعبة تضاهي كرة القدم في التوظيف السياسي أو مقاربة السياسات العامة والخارجية للعديد من الدول، وهي توظيفات مركبة من موروث قديم ومعطيات جديدة.
في الموروث القديم، ثمة ما يسمح لنا بالبحث عن قواسم مشتركة مع لعبة المجالدين القديمة، حيث كانت أرستقراطية روما تستمتع بصراع الأسرى العبيد حتى الموت، قبل أن تتحول هذه المصارعة إلى الأرستقراطيات الجديدة، وعبر أشكال بديلة، من مصارعة الثيران إلى صراع الديوك.
أما المعطيات الحديثة فهي مزيج من توظيف السيكولوجيا البشرية على النحو الذي قصده غوستاف لوبون في كتابه الشهير "سيكولوجيا الجماهير"، ومن الآليات الجديدة للنهب الرأسمالي. من هذه المعطيات:
1- الإزاحة من تناقض أو تعارض إلى تناقض آخر، ونقل ميدان ذلك من السياسة أو الصراع الطبقي إلى المدرجات الرياضية.
2- تنفيس الاحتقانات الناجمة عن القهر الوطني أو الطبقي أو الإثني ونقلها أيضاً إلى المدرجات.
3- الدمج الجمعي في حالة التأويلات التي ترى في الجماهير ظاهرة قطيعية (من قطيع)، وقد أظهرت كرة القدم أنها الأكثر قدرة على توفير هذه الحالة.
4- أما في البلدان التي شهدت تطوراً كبيراً في لعبة كرة القدم، فإن المراهنات والمافيات والسمسرة وتسويق القمصان والأعلام وغيرها هي أبرز هذه المعطيات.
الحالة الخليجية
بالتأكيد، الحالة الخليجية ليست استثناء، لا على الصعيد الدولي ولا على الصعيد العربي: وعلى سبيل المثال فإن السياق العام للاهتمام الأردني الرسمي بكرة القدم بعد حوادث أيلول/ سبتمبر 1970، كان في جزء منه استثماراً سياسياً بالدرجة الأولى، وبقصد إزاحة جمهور كبير من سكان المخيمات عن العمل الوطني نحو المدرجات الرياضية، وتنفيس الاحتقانات السياسية عبر أشكال مختلفة، بينها صناعة نجوم رياضيين بدلاً من المناضلين والمقاومين. كما أصبحت هذه الحالة -على غرار ما هي عليه في بلدان كثيرة- مناخات لتمزيق الطبقات الشعبية واستبدال الحساسيات الجهوية المختلفة بعدوها الوطني الخارجي والطبقي الداخلي.
خليجياً، المسألة أعقد وأوسع، ولا تخلو من أبعاد دولية وإقليمية، إضافة إلى إغواء الثروة الطائلة، سواء في بعدها الطارئ أم في سياقها الاستراتيجي المرسوم عند المتروبولات الرأسمالية وراء البحار، والذي تمت صياغته في إطار الرد على شعارات جمال عبد الناصر أيام المد القومي (وحدة الأمة، ونفط العرب لكل العرب). فوحدة الأمة -بحسب هذه الشعارات- تعني استثمار النفط على مستوى الأمة، مما يتناقض مع مصالح الإمبرياليين ونهبهم للمنطقة وثرواتها.
ومن المؤكد ألا شيء يذكّرنا بذلك أكثر من تبديد أموال الأمة على مونديال قطر ودوري كرة القدم في السعودية، مقابل عشرات الملايين من العرب الجياع والعاطلين من العمل.
إضافة إلى الحالة المذكورة، ثمة مقاربات محلية وخارجية لهذا الاهتمام الخليجي بكرة القدم، أبرزها ما عاشته وتعيشه منطقة الخليج بعد حادثة البرجين، أو ما يعرف بـ"عار الثلاثاء في مانهاتن"، من ابتزاز مستمر من الشركاء الأنجلوسكسون في أمريكا وبريطانيا.
ومن الواضح أن هذا الابتزاز انتقل من المشاركة في النهب واللصوصية المعلنة كما فعل ترامب، إلى إعادة هيكلة البيئة الثقافية والاجتماعية، ومن ضمنها إغراق ملايين الشباب باهتمامات جديدة بعيداً عن التراث الوهابي التكفيري بعد استنفاد دوره.
ومما يستدعي التمعن في هذه الحالة محاولة البعض مقارنة ما يجري في الخليج بما فعله أتاتورك بعد إلغاء الخلافة وبالأحرى السلطنة، فتركيا لم تكن يوماً دولة خلافة، ذلك أن تحولات تركيا عكست حينها مصلحة مشتركة لبرجوازية مدنية صاعدة في كل القطاعات، ومترافقة مع رغبة القناصل الأجانب في دمج تركيا في النظام الرأسمالي الأوروبي. أما البنية السعودية والخليجية عموماً فتعيش حالة من الصدمة، بصرف النظر عن آفاقها.
بالمقابل، ومن دون أي مبالغة، لا ينبغي التقليل من تداعيات البنية الصناعية وانعكاساتها في نشاط متزايد لغرف التجارة والصناعة السعودية، التي تؤدي دور الأحزاب والمؤسسات البرجوازية في بلدان أخرى. ومن المفهوم أن بنية كهذه بقدر ما تحافظ على الخطاب التقليدي تفتح الباب أمام الرياح الأخرى التي تفسر الاستقطابات الجديدة لحفلات الترفيه التي تبدو مستهجنة في بنية تقليدية.
إذن، ثمة مناخات جديدة تحت تأثيرات شتى يراد لها -بسبب هذه التأثيرات- أن تتوسع أكثر فأكثر نحو مجالات أقل خطراً وأكثر جدوى، مثل المجال الرياضي، وتحديداً كرة القدم.
ربما يعتقد مسؤولون خليجيون أنهم -عبر مونديال عالمي وبشراء نجوم كبار في كرة القدم- قد يتمكنون من اقتحام دوريات كرة القدم الأكثر مشاهدة في العالم وجذب جماهيرها إلى شاشاتهم! وربما لا يمانع عرب كثيرون من هذه الرغبة ويرون فيها -إلى حين- شكلاً من الحضور العربي أو القومي! وربما يعتقد آخرون أن هذه المناخات تطوق الثقافة التكفيرية الإرهابية وتفتح الآفاق لما هو أفضل! لكن الدور الإقليمي لأي جهة أو عاصمة ترغب بدخول نادي اللاعبين الكبار، لا يتحدد أساساً بالثروة (على أهميتها)، ولا بالرغبة ولا بالتكيف مع إملاءات خارجية.
فالمهم هو التشخيص الدقيق للشرط الموضوعي لهذا الدور وتركيبته الاجتماعية وموقعه في الإقليم ضمن شروط تاريخية، منها انعكاس الثروة ونموها في تركيبة وعلاقات اجتماعية جديدة تنقل المجاميع ما قبل الرأسمالية، الطائفية والعشائرية، إلى حالة المجتمع المدني، وبتعبير هيجل: من الطبيعة إلى الحضارة (دولة العقد الاجتماعي والحق والدستور والعقل والمواطنة المدنية).
أي: دولة الأمة، في الحالة العربية، التي لا يمكن أن تنهض إلا بشكل جمعي وباستثمار كل إمكاناتها، المالية إلى جانب الثقافية وتقاليدها الحضارية، وتؤدي واجباتها إزاء كل مواطن في نطاق حدودها التاريخية من المحيط إلى الخليج، والأهم هو نطاق السيادة القومية، وفك التبعية ومواجهة عدوها القومي؛ لا من خلال علاقة التبعية العضوية مع المتروبولات الرأسمالية وبالتواطؤ مع عدو الأمة، ممثلاً بالكيان الصهيوني.
وثمة بعد آخر مهم للغاية، هو البعد الحضاري الثقافي، الذي لا يتحقق باستيراد المثقفين والنجوم وشراء ذممهم بعشرات الجوائز والدوريات والمجلات والمنابر، بل بالقدرة الموضوعية على إنتاج ثقافة حقيقية ممثلة بحواضرها التاريخية في مصر وبلاد الشام والعراق وشمال أفريقيا.
كاتب ومحلل سياسي أردني

.jpg)
















المصدر موفق محادين
زيارة جميع مقالات: موفق محادين