المروانية.. صفحة سوداء في تاريخ الإسلام
- عدلي عبد القوي العبسي السبت , 6 أغـسـطـس , 2022 الساعة 7:40:33 PM
- 0 تعليقات

عدلي عبد القوي العبسي / لا ميديا -
من المعلوم أنه في كل ثورة اجتماعية سياسية غالباً ما كان ينشأ صراع بين جناحين سياسيين داخل الثورة: جناح مبدئي، وآخر انتهازي. وللأسف الشديد، نجد في أغلب تاريخ هذه الثورات أن المنتصر غالباً كان هو الجناح الانتهازي المصلحي الكاذب والمنافق، الذي لا تربطه بمبادئ وأهداف الثورة أي صلة.
في المقابل كان الطرف المهزوم هم جماعة المبادئ والصدق، وفي الغالب كانوا أغزر علماً وأكثر وعياً وأقوى إيماناً بأهداف الثورة وأكثر التزاماً بالعمل لمصلحة المستضعفين الفقراء.
والإسلام في مطلع القرن السابع الميلادي كان ثورة اجتماعية سياسية عظيمة غيرت وجه العالم، وقلبت موازين القوى في الإقليم والعالم القديم، وأنشأت دولة عظيمة وحررت الأراضي العربية المحتلة من احتلال أعتى إمبراطوريتين آنذاك (الروم وفارس)، ووضعت العرب على طريق النهوض الحضاري وبدايات التمدين. وليس غريباً أن سميت عاصمة الإسلام الأولى بـ”المدينة”؛ إذ هي كانت لحظة الانتقال الأولى من مجتمع القبيلة والعشيرة إلى مجتمع المدينة.
والثورة الإسلامية الكبرى كان لها ذلك الجوهر الاجتماعي الواضح من بدايات ظهورها على مسرح التاريخ، من حيث أنها انتصرت لحقوق المستضعفين من العبيد والفلاحين وفقراء البدو والنساء، وهاجمت الاحتكار والربا، وأنشأت بيت مال المسلمين، وأعادت توزيع الثروة باتجاه الأسفل عبر فريضة الزكاة والصدقة ومساعدة المحتاجين، ووضعت ركائز اقتصاد جديد يميل أكثر لمصلحة الفقراء ويضع ضوابط شرعية لممارسة التجارة بعيداً عن الاستغلال والاحتكار وجشع الربح ولا عدالة التوزيع، كما كان سائدا آنذاك في إطار المجتمعات اليهودية المغلقة في الجزيرة وخارجها، وكما ساد أيضاً في قريش الجاهلية التي ترأسها أبو سفيان بن حرب الأموي.
كما أن الإسلام وضع قوانين لحماية الحقوق والثروة العامة وحقوق الفقراء، وفصَّل مسؤولية كل مسؤول وحاكم، وبيَّن عظمة حمل المسؤولية والأمانة التي تنوء بحملها الجبال، وحذر الحاكم وكل مسؤول من أن يكون ظلوماً جهولا.
لمسنا ذلك في سياسة وسلوك أبي تراب (الإمام علي) ومنطق أبي ذر ونهج العمرين (عمر بن الخطاب وحفيده البعيد لجهة ابنته عمر بن عبد العزيز)، وقبل هؤلاء جميعاً لمسنا ذلك في حياة يثرب، المدينة التي قادها الرسول الأعظم محمد (ص).
الإسلام كان ثورة اجتماعية، والثورة في مضمونها هي تعبير مكثف عن انفجار الصراع الاجتماعي الطبقي في لحظة الذروة، وثورة الإسلام جاءت في لحظة تعاظم حالة الذل والهوان والبؤس في جزيرة العرب، تناحر وتفرق وهرج وقتل لأتفه الأسباب، وتفاخر وعصبيات واستعباد للناس وامتهان لكرامة المرأة وانحلال أخلاقي وتمزق اجتماعي وضياع الفكر وغياب البوصلة في حالة من غياب الأديان السماوية السابقة أو ضآلة انتشارها، وانتشار البؤس المعيشي الاقتصادي لدى الغالبية، وتبذير وترف ورِبا واحتكار واكتناز للأموال وسعي للثروة لدى القلة المترفة الفاسدة.
وسبب انتشار تلك الظواهر المَرَضية هو انتشار الفقر والبؤس في المجتمع، وهذا هو العامل المسبب الأعظم لسخط الناس في مجتمع جاهلية البؤس والإفقار، والدافع الأكبر لالتفافهم حول (الصادق الأمين) المشهور بالتزام جانب العدل والحق، لأنهم لمسوا في خطابه ومضمون دينه أنه منحاز إلى مصلحة الفقراء والمستضعفين كافة، وأنه كان صادقاً وصريحاً في مقارعة الظلم بكافة أنواعه.
ومن قبل مجيئه كان الحنفاء الإبراهيميون، وعددهم قليل في مكة والجزيرة، ينددون ويرفضون واقع الحال ويشمئزون من جاهلية المجتمع وتفشي سائر الأوبئة الاجتماعية فيه، وكانوا أيضاً الممهدين الذين هيؤوا الناس للخروج من جاهلية البداوة والبهيمية والعنف وقلة العقل إلى رحابة نور الإسلام، دين السلام، ومدينته ونقلته النوعية الحضارية على طريق التطور الاجتماعي.
ومعروف في كتب التاريخ كيف أن الناس قد ضاق بهم الحال في ذلك العصر، وكيف أنهم كانوا يترقبون قدوم النبي المخلص الذي ينقلهم إلى واقع الهداية والمبادئ والمثل الأخلاقية وواقع التحرر والخلاص الاجتماعي، من نير الظلم والفساد والجهل والتمزق، والأهم ما يخلص أرضهم من نير الاحتلال الفارسي البيزنطي البغيض.
الدين الإسلامي في جوهره هو دعوة إلى العدل والمساواة والحرية والمؤاخاة بين الناس، وفي مضمونه الاجتماعي هو ثورة اجتماعية ضد الظلم الاجتماعي، وفي أساس فكرته السياسية هو رئاسة لمجتمع المتساوين في الحقوق، وليس مُلكاً عضوضاً متوارثاً جيلاً بعد جيل، ولا يعترف بأي وجاهة ارستقراطية وامتيازات وتمييز واستبداد بالحكم واستئثار بالسلطة كما فعل بنو أمية وفرعهم المرواني ومن بعدهم بنو العباس... وهلم جراً.
في هذه الثورة العربية الإسلامية الكبيرة نشأ ذلك الصراع الاجتماعي السياسي داخل الثورة، مثلما حدث ويحدث تاريخياً في كل الثورات التي جاءت قبلها وبعدها. ونستطيع القول بأن ظروف نشأه الثورة وأسبابها في الجاهلية هي نفسها ظروف نشأه الثورات اللاحقة التي حدثت في العصر الإسلامي الأول، والتي أرادت أن تصحح المسار وتنقذ الأمة من ويلات يجلبها الانحراف عن النهج ويسببها حكام انتهازيون ونفعيون جدد كان آخر همهم هو صلاح أمر الناس ومعاشهم وأمنهم وأخلاقهم.
في العصر الإسلامي الأول، وتحديداً في النصف الثاني من زمن الخلافة الراشدية، بدأت مظاهر الانحراف في الحكم والإدارة وسياسة أمور الدولة والناس.
لم يتوقف الصراع الاجتماعي الطبقي مع دخول الناس في العهد الجديد، عهد الإسلام، وإنما وجدنا أنه في سياق الصراع الاجتماعي الأكبر كان يتبلور شيئاً فشيئاً بمرور الوقت صراع سياسي له خلفيته الاجتماعية، هو صراع الجناحين السياسيين. هذا الذي نعرفه في التاريخ الإسلامي: صراع سياسي بين الثوار الملتزمين بمبادئ الثورة وأهدافها ونهجها من قادة المستضعفين الذين يملكون الإيمان وقوة الحجة والعزيمة وجلهم من الفقراء والكادحين، وبين المستكبرين الذين يملكون السلطة والجاه والمال والسطوة، ومن حولهم شبكة من المنتفعين المصلحيين الانتهازيين الساعين وراء فتات السلطة ولديهم القدرة على التغرير بالناس باستخدام وسائل شتى أهمها المال والمناصب، وخداع الناس البسطاء العوام ببث الشائعات وكيل الاتهامات والطعن في أخلاق وسلوك ونزاهة وشجاعة ومصداقية الطرف الآخر.
هكذا جرى الحال في جو من حداثة العهد بالإدارة والسياسة، وحداثة وطراوة الدولة الجديدة الناشئة باتساعها الجغرافي الإمبراطوري وبما حازت عليه تحت تصرفها من موارد غزيرة في الأمصار التي شهدها الفتح الإسلامي، واتساع مدى حجم سكانها ورعاياها من شتى الأجناس والمذاهب والثقافات، وهو ما ألقى بعظم المسؤولية على الحكام المسلمين من كل المستويات، في المركز والأطراف.
في تلك الظروف المستجدة والتحولات الاجتماعية المتسارعة أثرت قلة المعرفة والخبرة القليلة المكتسبة في الإدارة والسياسة والحكم وقلة العارفين بشؤون الإدارة والحكم، وحيث وجد التهاون الكبير، مع وجود قليلي الخبرة والمعرفة وضعيفي الكفاءة والنزاهة، في حساب خطورة إهمال مصالح الناس وإدراك ما ينفعهم في شؤون دنياهم ومعرفة مطالبهم واحتياجاتهم وخطورة تولية المناصب لمن هم دون مستوى الكفاءة والمعرفة والإخلاص والنزاهة والتقوى والقدرة على كسب الناس البسطاء إلى صف السلطة الجديدة.
كانت تختلف الآراء وتتباين المصالح ويحدث الانقسام السياسي ويحدث الصراع بالمحصلة لهذه التحولات والمستجدات، وكذلك كنتيجة لسوء وتدهور أوضاع السواد الأعظم الفقير من أبناء الأمة. لهذا نقول إنه أمر طبيعي أن يحدث الصراع الاجتماعي، وأن يتمظهر بشتى المظاهر السياسية والفكرية والثقافية، طالما هناك صادقون مؤمنون أقوياء في إيمانهم، وكاذبون ضعيفو الإيمان، وطالما هناك ارستقراطيون إقطاعيون وتجار وكبار مشائخ لا همّ لهم إلا السلطة والثروة.
وفي المقابل هناك علماء وثوار مجاهدون وفلاحون وبدو بائسون وغاضبون، همهم الأساس والأكبر هو تحقيق أهداف الثورة، لا تحصيل الثروة وامتلاك السلطة!!
طالما هناك منتفعون يستأثرون بالمال العام، ومحرومون مستضعفون يكابدون شظف العيش ويصرخون من شدة البؤس والجوع وهوان الحال، فمن الطبيعي حالئذٍ أن يتصارع مزاجان: مزاج غفاري (نسبة إلى الصحابي الجليل أبو ذر الغفاري)، ومزاج مرواني (نسبة إلى مروان بن الحكم الأموي).
أبو ذر الغفاري دافع عن حقوق الفقراء والجياع، وانتقد -بلا هوادة- السلوكيات الانحرافية لبني أمية في زمنه، أي زمن بدايات تمكنهم من النفوذ وتغلغلهم في مفاصل الدولة الجديدة طمعاً في استعادة الحكم والوجاهة القرشية التي ضعضعها محمد وأتباعه!
ومروان بن الحكم الأموي أسس الدولة الأموية الثانية، المروانية، الجائرة المستبدة العنصرية الفاسدة الارستقراطية الإقطاعية.
مروان والغفاري أهدافهما ومصالحهما كانت مختلفة، ودرجة التزام كل منهما بجوهر الدين الإسلامي كانت مختلفة، الدين الإسلامي الذي هو دين العدالة والمساواة والنزاهة، دين مناصرة الفقراء والمستضعفين، دين القدوة فيه للعلماء وأئمة الهدى، وليس للملوك وشيوخ العشائر والتجار، دين الأمة، دين الشعب، وليس دين الارستقراطية والملك.
وشتان ما بين من يظهر أطماعاً صريحة للحكم، وبين من يقود حركة ثورية معارضة ضد الانحراف عن نهج الحكم، وضد التمييز الاجتماعي، ضد الذين اتخذوا القصور وامتلكوا الأموال وميزوا أنفسهم عن عامة المسلمين في عيشة ملوكية، كما مارس البعض من الولاة، تحديداً من بني أمية، زمن الخليفتين الثاني والثالث، ثم بعد ذلك حولوها إلى “ملك عضوض”، وهو ما حذر منه النبي العظيم ونبه أصحابه وآل بيته إلى مخاطر مقبلة ستواجهها الأمة من هؤلاء الحكام المستبدين الفاسدين.
وفي نبوءته هذه (ص) إشارة إلى ما استبصره واستشرفه من أطماع وكذب ونفاق البعض من أهل قبيلته قريش (بني أمية على رأس هؤلاء)، وقبائل أخرى، وقد أدرك بحدسه النبوي مخاطر التحرك المستقبلي لهؤلاء ضد مصالح الأمة الإسلامية ومصالح المستضعفين والفقراء والحزانى، الذين قلنا إنهم يمثلون سواد الأمة وغالبية تعداد المجتمع الإسلامي من فلاحين وبدو وكسبة وغيرهم.
ومع إهمال وضع معيشة الفقراء وتفاقم سوء هذا الوضع، بالتأكيد ستسود وتنتشر كل الظواهر الاجتماعية السيئة وتنتشر روح التمرد والثورة، وقبلها وبعدها تسود الفوضى، فالفقر هو أساس المصائب وأبوها، ولهذا السبب قال الإمام علي: “لو كان الفقر رجلاً لقتلته”، وهذا القول دليل حكمة عظيمة يمتلكها رجل عظيم.
هذا -إذن- هو الفرق -في مطلع أيام الثورة الإسلامية الكبرى- بين تحرك وقصد بني أمية وتحرك وقصد بني عمومتهم من آل البيت أو الهاشميين العلويين كما يحب أن يسميهم المؤرخون، ومعهم نصيرهم الأكبر أبو ذر (أصدق من أقلت الغبراء وأظلت السماء) الذي اشتكى إلى الخليفة الثالث عثمان ما انتشر في عهده من مظالم ومفاسد لا يقبلها الله ورسوله، واعتزل الناس بعد خلاف مع الخليفة، وعاش ما تبقى من عمره ومات وحيداً!!
ما دفعني لكتابة هذه السطور فقط أن أنبه كل من يحب أن يتناول هذه المرحلة أن يتحرى الموضوعية، وأن يتجنب الوقوع في فخ الإساءة لعظماء ورموز الثورة الإسلامية المحمدية الكبرى، والتي يفتخر بتراثها وجانبها المضيء المشرق وكل الثوار والأحرار في العالم، ويستلهمون منها ومن كل الثورات الأخرى العظيمة معاني نصرة المستضعفين وتحقيق العدل والمساواة والحرية.
ولا بد من الحذر وعدم تصديق مرويات فقهاء السلاطين في دول سلطانية، وعلى مر أزمنة متباعدة، انحازوا إلى الطرف المخاصم والمعادي لهؤلاء العظماء، وهم كما هو معروف أيضاً ليسوا محل ثقة مطلقة، وبشر تتحكم بهم أهواؤهم ومصالحهم السياسية ونزعاتهم الفكرية وعصبياتهم المذهبية.
أردت أن أنبه وأشير إلى ضرورة الالتفات إلى السياق الاجتماعي التاريخي والخلفية الاجتماعية لكل الصراعات والتجنحات السياسية التي حدثت آنذاك، وفيما بعد أيضاً، أن نعرف أولاً أين كان الحق في صراع الطرفين المتناقضين اجتماعياً وسياسياً وفكرياً وأخلاقياً.
ولا شك أن أي مظاهر سيئة حدثت في القرون التالية أو أخطاء أو شطحات أو ربما انحرافات نظرية وسلوكية سياسية ارتكبها أفراد أو جماعات أو أنظمة حكم إسلامية باسم عظماء الإسلام الكبار لا تؤثر في مصداقية هؤلاء ولا في نبل أخلاقهم وعظمة مواقفهم وسلوكهم وعظمة الحركة الثورية النبيلة التي بدأت مع أبي ذر وعمار والإمام علي وأحفاده الثوار وامتدت واستمرت إلى زماننا هذا. فأين سيقف مروان الغفوري في مقاربته للتاريخ في تلك اللحظة؟! هل مع الحزب الغفاري أم مع الحزب المرواني؟!
لا مشكلة في أن يطرح أسئلة، أن يثير جدلاً حول مسائل هامة، أن يقول رأيه، أن يبحث في التاريخ، أن يلقي حجراً في البركة الراكدة كما يعتقد هو، وهذا حقه؛ ولكن المشكلة تكمن في الانزلاق إلى الإساءة للرموز والعظماء، وفي إظهار نوع من عدم الاحترام للمشاعر الدينية أو هكذا بدا لكل من قرأ مقالاته التي تبدو نوعا ما مستفزة!!
المشكلة هي في المسارعة إلى إصدار أحكام بخلفية حزبية ومذهبية مسبقة، انطلاقاً من عقد ما ومن قناعات أيديولوجية راسخة أو شعور بالاضطهاد أو خيبة أمل من تعثر مسار الثورة الشعبية أو بالأحرى الفشل الحزبي السياسي لحزب ما في الظفر بالسلطة أو الاحتفاظ بها، وهو هنا في رأيي يسقط في رد الفعل الانفعالي ويتجنب الموضوعية والهدوء والعقلانية، ومن غير قصد يساهم في إذكاء مشاعر الفتنة الطائفية وتأجيج الكراهية بين الناس، وهو يعلم جيداً من هي القوى التي تستفيد من إثارة الفتنة الطائفية في اليمن وفي كل دولة عربية، وأخشى أن نكون هنا بصدد مثال حالة “مثقف كراهية”، ولكن من خانة اليمين الديني الليبرالي المتاورب.
الأستاذ مروان المعروف عنه نقده للفاشية، كان ينبغي عليه أن يتجنب الوقوع في فخاخها وأوهامها ومروياتها. وكمثقف وأديب مبدع له قلب الأديب وقلب الطبيب وشخصية عامة مشهورة يتابعها ويقرأ لها الملايين من مختلف الاتجاهات والمشارب السياسية والفكرية، كان ينبغي عليه أن يجتهد ويهتم أكثر في مقارباته وتناولاته، ويتجنب قدر الإمكان الوقوع في الأخطاء، فهي مسؤولية كبيرة يتحملها بما له من تأثير على الرأي العام اليمني.

.jpg)









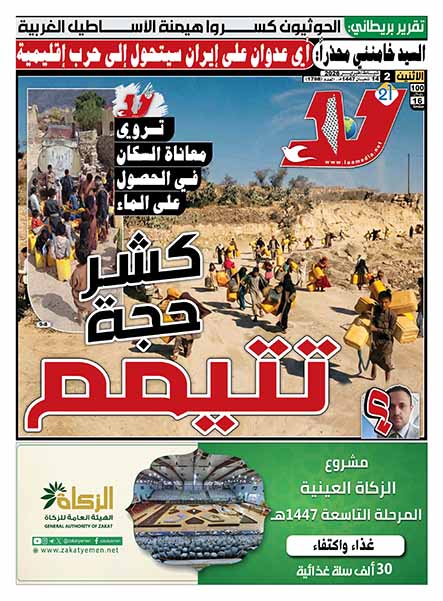






المصدر عدلي عبد القوي العبسي
زيارة جميع مقالات: عدلي عبد القوي العبسي