الكتابة كإرجاء وممحاة لقسوة الذاكرة ...في «أطياف عدن - هذيان الحطب - شهادات سياسية» الحلقة الأولى
- محمد ناجي أحمد الأحد , 21 يـولـيـو , 2019 الساعة 7:03:10 PM
- 0 تعليقات

محمد ناجي أحمد / لا ميديا -
في كتابه "أطياف عدن - هذيان الحطب - شهادات سياسية"، (الصادر عن دار ميّارة، تونس، 2019م) يلج منصور هايل بعتبتين نحو محاولة النسيان، والتطهر من الذاكرة، مفتتحاً سرديته بعبارة للدكتور أبو بكر السقاف عن عدن التي لا تمنح حبها للغريبين عنها بالروح، وفي ذلك يتساوى موقفها الرافض للبدوي الجهول والقبيلي الغازي والقرصان الامبراطوري. فهي تهب حبها لمن يتماهى مع روحها، من خلال مهنة يحترفها ويذوب في تنوعها المفتوح على الريف والبحر والبادية، شرط الانصهار في "حافاتها" وحواريها كأفراد لا كقطعان بدوية أو قروية أو تجريف امبراطوري ليمنيتها.
«الذين يتجاهلون الماضي هم معرضون لأن يخرج عليهم الماضي من مكمنه، مطلقا عليهم الرصاص دون رحمة»
(الشاعر الداغستاني رسول حمزاتوف).
والعتبة الثانية يقتبسها الكاتب من "مقدمة ابن خلدون" تلخيصاً لدلالة الدولة التي تتحكم بها أهواء وعصبيات القبائل، فوراء كل رأي عصبية وهوى، وانتفاضات تستحكم بالدولة وتخرج عليها.
بمقدمة عنونها بـ"أمَّا قبل" يهيئ الكاتب قارئه للولوج إلى ذاكرة نشطة ومخاتلة "باتجاه الاعتبار بما صار وإسعاف ما تبقى من خريف".
هي ذاكرة "تجاوزت سن النبوة والزعامة"، وإن كانت تبحث لنفسها عن جمهور يغفر لها ما سكتت عنه، لكنه كالوشم في القلب، عبر عنه بكتابة رملية تخاصمها الريح.
هي على حد تعبيره "ليست بحاجة إلى تدليك أو نفاق وتملق ذوي الشأن والبأس والسلطان، فقد بلغت سن الشتات"، مما يحيل القارئ إلى مرحلة ما قبل الشتات ومتلازماتها التي تغور إيحاء لا تصريحا!
توطئة مكثفة الدلالة، موقفاً ورؤية ومساراً. ولأن السياسة في اليمن "فتوحاتية وانتحارية شخصية وجماعية"، ولأن الساسة في جُلّهم "استثمروا كثيرا في الرياح إلى الدرجة التي أودت بنا إلى هباء العاصفة"، فإن ذلك أودى بنا إلى فشل في بناء مجتمع متآصر ومتضامن لا يُقصى فيه أحد، ويكون الأمل متاحاً للجميع، فزعماء النكد والغصة وشيوخ السياسة وديناصوراتها... عاشوا زمنهم نكداً ومحناً وجشعاً واستكلاباً واستذئاباً، وأجبروا الناس على طهي الحصى والإقامة في عراء التصحر الإنساني، وتحت خط الفقر السياسي والثقافي والمعرفي، وعلى خط الإرهاب والرهاب والذهان والهذيان، وفي خارطة ملتهبة بجغرافيا الأحقاد والضغائن والثأر".
في "توثب" ما بعد العشرين كان الكاتب مع قدر "الوقوف على الأطلال والجماجم والخرائب"، وحكم عليه "بالهرم المبكر والشيخوخة المستعجلة" من هول ما عاشه، ومن فداحة خسرانه لأصدقائه، وخسارته في "اختراع وطن"، فكارثة 13 يناير 1986 لم تكن حدثاً عابراً، وإنما "كانت أكبر عملية انتحار جماعية، وعلامة فارقة وصارخة على الإخفاق في إدارة الخلاف والاختلاف، وعلى الخفة والانزلاق إلى تصفية الخصوم والقتل، وبالأحرى تصفية شرط الحياة والوجود الإنساني القائم على الاختلاف أصلا".
13 يناير "كانت وليمة القتلة قد استحضرت المحاربين من قبائل طوق عدن، وكافة أصحاب السوابق من المشاركين في جرائم واغتيالات سالفة، وتصفيات و"لحس" وزعران وفتوات الحواري، بقصد تأهيلنا لمستقبل أكثر ميليشاوية وفوضوية ودموية، وبالكثير من جرعات التوحش". وكان "المثقف هو المتهم رقم 1"... "طغمة" رممت عرش سلطتها بأكداس من جثث الرفاق في "الزمرة" الذين اندحروا وهربوا وتشردوا، واعتقلوا وقتلوا، كما كانوا قد فعلوا تماما برفاقهم في "الطغمة".
يتساءل الكاتب بلغة تحفر في مفارقات التسميات والآمال، بما يعري حالة التوحش بانشطار دلالات الأسماء: "ترى كيف كنا نقيم جنة اشتراكيتنا فوق ذلك الجحيم الذميم؟! وأي عقلية زقاقية نفاقية كانت وراء ذلك الاختراع الفظيع؟!". "سجن الفتح" تكثيف لهذه المفارقة السوداء، وما يحمله من دلالات "الفتح المبين" و"في صيرورته إلى سجن للفاتحين!". تتجلى في التسمية القصدية في استلهام "نرجسية الفتوحات الأولى، وترتد بالذاكرة الغريقة إلى سماع رنين أجراس أمجاد الأسلاف وتناهيها ثم تلاشيها وانحباسها في كاتم صوت هذه المغارة: سجن الفتح".
يصرّ الرفاق من مصر، وعلى الخصوص حسين عبدالرازق -رئيس تحرير صحيفة "الأهالي" آنذاك، وزوجته فريدة النقاش، على زيارة المعتقلين، ومعرفة حال الرفيق فاروق علي أحمد، والتقوا بالأمين العام علي سالم البيض، "الذي كان ظريفاً بتجديفاته وتهريفاته عن الشفافية الطبقية، وتقبلوا كلامه بوقار رفاقي وصبر أيوبي...".
يرى الكاتب أن "حجم استبطان الريبة و"المؤامرة" لدى رفاقنا في "القيادة الجماعية" بعضهم ببعض وبغيرهم، كان مذهلاً ومهولاً ويتجاوز كل حدود المعقول".
الكتابة عن كارثة يناير لها دافعان، أحدهما ذاتي، أغفل المؤلف الحديث عنه، مكتفياً بإشارات وتلويحات مجملة، بقوله: "إن المسألة شخصية جدا".
هل اصطف الكاتب مع الطرف المنتصر بالقول أو بالصمت، أو بتبوؤ منصب مدير تحرير صحيفة "14 أكتوبر" خلفاً لأحد الضحايا الذين سحقتهم الكارثة بكلكلها؟! ففي غلاف الكتاب يبين الكاتب في سيرته أنه كان مديراً لتحرير "14 أكتوبر" في الفترة 1986-1990!
لهذا تصبح الكتابة تحرراً وانعتاقاً من زنزانة الإثم! ويكتفي الكاتب بالحديث عن البعد الموضوعي للكتابة: "ثم إني أريد أن أتحرر من مجزرة يناير وأثقالها، بمعرفة بواعثها وأسبابها، وعبر استكشاف واستنطاق الدهاليز الغائرة في النفس البشرية وشركاء الإخفاق، والنأي بالنفس عن مسايرة قطعان الكراهية ومن يرفعون راية "التسامح والتصالح" من باب "التكتيك/ الكمين"، وبالانطلاق من منطق ثأري، عبر تعريف الذات بكراهية الجار في القرية المتاخمة".
ما الرابط بين اعتقال وإخفاء أحمد سالم الحنكي، مدير دار الهمداني، ورغبة الكاتب في التحرر والانعتاق الشخصي من جريمة يناير؟!
في "أطياف عدن..." كشهادة سياسية ببعديها الذاتي والموضوعي يظل مشهد المثقف والمدينة جوهرياً في هذه السردية التي ترقى لأن تكون عملاً روائياً مميزاً. فكارثة 13 يناير لم تجرف المدينة عدن فحسب، وألقت بها إلى البداوة والذهنية البدوية، وإنما "لحست" المثقف بإعدامات جماعية، ومحاكمات صورية، كانت نتيجتها إعدام العقل والمدينة في آن.
هناك صوت ظل يتردد حافراً بإزميله في جرح الكاتب. إنه صوت فاروق علي أحمد، المثقف، رديف المدينة وضميرها وأفقها. حين اعتقل بتهمة أنه هو الذي كتب خطة يناير وورقة العمل، "سأله القاضي: هل كتبت الخطة؟ لماذا كتبت؟ فكانت إجابة المثقف والمفكر الساخر من المشهد الدموي الذي لا يحتاج إلى حيثيات لينطق بحكم إعدام المثقف، كانت إجابته الساخرة: لأن خطي مليح!"، بحسب كتاب منصور هايل. ففاروق تنويري قل أن تجود به المدينة، فلقد نشأ مع توهج المدينة عدن، وتم إعدامه والمدينة في آن، في تعرية للصراع الذي تفجر لأسباب قبلية ومناطقية ورغبات شخصية في التسلط، إلى جانب دور قام به الشيوعيون العرب من مصر ولبنان والعراق ومن تمركسوا من قيادات حركة القوميين العرب من الفلسطينيين، وكانت "الطغمة" و"الزمرة" جاهزة للاستماع إلى ما يعزز شهوة الحكم لديها.
الصوت الذي ظل يتردد في أعماق هايل منصور مشكلاً جرحاً غائرا لا ولم يتشاف، هو صوت فاروق علي أحمد، حين زاره منصور هايل بصحبة وفد من الشيوعيين المصريين، وعلى رأسهم رئيس تحرير صحيفة "الأهالي" حسين عبد الرازق وزوجته فريدة النقاش. سأل فاروق: كيف حالك أخي منصور؟ بعتاب وحنو. ومنصور وقتها أصبح مديراً لتحرير صحيفة "14 أكتوبر" خلفاً للمدير السابق (فاروق رفعت) الذي تم اعتقاله وتصفيته في براري شُرَّاب الدم.
والصورة الملازمة للصوت والموسعة للجرح كانت صورة أحمد سالم الحنكي حين تم اعتقاله بعد أسبوع من انفجار الكارثة. شاهده من فتحة ضيقة للطربال، وهو في سيارة الاعتقال، أخذوه من جمارك المعلا إلى لحج، إلى براري القتل الجماعي! أحمد سالم الحنكي الذي وقف إلى جوار منصور داعماً له في عمله، بل وفي توظيفه بمنصب قيادي بصحيفة "14 أكتوبر"، وإعفائه من الخدمة العسكرية الإجبارية، وفي ثالث يوم من كارثة يناير كاد الموت أن "يلحس" منصور هايل لولا أن أنقذه أحمد سالم الحنكي، وأخذه إلى مكان آمن. يشاهده منصور بعد أسبوع من الكارثة وقد وشى به واحد من الذين أغدق عليهم الحنكي بمواقفه ورعايته! من هو هذا الشخص الواشي؟! الكاتب لا يخبرنا، وكأن العدالة لا تتحقق، والتصالح لا يتم، والتسامح لا يكون، إلاَّ بمحو أي إدانة ولو كانت معنوية، الذين وشوا والذين نفذوا جرائم "اللحس الجماعي". هنا يستمر التواطؤ، يستمر القتل، من خلال المحو والنسيان.
على عكس نصيحة رفاقه بأن "الوقت مش مناسب للكتابة" فالكتابة فتنة، يندفع منصور للكتابة، لكنه لا يبوح بشيء، سوى البكاء على مدينة تلاشت ومثقف تم "لحسه". لا تدين الكتابة هنا القتلة بأسمائهم، وإنما تحيل إلى عموميات هي في ذاتها إرجاء وطمر بزهايمر إرادوي. الكتابة هنا ليست بغرض الإنصاف بتعرية القتلة والمطالبة بالعدالة منهم. مخاتلة للعواطف، وتخدير بالكلام الذي هو أقرب إلى الصمت أو الثغثغة، ورجع أحزان الإبل، حيلة بدوية لطالما كان البدوي يقتل ثم ينوح على الضحية!
عدن تلاشت كحاضرة تمتص القروي والبدوي. والغريب شرط أن يتماهى الجميع مع روحها المدينية! والكاتب لا يرى حضوراً لعدن في سياق دولة "الوحدة اليمنية"، بل يرى أن ذلك مماثل لدولة الخلافة الاشتراكية ودولة الخلافة الإسلامية واتحاد إمارات الجنوب العربي! هنا نسأل الكاتب: أي حضور عدمي للمدينة إن لم تكن الوحدة اليمنية بركيزتيها، الحرية والعدالة، هي الضامن لمدينية ومدنية اليمن؟! السقوط في العدمية انتصار للبدائية، وديمومة للتوحش الذي نئن منه!
لم تُبْقِ كارثة يناير لمنصور رأساً. وما يزعم في الكتاب أنه كتب شهادته السياسية في هذا الكتاب لأن "رأسه رئيسه" يدحضه صمت الكتاب عن قول شيء غير مرمي في الطرقات يعرفه العابرون والمارة!

.jpg)








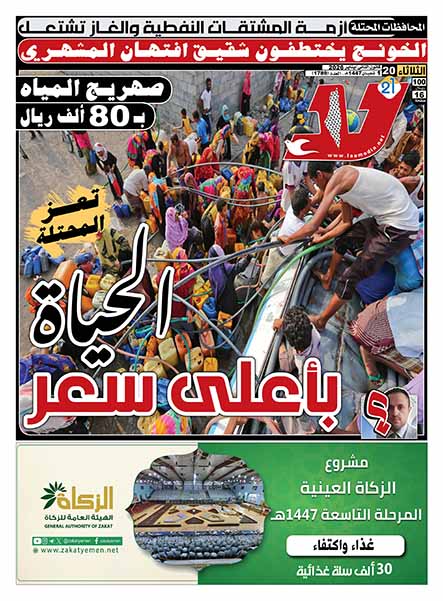







المصدر محمد ناجي أحمد
زيارة جميع مقالات: محمد ناجي أحمد