النقد البناء.. مناعة الدولة وسر قوتها
- فهد شاكر أبو راس الثلاثاء , 17 فـبـرايـر , 2026 الساعة 12:08:17 AM
- 0 تعليقات

فهد شاكر أبوراس / لا ميديا -
في قلب المشروع الحضاري لأي أمة تتبلور فكرة أساسية لا تقبل المساومة: أن النمو الحقيقي لا يُبنى على تمجيد الذات أو تغطية العيوب، بل على التمحيص الدقيق والمراجعة المستمرة.
وهنا تبرز قيمة النقد البناء ليس كخيار ثانوي، بل كضرورة استراتيجية لا غنى عنها. إنه في جوهره آلية تشخيص حيوية، وأداة مراقبة مستمرة، ونظام إنذار مبكر متطور، يصطاد مواطن الخلل والضعف في مهدها، قبل أن تتحول إلى أورام سرطانية تنخر في بنيان الدولة ومؤسساتها.
فالدولة، في رحلتها نحو التقدم، تشبه السفينة العملاقة التي تبحر في محيط متلاطم الأمواج؛ قد تبدو صامدة وقوية من الخارج، لكن سلامة رحلتها تعتمد على آلاف التفاصيل الداخلية؛ من متانة الهيكل إلى كفاءة المحركات إلى دقة الخرائط الملاحية.
وفي خضم المعارك اليومية ضد تحديات التنمية والأمن والمنافسة العالمية، قد تنشغل طواقم الإدارة عن ثغرات صغيرة، أو تكرر نماذج عمل متقادمة، أو تنغلق أقسام منها على نفسها في دوائر من الروتين والعزلة.
وهنا يأتي النقد ليكون العين الناقدة، والنظرة المجردة من التحيز، التي ترى ما قد لا تراه العين الداخلية المعتادة على المشهد. إنه ذلك الصديق الأمين الذي لا يخدعك بمجاملة، بل يقدم لك المرآة الحقيقية لوجهك، أو ذلك الطبيب الخبير الذي يفحص المريض القوي البنية ليس بحثاً عن مرض ظاهر، بل للتأكد من أن كل شيء يسير على ما يرام، ولالتقاط أي إشارة غير طبيعية قد تكون بداية لمشكلة أكبر.
إن إهمال هذا "الفحص الدوري" الاستراتيجي للدولة لا يعني أبداً غياب العلل أو الثغرات؛ بل يعني ببساطة السماح لها بالنمو والتضخم في صمت، تتغذى على موارد الأمة وطاقتها، حتى تصل إلى مرحلة حرجة تفاجئ الجميع بانهيار مفاجئ، أو أزمة عاصفة، يكون علاجها آنذاك باهظ التكلفة، إن لم يكن مستحيلاً. ولهذا، فإن الثقافة المؤسسية التي تحتضن النقد البناء وتؤسس له قنوات وآليات واضحة، هي ثقافة الكائن الحي الذي يتكيف ويتعلم، وليست ثقافة التمثال الصلب الذي قد يتحطم بأول عاصفة.
وهذا يقودنا إلى حقيقة أعمق: النقد ليس عدواً للولاء أو الانتماء، بل هو ذروة الإخلاص. فالكاتب أو الناشط الذي يبذل جهداً فكرياً وعملياً لتحليل أوجه القصور واقتراح سبل الإصلاح، هو من يضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، وهو على النقيض من أولئك الذين يفضلون الصمت المريح أو المجاملة الخادعة، والتي تخدم مصالح شخصية ضيقة على حساب المصلحة العامة.
لقد شهد التاريخ كيف أن الحضارات التي ازدهرت كانت تلك التي سمحت بحرية النقاش والاختلاف داخل إطار الوحدة والهدف المشترك، بينما كانت الثقافات القمعية التي حجرت الفكر وحظرت النقد تترنح ثم تنهار من الداخل بسبب تراكم الأخطاء والعيوب التي لم يجرؤ أحد على مواجهتها.
إن بناء دولة المستقبل لا يحتاج فقط إلى مهندسين وأطباء وعلماء، بل يحتاج بشدة إلى "نقاد بنائين" في كل مجال: نقاد للسياسات الاقتصادية، ونقاد للأداء الإداري، ونقاد للخطط التعليمية، ونقاد للاستراتيجيات الأمنية.
هؤلاء الذين لا يكتفون بالتنفيذ الآلي، بل يمارسون التفكير النقدي الذي يربط بين الأسباب والنتائج، ويسأل الأسئلة المحرجة والمفيدة: لماذا نفعل ذلك بهذه الطريقة؟ وهل هناك طريقة أفضل؟ وما هي التكاليف الخفية لهذا القرار؟ وما هي البدائل المطروحة؟ وكيف ستتأثر الفئات المهمشة؟
إن تطوير هذه العقلية النقدية الجماعية هو استثمار في رأس المال الفكري للدولة، وهو درع واقٍ ضد الجمود والترهل.
ولا يمكن لهذا أن يحدث في فراغ؛ فهو يحتاج إلى بيئة مؤسسية آمنة تشجع على تقديم الملاحظات دون خوف من الانتقام أو التهميش، وتتبنى منهجية علمية في تقييم هذه الملاحظات ودراستها. كما يحتاج إلى قيادات واعية تدرك أن صوت النقد البناء هو هدية ثمينة، وليس تمرداً أو تشويهاً.
هذه القيادات هي التي تمتلك الثقة الكافية لفتح أبواب الحوار، والمرونة الكافية لتعديل المسار عندما يثبت النقد صحة وجهة نظر معينة.
ومن المهم أيضاً التمييز بوضوح بين النقد البناء الهادف إلى الإصلاح، والنقد الهدام الذي يهدف إلى التشكيك في الأسس أو زعزعة الثقة دون طرح بديل. الأول يعمل ضمن إطار المصلحة الوطنية ويقدم الحلول، بينما الثاني يعمل على تقويض الروح المعنوية وإثارة اليأس.
ومسؤولية التمييز بينهما تقع على عاتق مؤسسات الدولة التي يجب أن تتعامل بجدية مع الأول، وتواجه الثاني بالحجج والبيانات والشفافية.
إن تعقيدات العصر الحديث، من الثورة الصناعية الرابعة إلى التحديات البيئية إلى التحولات الجيوسياسية المتسارعة، تجعل عملية النقد البناء أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى.
فالقرارات التي تتخذ اليوم لها آثار بعيدة المدى ومعقدة، وقد تكون الخطأ البسيط كافياً لإهدار موارد ضخمة أو خلق مشاكل لأجيال قادمة.
لذا، فإن وجود "أنسجة نقدية" سليمة داخل جسد الدولة يعادل وجود جهاز مناعي قوي يقاوم الفيروسات والخلل الداخلي قبل استفحالها.
وهذا يتطلب بالضرورة تطوراً موازياً في أدوات النقد نفسه، من الاعتماد على البيانات الضخمة والتحليل الكمي، إلى إشراك أوسع قطاع ممكن من الخبراء والمستفيدين في عملية التقييم.
باختصار، النقد البناء ليس ترفاً فكرياً أو ممارسة ثانوية؛ إنه العمود الفقري للتعلم المؤسسي المستمر، والوقود الذي يحرك عجلة التحسين والتطوير. وهو الضمانة الحقيقية ضد تراكم الغبار على آليات العمل، وضد تحول البيروقراطية إلى غاية في ذاتها بدلاً من كونها وسيلة لخدمة المواطن.
إن دولة تتبنى هذا النهج بصدق وشفافية، هي دولة تثق بنفسها وبشعبها، وهي الدولة التي تستحق أن تبني مستقبلاً مزدهراً لأبنائها.
إنها رحلة تتطلب شجاعة أدبية نادرة، وحكمة إدارية عالية، وإيماناً راسخاً بأن الحقيقة، حتى لو كانت مريرة في البداية، هي الطريق الوحيد نحو القوة والمتانة في النهاية. وبدون هذه الرحلة، تظل الدولة كائناً هشاً، يقف على أرض مهزوزة، ينتظر أول صدمة تكشف عن خفايا أمراض كانت تنمو في الظلام.
إن بناء ثقافة النقد البناء هو، في حقيقته النهائية، بناء لمناعة الوطن وضمان لاستمراره وازدهاره.
إن الحقيقة الحيوية في هذه التناولة تقودنا إلى البُعد الثاني، وهو الأكثر خطورة والأعمق أثراً في فلسفة النقد البناء؛ دوره كحصن منيع ضد آفة الاستبداد الداخلي والانحراف الخفي عن المسار.
فكل مشروع وطني طموح، وكل حركة إصلاحية جادة، وخاصة تلك التي تنشأ أو تعمل في ظل ظروف استثنائية، كالحروب أو الأزمات الشاملة أو مراحل البناء المضني، تواجه خطراً داهماً وكامناً.
هذا الخطر لا يأتي بالضرورة من الأعداء الخارجيين، بل يأتي أحياناً من الداخل، من ذلك الميل البشري المؤسساتي نحو التمترس خلف السلطة وتحويلها من وسيلة لتحقيق الأهداف إلى غاية تسعى للحفاظ على نفسها.
وفي خضم المعارك المصيرية وحالة الطوارئ التي تبرر تركيز الصلاحيات وتوحيد القيادة، قد تبدأ بعض الدوائر أو الشخصيات داخل الجهاز القيادي أو المؤسسي بالاعتقاد بأنها أصبحت فوق النقد، وفوق المحاسبة، وفوق المراجعة.
وقد تتستر وراء شعارات عظيمة، مثل "قدسية المرحلة" أو "حساسية اللحظة" أو "أولوية المعركة"... لتحصين نفسها ضد أي مساءلة، متحولة ببطء إلى كيانات مغلقة، تضع مصالحها الضيقة أو رؤيتها الأحادية فوق المصلحة العامة.
هذا المسار، إذا لم يُقطع مبكراً، يقود حتماً وبلا استثناء إلى تفشي آفتين قاتلتين: الفساد بكل أشكاله المالية والإدارية والأخلاقية، وإساءة استخدام السلطة وتحويلها من أداة خدمة إلى أداة قمع وتكميم للأفواه.
وهنا، يتحول النقد البنّاء الشجاع والصريح من مجرد أداة تحسين إداري إلى سلاح أخلاقي وجودي. إنه ذلك الصوت الداخلي الذي يوقظ الضمير المؤسسي، وذلك الجدار الذي يقف في وجه انزلاق السلطة نحو الهاوية.
فالنقد في هذا السياق ليس تقويضاً للقيادة، بل هو إنقاذ لها من نفسها، هو ذلك الصديق الذي يمسك بيد صديقه وهو على حافة الهاوية، مهما كان غاضباً من هذه اليد الممسكة.
إنه يُذكّر الجميع، من القاعدة إلى القمة، بأن السلطة ليست ملكاً شخصياً ولا امتيازاً موروثاً، بل هي أمانة ثقيلة يوضع من يحملها تحت مجهر المسؤولية التاريخية.
وهي رسالة واضحة بأن الثورة الحقيقية، أو المشروع الإصلاحي الأصيل لم يكن ضد ظلم خارجي فحسب، بل كان، ويجب أن يبقى، ضد كل أشكال الظلم والانحراف، حتى ولو كانت ترتدي ثوب "الرفاق" أو تتحدث بلسان الثورة ذاتها.
فأخطر أنواع الظلم هو ذلك الذي ينبعث من قلب الصفوف الداخلية؛ لأنه يستغل رصيد الثقة المكتسب ويستخدمه لضرب القيم التي كان الكفاح من أجلها. لقد شهدت تجارب شعوب عديدة كيف تحولت بعض الحركات التحررية إلى أنظمة قمعية بعد وصولها إلى السلطة؛ لأنها قتلت داخل نفسها آلية النقد والمحاسبة، وآمنت بأنها تمتلك الحقيقة المطلقة، وأنّ كل معارضة لها هي خيانة للقضية.
والنقد البنّاء، بجرأته وصراحته، هو الذي يحول دون هذه الكارثة الأخلاقية والسياسية. فهو يعيد ربط السلطة بمصدر شرعيتها الأصيل: خدمة الشعب وتحقيق أهداف المشروع الوطني. وهو يخلق توازناً رقابياً مستمراً يمنع أي فرد أو مؤسسة من الاعتقاد بأنه خارج دائرة المساءلة.
إن قبول القيادة للنقد ليس علامة ضعف، بل هو ذروة القوة والثقة. القوي الواثق هو من يستطيع أن يستمع إلى آراء مخالفة، ويناقشها بموضوعية، ويعترف بالخطأ إذا ثبت. أما الضعيف المتوجس فهو الذي يحاصر نفسه بجدار من المتملقين، ويخاف من أي صوت حُر، وينظر إلى كل نقد على أنه مؤامرة.
لذلك، فإن بناء ثقافة النقد داخل المشروع الوطني هو ضمانة استمراره وسلامة مساره. وهو يحوّل المؤسسات من أجهزة بيروقراطية جامدة إلى كيانات ديناميكية قادرة على التصحيح الذاتي. إنه يزرع في نفوس العاملين أن الولاء الحقيقي ليس بالصمت الطيّع، بل بالإنجاز العالي والمبادرة الإيجابية، وتقديم الرأي السديد الذي قد ينقذ الموقف.
وفي هذا الإطار، يصبح النقد مساهمة في صنع القرار، وليس تعطيلاً له.
إن القرارات التي تخضع لتمحيص نقدي مسبق تكون أكثر نضجاً وأقل عرضة للأخطاء الكارثية. كما أن وجود قنوات نقدية آمنة ومؤسسية يمنع تراكم السخط والغضب الذي قد يتحول إلى انفجار عشوائي مدمر في وقت لاحق. إنه يصب الغضب المشروع في قنوات بناءة، ويحوّله إلى طاقة إصلاحية.
وهنا تظهر أهمية التمييز بين النقد الذي ينطلق من حرص على المشروع، وبين الهجوم الذي يهدف إلى هدمه. والفارق الجوهري هو النية والبناء.
الأول: يقدم البدائل ويبحث عن حلول ويعترف بالإنجازات أيضاً، بينما الثاني يهدف إلى التشويه والتخوين فقط. وواجب المؤسسات هو تشجيع الأول وحماية أصحابه، ومواجهة الثاني بالحجج والشفافية.
في النهاية، إن النقد البنّاء كحصن ضد الاستبداد هو تعبير عن النضج السياسي والحضاري للأمة. فهو يعني أن المجتمع قد تجاوز مرحلة الخوف والتبعية العمياء، وانتقل إلى مرحلة المسؤولية والمشاركة الواعية. وهو إعلان بأن الشعب ليس رعية تستحق التوجيه فقط، بل هو شريك في الرؤية ومسؤول عن الرقابة. وهذا ما يجعل الدولة الحديثة القوية مبنية على عقد اجتماعي متين، حيث الحقوق يقابلها واجبات، ومن أهم هذه الواجبات واجب النصيحة والمتابعة. وبدون هذا الحصن الأخلاقي والمؤسسي، تتحول أعظم الإنجازات المادية إلى قصور من وهم، قابلة للانهيار عند أول اختبار حقيقي، وتصبح السلطة سجينة لنخبة ضيقة، تفقد تدريجياً صلتها بالواقع وباحتياجات الناس، وهذا يفتح الباب للانفجار من الداخل أو للتدخل من الخارج.
لذلك، فإن تعميق ثقافة النقد المسؤول هو خط دفاع أول عن أمن الوطن واستقراره، وهو الضامن لاستمرارية المشروع الوطني على أسس سليمة، بعيداً عن أمراض الغرور والانعزال والفساد، التي أطاحت بحضارات عظيمة عبر التاريخ.
إنها المعادلة الصعبة والضرورية: قيادة قوية وموحدة، يقابلها مجتمع ناقد وحيوي، في إطار من الاحترام المتبادل والهدف المشترك، حيث تزدهر الدولة وتصبح قادرة على مواجهة تحديات الزمن.

.jpg)









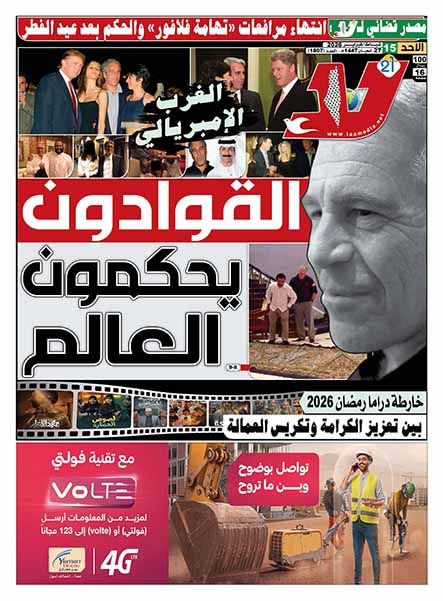
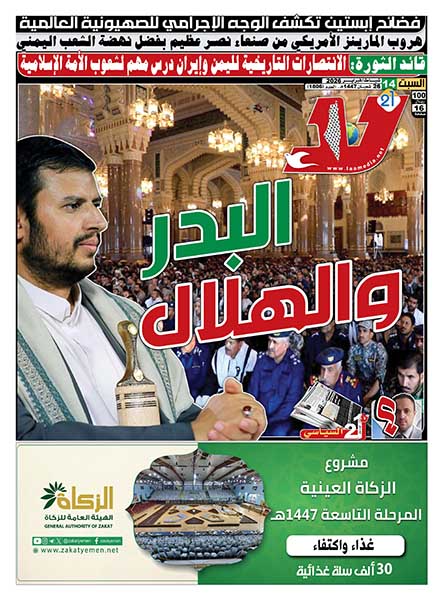




المصدر فهد شاكر أبو راس
زيارة جميع مقالات: فهد شاكر أبو راس