«الزمن الجميل».. هـــل كـــان جميــــلاً حقـــاً؟! الحلقة 9٨
- مروان ناصح الثلاثاء , 17 فـبـرايـر , 2026 الساعة 12:08:13 AM
- 0 تعليقات

مروان ناصح / لا ميديا -
حين كان المسرح يتنفّس -أحيانا- في المدارس
كان زمناً ترسم فيه القصائد بالطباشير الملونة على اللوح الأسود. وكانت الأناشيد تُعلَّم كما تُتلى الأدعية. وكان المسرح نافذةً صغيرة مغلقة في جدار المدرسة تشكو إلى السماء.
لم يكن مشروعاً تُشرف عليه الإدارات، ولا نشاطاً تُحدده الجداول، بل كان أشبه بنبضٍ خفيٍّ يمرّ بين المعلمين، ينتظر واحداً منهم ليؤمن به، ويشعل المصباح الأول في عيوننا.
كنا نعرف أن الرياضة تُعلّم الجسد، والدروس تُعلّم العقل؛ لكن المسرح وحده كان ينتظر دوره ليُعلّمنا كيف نصير بشراً في ضوءٍ مرتجفٍ بين الستائر.
المعلّم الذي أيقظ الضوء
ما كان المسرح ليُولد لولا ذلك المعلّم الحالم، الذي كان يؤمن بأن الدروس ليست كل شيء.
كان يدخل الصف بابتسامةٍ متعبةٍ تشبه نجمةً في آخر النهار، ويقول بصوتٍ مفعمٍ بالحياة: "رح نعمل مسرحية.. والبطولة للّي ما بيعرف يمثل". ضحكنا يومها، لكننا صدّقناه.
هو وحده استطاع أن يرى خلف الخوف بذرة الحلم، وأن يلتقط من بين عشرات التلاميذ من يرتجف صوته؛ لأن في داخله موسيقى لا تزال خجولة. كان أشبه بحدّادٍ يصنع من الارتباك سيفاً للثقة.
البروفة الأولى..
حين يتلعثم الحلم
في قاعةٍ تفيض بالطباشير والغبار، بدأ التدريب. كنا ننسى الجمل، ونتعثّر في الحركات، ونضحك حين نخطئ، كالذين يعتذرون للحياة عن ولادتهم المبكرة في الضوء.
لكن المعلّم لم يكن يضحك. كان يرسل إلينا نظرةً تجعلنا نصدق أن الوقوف على الخشبة أهم من النجاح في الامتحان.
كان يهمس: "ما في شي اسمه فشل. في شي اسمه محاولة جديدة". تلك العبارة صارت أول جملةٍ نحفظها حقاً، لا من النص، بل من الحياة.
الكواليس..
رائحة الخوف والدهشة
جاء يوم العرض كعيدٍ صغيرٍ ينتظر المطر. خلف الستارة الحمراء، كانت رائحة الخشب تختلط بعطر القلق. الأزياء أكبر من أجسادنا، والأضواء تلمع كنجومٍ على وشك الانفجار.
كنا نحفظ أسماءنا من جديد كي لا نضيع في شخصياتنا.
وحين وضع المعلّم يده على كتف بطل المسرحية، قال بهدوءٍ يعرف طريقه إلى القلب: "هلق صرت ممثل! روح واحكي صدقك". تلك الجملة كانت رخصة دخول إلى عالمٍ لا يشبه شيئاً سواه.
اللحظة..
حين لمس الضوء الجبين
يروي البطل: حين ارتفعت الستارة ببطء، كأنها ترفع الغطاء عن حلمٍ كان نائماً.
تسلّل الضوء إلى وجهي، فأحسست أنه يقرؤني.
قلت جملتي الأولى بصوتٍ غريبٍ عني، كأنّ أحداً آخر يسكن جسدي.
لم أتعثر، لم أنسَ، بل شعرت أنني أخيراً أقول ما كنت أريد قوله منذ أن عرفت الكلام.
وحين دوّى التصفيق، شعرت بقلبي صار خشبةً أخرى.
كان ذلك التصفيق أول اعترافٍ من العالم بأنني موجود.
بعد العرض.. ولادة في الظل
في اليوم التالي، لم تعد المدرسة كما كانت. كل شيءٍ بدا أكثر دفئاً: الجدران، الزملاء... حتى الممرات.
يقول بطل المسرحية: ناداني أحدهم باسم الشخصية التي لعبتها، فضحكت حتى اهتزت أعماقي بالنشوة.
أما المعلّم فقال وهو يغلق دفتره: "شايف؟! مو المهم الدور. المهم إنك صدّقت حالك".
ومنذ تلك اللحظة، لم أعد أبحث عن الأدوار، بل عن نفسي في كل مشهدٍ حياتيّ جديد.
المسرح الذي لم تحببه الإدارات
كبرنا، وتغيّر الزمن، وبقي المسرح هناك، ينتظر أحداً يشعل مصباحه من جديد.
الإدارات كانت مشغولة بالعلامات. لم تفهم أن الضوء الذي يُزرع في عين طفلٍ واحدٍ أغلى من ألف خطة تطوير.
تحوّلت الخشبات إلى مستودعاتٍ للكتب القديمة، وأُغلقت الستائر على الغبار بدل الأحلام.
لكن في كل مدرسةٍ، لا بد أن ينهض بطل من جديد، يبحث في الظل عن أثرٍ من ذلك الضوء.
آخر ممثل
يقول بطل المسرحية: اليوم، حين أمرّ قرب المدارس، أُصغي جيداً؛ ربما أسمع صوتاً صغيراً يتدرّب خلف نافذةٍ مغلقة، ربما هناك طفلٌ آخر سينطق بجملته الأولى الآن، ويرتجف كما ارتجفتُ ذات زمنٍ جميل.
ذلك الارتجاف – أعرفه، هو الذي يصنع الفن. لأن المسرح، في جوهره، ليس وقوفاً على خشبة، بل محاولةٌ أن تبقى واقفاً أمام الحياة.
خاتمة:
لم يكن الزمن الجميل جميلاً لأنه بلا أخطاء؛ بل لأنه كان صادقاً في محاولاته الصغيرة لصنع الجمال.
كان المسرح المدرسي تجربةً خجولة؛ لكنها عميقة، مثل زهرةٍ نبتت في شقّ جدارٍ من الإسمنت.
ومن تلك الزهرة، تعلّمنا أن الضوء لا يحتاج إلى إذنٍ من أحدٍ كي يولد. يحتاج فقط إلى مؤمنٍ واحدٍ يشعل المصباح.

.jpg)









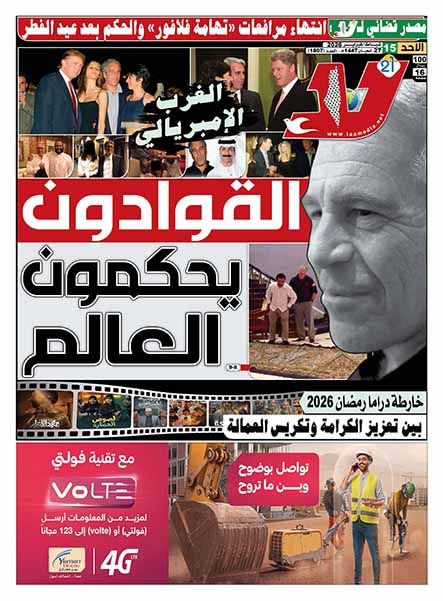
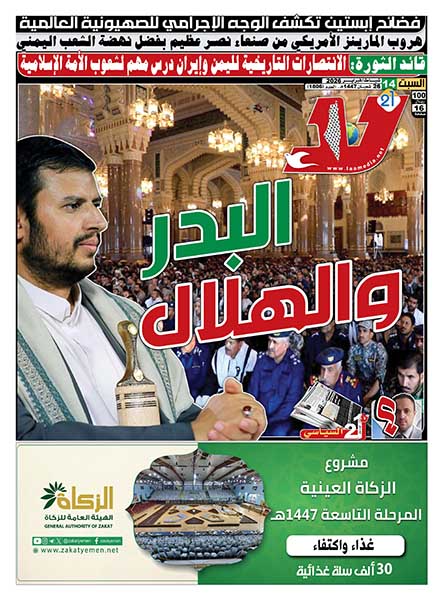




المصدر مروان ناصح
زيارة جميع مقالات: مروان ناصح