كيف يسهم اليمن في تحولات النظام العالمي نحو التعددية القطبية؟
- أنس القاضي الأثنين , 28 أبـريـل , 2025 الساعة 1:08:37 AM
- 0 تعليقات

أنس القـاضي / لا ميديا -
ملخص:
يشهد النظام الدولي اليوم تحولات عميقة تتجه نحو تفكيك الأحادية القطبية التي فرضتها الولايات المتحدة منذ نهاية الحرب الباردة. وفي هذا السياق يتخذ اليمن موقعاً فريداً ومؤثراً في هذا التحول، خصوصاً من خلال الدور الذي يلعبه في زعزعة المنظومة الإمبريالية الغربية من موقع الأطراف لا المركز. انطلاقاً من موقعه الجغرافي الحساس المشرف على باب المندب، فمن خلال أدوات المقاومة والحرب غير المتكافئة، يتحول اليمن إلى فاعل غير تقليدي مؤثر في معادلة التعددية القطبية، وهي معادلة عالمية، ولم يسبق لحركة تحرر وطنية لعب دور كهذا.
بدأ أنصار الله، بوصفهم فاعلاً محلياً، في ثورة 21 أيلول/ سبتمبر 2014. ومن بعد العدوان 2015 و"طوفان الأقصى" 2023، أصبح اليمن اليوم يتصرف كندّ سياسي وأمني في الإقليم، ويستخدم أدوات الضغط البحري والعسكري لتعديل التوازنات في المنطقة، ويطرح نفسه كطرف قادر على مجابهة القوى الإمبريالية والصهيونية.
وفيما تنشغل أمريكا بمحاولة إعادة فرض هيمنتها في البحر الأحمر وتلافي التعرض لهزيمة استراتيجية في هذه الجبهة تزعزع مكانتها، ترصد الصين وروسيا باهتمام تحركات صنعاء؛ إذ أضحى اليمن مختبراً استراتيجياً لدراسة إمكانية التمرد على الإمبريالية وفك الارتباط عنها في إطار التحول نحو التعدد القطبي.
ويكمن التحدي الأكبر في عدم تحول اليمن إلى ساحة استنزاف تخدم مصالح القوى الدولية دون أن تبني مشروعاً وطنياً داخلياً متماسكاً. المقاومة وحدها لا تكفي ما لم تقترن بإصلاح سياسي داخلي، وعدالة اجتماعية، وسيادة قانون، وإعادة بناء الدولة من منظور تحرري مستقل.
مقدمة:
تُعيد التحولات المتسارعة في النظام العالمي، خصوصاً في هذا العقد، إنتاج مفهوم القوة والتأثير خارج الإطار التقليدي القائم على مركزية الدول الصناعية الكبرى. وضمن هذا السياق، تكتسب دولة كاليمن أهمية من حيث إسهامها في الدفع نحو التعددية القطبية.
تستند هذه الورقة إلى مقاربتين نظريتين: الأولى من مدرسة التبعية التي أسسها سمير أمين، والتي تُركز على العلاقة البنيوية بين المركز الرأسمالي والأطراف التابعة، والثانية من المدرسة الجيوبوليتيكية التي تُعيد الاعتبار للموقع الجغرافي والإمكانات المادية والمعنوية كأدوات للنفوذ في السياسة الدولية.
من منظور سمير أمين، لا تتحرر الأطراف إلا حينما تُعيد إنتاج بنيتها الاقتصادية وسياستها خارج منطق السوق الإمبريالية وخارج الفلسفة الليبرالية المعولمة. ويمكن القول إن صنعاء -وإن لم تصل بعد إلى هذه المرحلة- تُعد مثالاً على فك الارتباط والتبعية السياسية والأمنية عن المركز، عبر أدوات غير تقليدية مثل المقاومة، السيطرة على المضائق، والتحالفات المتعددة خارج نطاق الهيمنة الغربية. والمسألة ذاتها تقوم بها دول ساحل شرق أفريقيا التي تتمرد على الهيمنة الإمبريالية الفرنسية والأمريكية.
أما من منظور الجيوبوليتيك، فإن اليمن -بحكم إشرافه على مضيق باب المندب، وتحكمه بأحد أهم الممرات البحرية العالمية- أصبح نقطة ارتكاز استراتيجية، رغم محدودية قدراته. وبهذا، تُجسد صنعاء حالة فاعل جيوسياسي صغير الحجم، كبير التأثير.
تجربة اليمن في معركة التعدد القطبي
سلطة صنعاء الوطنية والتحررية لم تعد فاعلاً محلياً محصوراً في دائرة الصراع اليمني الداخلي أو الإقليمي مع السعودية كما كان عليه الحال في بداية العدوان 2015، بل غدت جزءاً من المعادلة الدولية الأوسع، تؤدي دوراً غير مباشر في التحول الجاري للنظام العالمي نحو التعددية القطبية. تمارس هذا الدور انطلاقاً من موقعها في الهامش الجيوسياسي، ومن خلال أدوات اللا مركز، لا من خلال أدوات المركز كما تفعل الصين.
فمن المعروف تاريخياً أن أول مظاهر تفكك الهيمنة الغربية تظهر على الأطراف لا في القلب. وقد شهدنا ذلك مع الثورة الاشتراكية الروسية عام 1917، حين اندلعت في روسيا القيصرية، التي كانت آنذاك على هامش العالم الصناعي الأوروبي، بينما كانت الدول الرأسمالية "الناضجة"، كألمانيا وبريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة، عصية على اختراق ثوري مماثل بسبب تماسك منظومتها الإنتاجية والطبقية. من هنا فإن فرص التحرر من الهيمنة تكون غالباً أوفر في دول الهامش منها في مراكز القوة.
فعلى سبيل المثال، نرى أن فنزويلا -برغم فقرها النسبي- حافظت على استقلالية سياسية تجاه الولايات المتحدة أكثر مما فعلت البرازيل، الدولة الأكبر اقتصادياً في أمريكا اللاتينية، وأحد مؤسسي "مجموعة البريكس". وهذا يؤكد أن الموقع في الهامش يمنح حرية من نوع خاص، تُتيح خوض مغامرات سيادية لا تُتاح لمراكز مرتبطة بالنظام العالمي على نحو بنيوي.
أما الصين، زعيمة "البريكس"، فهي لا تسعى لفك الارتباط بالنظام العالمي، بل تتغلغل فيه وتعيد تشكيله من داخله. إنها تُنتج للعالم، وتُصدر الصناعات تحت علامات تجارية أوروبية وأمريكية بحسب طلبهم، وتصنع "للآخر" بوسائله وتوطن تقنياته كأي دولة رأسمالية كبرى؛ لكنها تفعل ذلك بهدف خلق نظام موازٍ من التحالفات والأنساق، دون أن تدخل في مواجهة عسكرية مباشرة مع الغرب.
في المقابل، تتخذ روسيا موقعاً مغايراً، إذ تخوض صراعاً مباشراً مع حلف الناتو في أوكرانيا، وتقوم فعلياً بدور الجناح العسكري لمشروع التعددية القطبية، داعمةً الصين في شقها الاقتصادي والسياسي، ومُساهمة في تفكيك أدوات الهيمنة الغربية عسكرياً.
اليمن، بطبيعة الحال، لا يمتلك الأدوات ليؤدي دور الصين أو روسيا، لكنه يُسهم من موقعه الخاص في معركة الدفاع عن التعددية القطبية، عبر ممارسة نموذج للتحرر من المركز، وفك الارتباط مع النظام العالمي من موقع الهامش. فمن بلد كان تابعاً للولايات المتحدة، ومجرد ساحة لتثبيت الهيمنة، أصبح اليمن -وتحديداً سلطة صنعاء- يشكل عامل ضغط وتهديد على منظومة الهيمنة ذاتها، لاسيما من خلال التحكم بالممرات البحرية الاستراتيجية.
ما يزيد من أهمية النموذج اليمني هو أنه تجربة حية وراهنة للتمرّد على النظام العالمي، لا تجربة سابقة تعيش على إرث استقلالي تاريخي، كما هو الحال في إيران أو كوريا الشمالية أو كوبا، التي نالت استقلالها قبل ظهور نظام الأحادية القطبية، وتتمثل قدرتها في الصمود لا في المبادرة الجديدة. أما اليمن فهو يخوض معركة الاستقلال الآن في قلب التحول العالمي، ولهذا فإن دوره يُعد أكثر جوهرية من حيث دلالته الرمزية والسياسية.
هذه التجربة اليمنية، بكل خصوصيتها، تُثير فضولاً بحثياً واستراتيجياً في العواصم الكبرى، خاصة في موسكو وبكين وهافانا وكراكاس وطهران... واليمن يُعد اليوم بمثابة "مختبر استراتيجي واقعي" لاختبار إمكانية فك الارتباط مع المركز الغربي، وبناء استقلال حقيقي من داخل عالم ما بعد الهيمنة الأمريكية.
وتدرك واشنطن خطورة هذا النموذج، لذلك تتصلب في موقفها العدواني، وتحاول استعادة زمام المبادرة في البحر الأحمر واليمن، خشية أن يتحول هذا التمرّد الناشئ إلى نموذج ملهم قابل للتكرار في أطراف أخرى من النظام الدولي.
صنعاء كمشروع تحرري وسلطة سياسية واقعية
رغم أن سلطة صنعاء في هذه المعركة -المؤثرة على النظام العالمي- تُقدّم نفسها كحركة تحرر وطني تسعى لفك الارتباط عن نظام الأحادية القطبية وتقاوم الهيمنة الإمبريالية؛ إلا أنها -مثل كل حركات التحرر- تحوّلت إلى سلطة حاكمة (المجلس السياسي وحكومة التغيير) تواجه معضلة هل يمكن أن تبقى ثورية وهي تُمارس الحكم؟
وهنا لا بد من التمييز بين "الرمزية الخارجية لصنعاء"، و"فاعليتها الداخلية". فالصراع الجدلي بين هذين البعدين يُحدد مستقبل دور اليمن في النظام العالمي. بمعنى آخر: لا يمكن تحرير البحر الأحمر وتبقى صنعاء غارقة في الفقر والفساد والضعف المؤسسي الداخلي. فإذا لم تنجح سلطة صنعاء في تحويل مشروعها التحرري إلى نموذج حكم تنموي عادل داخلياً، فإن وظيفتها الدولية كمُلهمة للجنوب العالمي ستضعف تدريجياً؛ فالتحرر الخارجي يجب أن يكون امتداداً لتحرر داخلي، للثورة الشعبية.
حتى لا يستنزف اليمن في حرب التعدد القطبي
رغم أن اليمن يُشكّل اليوم ما يشبه "المختبر الاستراتيجي" لتحدي النظام الأحادي القطبية، فإن ثمة خطراً جدياً يتمثل في احتمال تحوّله إلى أداة في صراع دولي أوسع من قدرته، دون أن يجني ثمار هذا الدور. وقد شهد التاريخ نماذج مشابهة، كما في أفغانستان ونيكاراغوا وفيتنام، حيث تحولت تلك الدول إلى ساحات استنزاف في صراعات كبرى، سواء بين الاتحاد السوفييتي والولايات المتحدة أو بين أجنحة النظام العالمي ذاته؛ لكن النتيجة كانت في الغالب مأساوية؛ فإما انهيار شامل كما في حالة أفغانستان، وإما إعادة دمج مشروط في النظام الرأسمالي العالمي، كما حدث لفيتنام التي حققت الاستقلال العسكري، لكنها بقيت اقتصادياً وسياسياً على هامش السوق الإمبريالية العالمية.
الخطر ذاته يتهدد صنعاء اليوم؛ إذ قد تنزلق إلى موقع "المستنقع الذي يستنزف أمريكا" دون أن تمتلك في المقابل أدوات إعادة بناء الدولة اليمنية، أو أن تتحول إلى فاعل دولي مستقل يُعبّر عن مصالحه الذاتية خارج منطق التبعية أو التموضع ضمن محور معين.
بكلمات أخرى: إن إسهام اليمن في تفكيك الأحادية القطبية لا ينبغي أن يكون مجانياً أو استنزافياً، بل يجب أن يكون مقروناً ببناء نموذج سياسي وطني صلب، يراكم مكتسبات داخلية قابلة للاستمرار، ويؤسس لدور مستقل وفاعل في النظام العالمي الانتقالي الراهن والقادم لاحقاً.
كييف يؤثر اليمن في التحولات العالمية؟ الموقع الجيوسياسي والنفوذ البحري
تكشف التقارير الدولية والاهتمامات البحثية تعاظم الأثر الجيوسياسي لصنعاء، انطلاقاً من موقع اليمن الاستراتيجي الذي يتحكم بمضيق باب المندب، إحدى أهم نقاط التجارة العالمية، ما يجعل أي اضطراب فيه بمثابة خطر مباشر على الاقتصاد العالمي.
أظهرت العمليات البحرية اليمنية منذ العام 2023 تحولاً في قواعد الاشتباك، حيث بدأت باستهداف السفن المرتبطة بـ"إسرائيل"، ثم توسعت لتشمل السفن الأمريكية والبريطانية، وأخرى مرتبطة بهما، وقد أثّر هذا بشكل مباشر في حركة الملاحة الدولية.
كما أبرزت التحليلات الاقتصادية أن طبيعة الحمولات التي تأثرت تشمل سلعاً وسيطة ومدخلات إنتاج، وليس فقط سلعاً نهائية، ما يهدد بإرباك سلاسل الإمداد العالمية على المدى المتوسط والطويل، أي أن القدرات الصناعية لأوروبا مثلاً رهينة مرور مدخلات الانتاج من باب المندب.
على الصعيد العسكري، ورغم أن هذه العمليات تتم بوسائل غير متماثلة (طائرات مسيّرة وصواريخ بحرية، وهناك قفزات في التقنيات العسكرية تجعل اليمن متصدراً عالمياً، كتقنية الصواريخ الفرط صوتية)، إلا أن أثر هذه العمليات العسكرية النفسي والاقتصادي والسياسي كان أكبر من الإنجاز العسكري التدميري، وأجبر الولايات المتحدة وبريطانيا على الدخول مباشرة في العدوان على اليمن، في حين أعلنت أوروبا مبادرة "أسبيدس" العسكرية لحماية الملاحة.
صنعاء ضمن محور المقاومة العالمي
تتجاوز علاقة صنعاء بمحور المقاومة البُعد الخطابي أو التكتيكي، لتتحول إلى فاعل استراتيجي مستقل ومؤثر قائم على تناغم سياسي وأيديولوجي وعسكري يجعل من اليمن أحد الفاعلين الفعليين، ويُسهم في تعزيز مشروع كسر الهيمنة الأمريكية وتفكيك النظام العالمي الأحادي القطبية، من موقعه جنوب الجزيرة العربية.
يتجاوز التنسيق بين صنعاء ومحور المقاومة التصريحات الإعلامية، ليصل إلى مستوى من العمل العملياتي المشترك، خاصة في ما يتعلق بتقنيات الصواريخ والطائرات المسيّرة، وآليات جمع المعلومات، وإدارة الردود العسكرية، ووجود غرفة عمليات موحدة لمحور المقاومة يؤكد ذلك.
على المستوى الدولي، لم تقم روسيا والصين بإدانة العمليات اليمنية، بل اكتفتا بالتعبير عن القلق تجاه عسكرة البحر الأحمر من قبل الولايات المتحدة. هذا الصمت المدروس يُفهم ضمن إطار الحفاظ على ورقة إقليمية تُربك خصومهم وتضعف النفوذ الأمريكي، دون أن تكبدهما كلفة مباشرة. كما أن سماح صنعاء بمرور سفن صينية وروسية بسلام يُشير إلى وجود تفاهمات غير مباشرة مع هاتين القوتين.
في هذا السياق فإن صنعاء تعمل على اكتساب الشرعية الدولية وفرض شروط جديدة في المشهد الإقليمي.
ولا يمكن فهم الدور الذي تلعبه صنعاء اليوم إلا بوصفه فاعلاً في معادلة إقليمية جديدة، معادلة لا تُبنى فقط على القوة الصلبة، بل على قدرة الفواعل غير التقليدية على ممارسة الضغط السياسي وتعديل موازين القوى. فقد أصبح واضحاً أن سلطة صنعاء ليست مجرد حكومة محلية لجزء من اليمن، بل تمارس نوعاً من السيادة الفعلية متحدثة باسم اليمن، وتُخاطب الخصوم الإقليميين كندٍّ سياسي وعسكري.
ومن زاوية أخرى، يُمكن القول إن صنعاء تسعى لتكريس حضورها في معادلة البحر الأحمر كمُعادِل للنفوذ "الإسرائيلي" - الإماراتي - الأمريكي، ومحاولة تطويع هذا الموقع للضغط في ملفات أوسع، تشمل المفاوضات حول مستقبل اليمن ووحدته وعلاقاته المستقبلية بالقوى الكبرى.
بين الهجوم الرمزي والوظيفة الجيوسياسية
لا تقتصر العمليات العسكرية التي تنفذها سلطة صنعاء في البحر الأحمر على كونها مجرد ردود فعل آنية أو تصعيدات تضامنية مع القضية الفلسطينية، بل تحمل في طياتها أبعاداً استراتيجية عميقة، تتجاوز الرمزية إلى الوظيفة الجيوسياسية، بقصد تثبيت حضور سياسي أمني في مضيق باب المندب، وهوما كان اليمن محروماً منه في السابق.
الرسائل المتبادلة بين صنعاء والعواصم الكبرى
تُمارس سلطة صنعاء في الفترة الراهنة سياسة خارجية قائمة على توجيه رسائل مركّبة ومضبوطة بعناية إلى العواصم الدولية الكبرى، وفي مقدمتها واشنطن وبكين وموسكو. هذه الرسائل، وإن كانت غير معلنة دائماً، تُبنى على مزيج من الخطاب السياسي، والإشارات الميدانية، والعمليات العسكرية والبيانات، ما يجعلها قابلة للتأويل على أكثر من مستوى.
بالنسبة للولايات المتحدة فإن الرسالة الأساسية من صنعاء هي أن اليمن لم يعد ساحة نفوذ مغلقة كما كان الحال قبل 21 أيلول/ سبتمبر 2014، وأن الفاعل المسيطر على العاصمة والمضيق قادر على تعطيل المصالح الغربية الحيوية في المنطقة. الرد الأمريكي على هذه الرسالة لم يكن موحداً؛ إذ تذبذبت مواقف واشنطن بين محاولات ردع عسكرية مباشرة، ودعوات للحوار والتهدئة عبر وسطاء إقليميين، ما يدل على حيرة استراتيجية في التعامل مع فاعل غير دولتي يمتلك نفوذاً استراتيجياً يتجاوز وزنه.
أما بالنسبة لروسيا والصين فثمة رسائل ضمنية من صنعاء تذهب في اتجاه تأكيد الاستعداد للعب دور الشريك في حماية توازنات البحر الأحمر والمحيط الهندي في ظل السيادة الوطنية.
الصين، التي تعتمد بشكل رئيسي على استقرار الممرات البحرية لتأمين مشروع "الحزام والطريق"، تُدرك أن تأمين البحر الأحمر لا يكون فقط عبر الأساطيل، بل بالتفاهم مع القوى الفاعلة في الميدان، وصنعاء الأقدر على ذلك.
ومن جانبها، تعتبر موسكو أن صنعاء تمثل حليفاً محتملاً في تقويض النفوذ الأمريكي في المنطقة، خصوصاً في ظل اشتداد التنافس على الممرات والموانئ من البحر الأسود إلى البحر العربي.
هذا التفاهم غير الرسمي بين صنعاء وكلٍّ من بكين وموسكو لا يرقى إلى مستوى التحالف؛ لكنه يشير إلى وجود توازن مصالح قائم على عدم التعارض، واستعداد مشروط للتعاون؛ وهو ما يمنح صنعاء هامش مناورة أوسع في سياستها الخارجية، وقدرة أكبر على مقاومة الضغوط الغربية.
الأهم من ذلك أن صنعاء تحاول أن تُعيد صياغة صورتها في الخطاب الدولي، من "جماعة متمردة" إلى سلطة أمر واقع، ومن "تهديد أمني" إلى فاعل عقلاني يمتلك مقاربات سياسية وقدرات تفاوضية. هذه الرسائل يتم تمريرها عبر التصريحات الإعلامية، والمبادرات السياسية الموجهة. غير أن هذه السياسة تبقى ركيكة؛ فعدم حسم الهوية الدبلوماسية -بين فاعل مقاوم وفاعل حاكم- قد يُربك بقية الدول، وأزمة انقسام اليمن ووجود حكومتين مُربك أكثر.
الخاتمة:
تكشف تجربة اليمن المعاصرة -بقيادة أنصار الله- إمكانية نادرة لقيام فاعل دولي صغير بممارسة تأثير استراتيجي يفوق حجمه، بل ويسهم في تعديل موازين القوى الدولية. إنها حالة مقاومة لا تستند إلى قوة مادية ضخمة، بل إلى إرادة سياسية وقدرة على توظيف الموقع واللحظة الجيوسياسية.
لكن هذه الفرصة، بكل رمزيتها، تظل محفوفة بالمخاطر؛ إذ إن تحوّل اليمن إلى طرف في معركة التعددية القطبية لا يجب أن يكون مجانياً أو استنزافياً. إن الرهان على استنزاف الغرب -دون بناء مشروع وطني داخلي- قد يجر اليمن إلى تكرار مآسي دول الهامش التي خاضت معارك الآخرين دون أن تملك مصيرها.
لذا فإن دور اليمن في العالم الجديد لا يُبنى فقط من خلال إطلاق الصواريخ أو كسر خطوط الملاحة، بل أيضاً من خلال بناء نموذج سيادي عادل في الداخل، يُعطي للرمزية التحررية معنى سياسياً متيناً، ويحوّل تجربة الهامش إلى مشروع مكتمل للحكم والمستقبل.

.jpg)






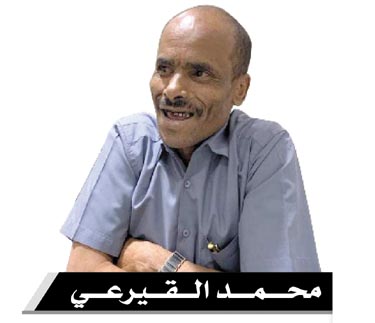
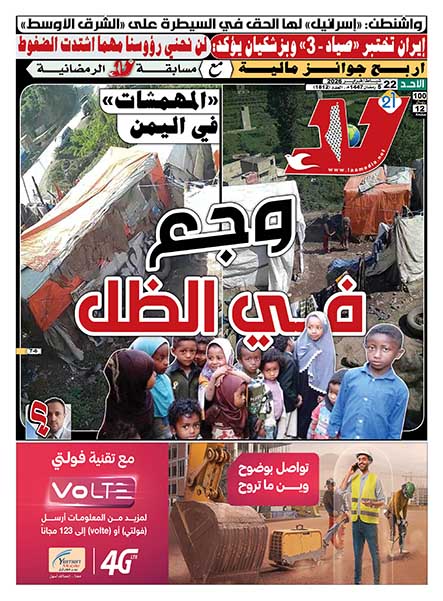
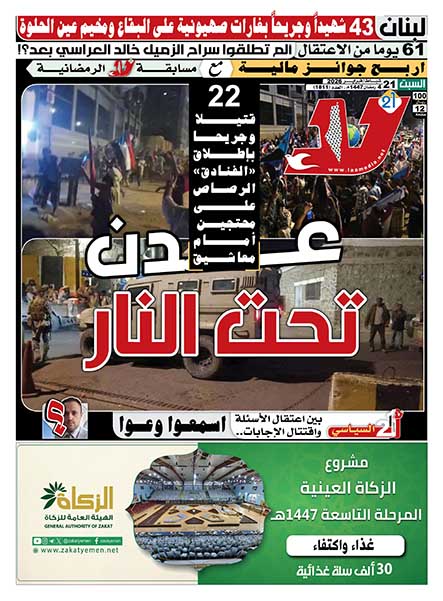

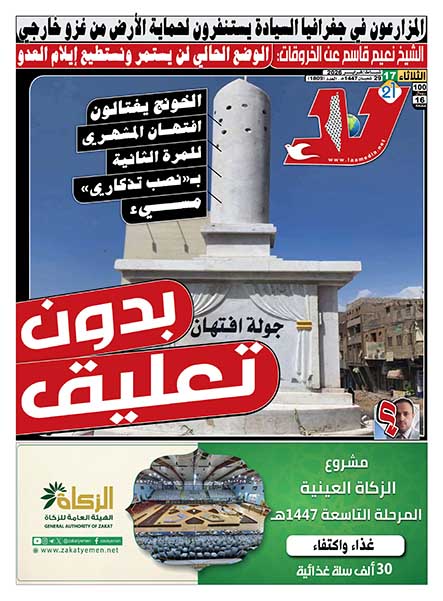
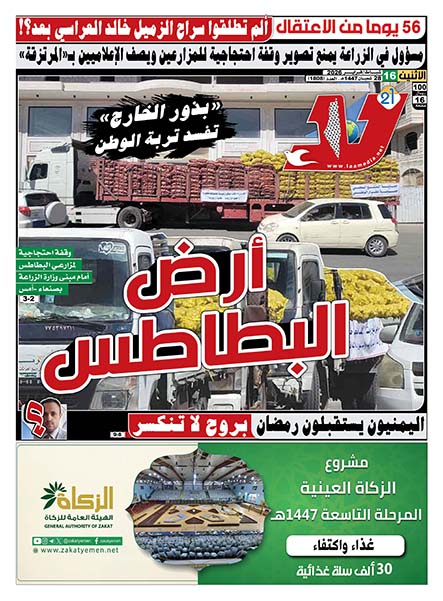
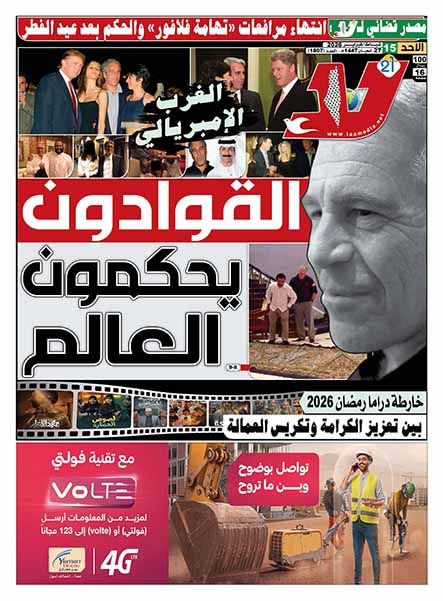

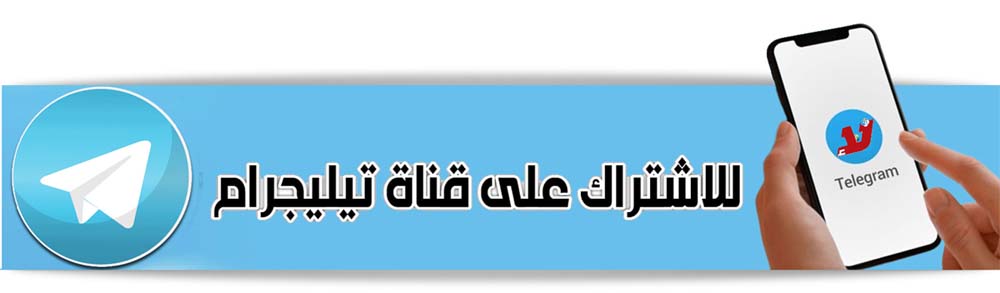
المصدر أنس القاضي
زيارة جميع مقالات: أنس القاضي