الاشتراكية كتجربةٍ حية
- أنس القاضي الأحد , 22 فـبـرايـر , 2026 الساعة 10:20:41 PM
- 0 تعليقات

أنس القاضي / لا ميديا -
لا تختزل الاشتراكية في نموذجٍ مؤسسي محدد، ولا يمكن ردها إلى صيغةٍ تنظيمية جاهزة أو بنيةٍ اقتصادية مغلقة تُنقل من سياقٍ إلى آخر، كما لا يصح حصرها في تجارب تاريخية بعينها بما لها وما عليها، فالتجارب التي عُرفت باسم الاشتراكية، على تنوعها واختلاف ظروفها ونتائجها، لم تكن سوى محاولات تاريخية لتجسيد فكرةٍ أوسع وأعمق من أن تُختزل في شكلٍ واحد أو في لحظةٍ سياسية بعينها. إن الاشتراكية، في جوهرها، ليست نظاماً جاهزاً بقدر ما هي اتجاهٌ تاريخي متحرك نحو تعميق العدالة داخل المجتمع، ومسارٌ طويل يتشكل عبر التراكم البطيء للتحولات في الاقتصاد والعلاقات الاجتماعية والثقافة وأنماط الوعي.
بهذا المعنى، لا تُفهم الاشتراكية بوصفها لحظةً تُعلَن، ولا نظاماً يُقام دفعةً واحدة، بل كعملية ممتدة تتقدم ببطءٍ في بعض المراحل، وتتسارع في مراحل أخرى، تبعاً لمستوى تطور المجتمع، وبنية اقتصاده، وتوازن القوى داخله، ومدى نضج وعيه الاجتماعي. فهي تنمو داخل الحياة اليومية للمجتمع قبل أن تظهر في شكل مؤسسات أو سياسات، وتتشكل من خلال ما يتراكم من إصلاحات وتجارب وصراعات وتوافقات، إنها ليست قطيعةً مطلقة مع الواقع، بل تحولٌ تدريجي ينشأ من داخل هذا الواقع نفسه، ويعيد تشكيله ببطءٍ عبر الزمن، من خلال إعادة ترتيب العلاقات بين العمل والثروة، وبين المجتمع والدولة، وبين الفرد والجماعة.
ومن هنا، لا تُفهم الاشتراكية كحالة نهائية مغلقة أو كمرحلة تاريخية محددة تنتهي عندها الحركة الاجتماعية، بل كأفقٍ مفتوح يتجدد بتجدد الشروط، ويتخذ في كل مرحلة صيغاً مختلفة تبعاً لاحتياجات المجتمع وقدرته على التغيير. فكل توسع في التعليم العام، وكل تحسن في خدمات الصحة، وكل ترسيخٍ لنظم الضمان الاجتماعي، وكل تعزيزٍ للملكية العامة في القطاعات التي تتصل بحياة المجتمع ومصالحه الأساسية، وكل تمكينٍ فعلي للمنتجين من التأثير في شروط عملهم وحياتهم الاقتصادية، يُعد خطوةً في اتجاه الاشتراكية.
إن الاشتراكية ليست انتقالاً فجائياً من نظامٍ إلى آخر، بل عملية طويلة من إعادة توزيع القوة داخل المجتمع، وإعادة صياغة العلاقة بين الثروة والعمل، وبين الدولة والمجتمع، وبين الفرد والمجموع. وهي تنمو كلما اتسعت دائرة الحقوق، وتحسنت شروط العيش، وتراجعت أشكال الاستغلال الفجة، وتزايد حضور المجتمع في مراقبة الثروة العامة وتوجيهها نحو المصلحة المشتركة.
ولا يكمن جوهر الاشتراكية في شكلٍ تنظيمي محدد أو في آليةٍ سياسية بعينها، بل في السعي المستمر نحو تقليص التفاوت الاجتماعي، والحد من تركز الثروة والسلطة في أيدي قلة، وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية، وتعزيز قدرة المجتمع، وخاصة فئاته المنتجة، على المشاركة في توجيه الاقتصاد والتحكم في مساراته العامة؛ فهي تعبيرٌ تاريخي عن نزوعٍ إنساني عميق نحو العدالة والمساواة والكرامة، نزوعٍ لا يولد من الكتب وحدها، بل من التجربة الملموسة للناس مع الظلم والتفاوت، ومن تطلعهم الدائم إلى حياةٍ أكثر استقراراً وأمناً وإنصافاً.
وبهذا المعنى، ترتبط الاشتراكية بفكرة العدالة ارتباطاً جوهرياً لا يُحصر في البعد، فالعدالة هنا لا تعني مجرد إعادة توزيع الدخل أو توفير حد أدنى من الخدمات فحسب، بل تعني إعادة التوازن داخل المجتمع، بحيث لا تتحول الثروة إلى مصدر هيمنة، ولا يتحول العمل إلى عبءٍ بلا حماية، ولا تتحول الفرص إلى امتيازات محصورة في دوائر ضيقة، إنها عدالة تسعى إلى أن يكون لكل فرد نصيب عادل من التعليم والصحة والكرامة والأمان، وأن تكون المشاركة في صنع الحياة العامة مفتوحة أمام الجميع، لا حكراً على قلة تمتلك النفوذ أو المال أو السلطة.
ومن هنا لا يمكن النظر إلى الاشتراكية باعتبارها قراراً سياسياً يُفرض من أعلى، ولا باعتبارها لحظة قطيعةٍ كاملة مع البنية القائمة، بل باعتبارها حركةً متدرجة تنمو داخل المجتمع نفسه، وتتشكل من خلال نضالاته اليومية، وإصلاحاته المتراكمة، وتحولاته الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إنها تتقدم حين تتوسع المشاركة الاجتماعية، وتتعمق حين تتسع دائرة الحقوق، وتترسخ حين تصبح العدالة جزءاً من مفردات الحياة العامة.
إنها تجربة حية، تتعرض للتجربة والخطأ، وتخضع للنقد وإعادة الصياغة مع كل مرحلة جديدة من مراحل التطور، فما يُعد تقدماً في مرحلة قد يحتاج إلى مراجعة في مرحلة أخرى، وما يتحقق من مكتسبات قد يتعرض للتراجع إذا لم يجد من يحميه ويطوره، ولهذا تظل الاشتراكية مساراً مفتوحاً لا يكتمل مرةً واحدة، بل يتجدد باستمرار مع تغير الظروف، ومع تطور وعي المجتمع بذاته وبحقوقه.
وبهذا الفهم، تغدو الاشتراكية اسماً لمسارٍ تاريخي نحو تعميق العدالة، لا عنواناً لنظامٍ مكتملٍ ونهائي لدينا تصور مسبق عنه، إنها اتجاهٌ مفتوح يتغير بتغير الزمن، ويعيد تعريف نفسه تبعاً لتحولات الاقتصاد والمجتمع، ويستمد معناه الحقيقي من قدرته على تحسين حياة الناس، وتوسيع نطاق الكرامة الإنسانية، وإعادة التوازن بين العمل والثروة، وبين الفرد والمجتمع، وبين الحرية والمسؤولية داخل الحياة المشتركة.

.jpg)







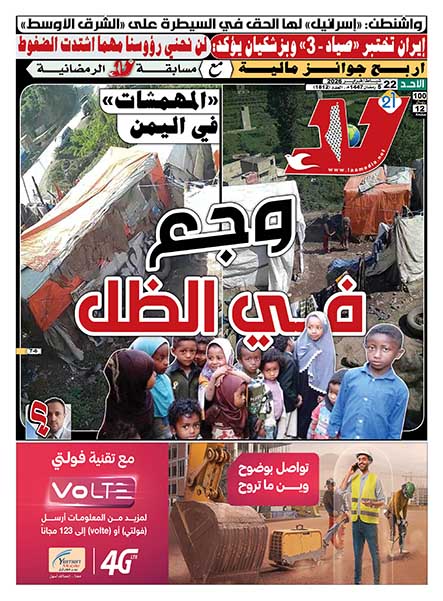
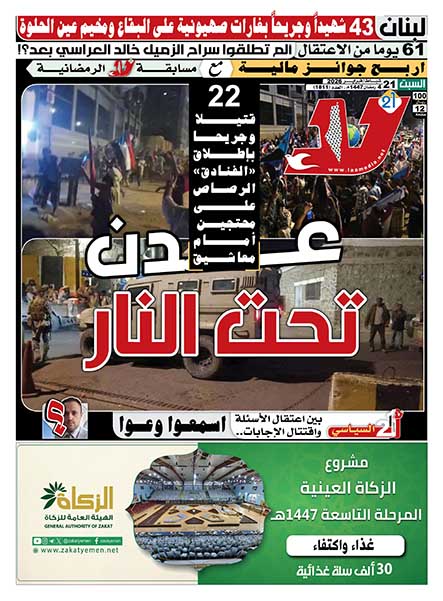



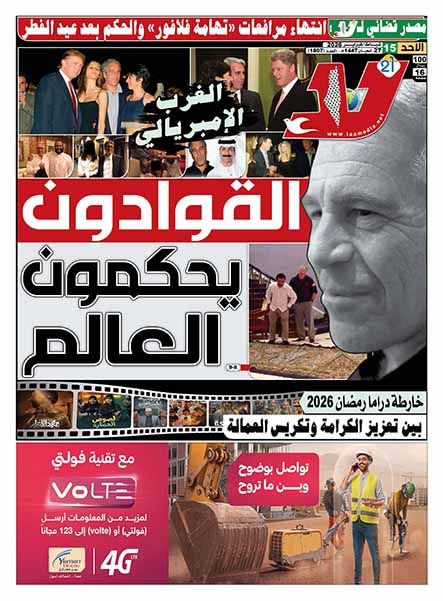


المصدر أنس القاضي
زيارة جميع مقالات: أنس القاضي