أهداف ومآلات مقتل زعيم «الدواعش» في سورية
- محمد القيرعي الأثنين , 7 فـبـرايـر , 2022 الساعة 6:24:27 PM
- 0 تعليقات

محمد القيرعي / لا ميديا -
حدث رئيسي ومهم شهدته الساحة السورية صبيحة الخميس الفائت 3 يناير، تمثل في ما أسمته إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بـ«العملية العسكرية النوعية» التي نفذتها قواتهم في شمال غرب سورية والتي أسفرت عن مقتل زعيم ما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام «داعش» أبو إبراهيم الهاشمي القرشي وعدد من الضحايا الثانويين قدر بـ13 ضحية مدنية جلهم من النساء والأطفال، كما جرت عليه عادة أغلب العمليات النوعية الأمريكية المنفذة في هذا الشأن بغض النظر طبعاً عن فحوى الروايات الأمريكية المتضاربة حول قيام القرشي، وأحياناً، زوجته بتفخيخ نفسيهما وإزهاق أرواح النسوة والأطفال الذين قضوا جراء الغارة للتغطية على النزعة الإجرامية المعهودة للأمريكان حيال الإنسانية، كون ما حدث يمكن تفسيره وفق الروايات الأمريكية المتداولة على أنه يشكل انتحاراً وقتلاً جماعياً طوعياً لأفراد الأسرة من قبل القرشي أو زوجته، وهو ما يتناقض أصلاً مع معتقدات «الدواعش» اللاهوتية التي وإن كانت تجيز من ناحية أولى كافة أعمال القتل الجماعي البربري لدوافع جهادية عبر التفخيخ الانتحاري بالأحزمة الناسفة، إلا أنهم يحرمون في الوقت ذاته الانتحار الفردي العبثي ما لم يكن الهدف منه إحداث أكبر ضرر ممكن بالعدو..
وعموماً، وبما أنه لا جدال هنا حول وضوح المآلات السياسية والاستراتيجية من وراء هذه العملية التي أفاض الرئيس الأمريكي جو بايدن في الحديث عن تفاصيلها خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب الغارة بقدر إفاضته أيضاً وفي سياق المؤتمر الصحفي ذاته في الحديث عن والدته التي كانت تقله للمدرسة في طفولته وعن أقرانه السود من زنوج أمريكا وإحساسه المبكر آنذاك بإنسانيتهم المعذبة؛ وذلك انطلاقاً من توقيتها الدقيق، أي العملية، وارتباطها بمجرى الأحداث والتحولات الجارية في المنطقة، والتي يمكن استشرافها بوضوح من خلال تشخيص السيد بايدن للعملية التي أسفرت، من منظوره، عن إزاحة زعيم تنظيم الدولة الإسلامية عن ساحة المعركة.
ومع أنه لم يشر هنا إلى إزاحة أو حتى احتمالية إزاحة التنظيم نفسه، ما يعني عملياً، أو ما يفهم حرفياً من تصريحه إن جاز التعبير، بقاء التنظيم الإرهابي ذاته فاعلاً ومؤثراً في الساحتين السورية والعربية، كون هدف العملية الأمريكية الأساسي يتمحور حول القضاء على شخص القرشي وليس الكيان الهرمي لتنظيمه التكفيري «داعش»، ما يؤكد بوضوح أن الهدف من مقتل القرشي هو ذاته الهدف الكامن أصلاً وراء مقتل سابقيه من قادة الحركات والمنظمات الإرهابية على غرار الزرقاوي وبن لادن والبغدادي.. والمتمثل في شقه الأول بالتمويه والتعمية على طبيعة الدور التاريخي الذي لعبه ويلعبه باستمرار الأمريكان وأعوانهم من الأنظمة والدويلات الانبطاحية في المنطقة العربية باللعب على ورقة «الإرهاب الديني» عبر تورطهم المباشر والعلني في أحيان كثيرة بإنشاء وتكوين وتوجيه وتمويل هذه المنظمات والمليشيات التكفيرية على اختلافها لتنفيذ أجنداتهم السياسية والإخضاعية، بالإضافة إلى إيجاد الذرائع والمبررات اللازمة لإطالة أمد الوجود الأمني والعسكري والاستخباراتي الأمريكي في سورية والمنطقة عموما بدواعي «مكافحة الإرهاب».
وفي شقه الآخر بإعادة ترتيب الوضع الداخلي لهذا التنظيم الأيديولوجي بغية إعداده بشكل ملائم للدور المستقبلي المرسوم له سلفاً من قبل رعاته في الإمبريالية الأمريكية ودويلات الرجعية الخليجية والعربية، وأمور كتلك لم تعد خافية على أحد البتة، بدليل أن وجود ونشاط التكفيريين، كل التكفيريين، وأينما كانوا أو وجدوا، يكاد يكون مرتبطاً وبشكل حصري فقط في الدول والمناطق التي يعيث فيها الأمريكان وعملاؤهم غياً وفساداً.
ولعل السؤال الذي يطرأ بإلحاح في هذه الحالة يتمحور حول: أين كانت القوات الأمريكية الغاشمة والمهيأة كما هو معلن لـ»مكافحة الإرهاب» من أحداث الحسكة أواخر يناير الفائت حينما شن المئات من مقاتلي التنظيم «الداعشي» هجوماً واسعاً ومنظماً على مدينة الحسكة السورية وسجنها العمومي ليحرروا على ضوئه ما يربو على الـ800 «إرهابي داعشي»، منهم قيادات عليا في التنظيم، وقتل المئات من المدافعين الأكراد.. والأمر الأكثر إثارة للحيرة في هذا الصدد يكمن في الكيفية التي تمكن فيها الجيش الأمريكي ومخابراته من رصد وتحديد موقع أبو إبراهيم الهاشمي القرشي بتلك الدقة والكفاءة فيما أخفقت عن رصد التحركات العلنية والموسعة لمنفذي عملية الهجوم الإرهابي الهائل على مدينة الحسكة، خصوصاً إذا ما وضعنا بعين الاعتبار أن مدينة الحسكة ومحيطها واقعة كلياً تحت سيطرة القوات الأمريكية وعملائها الأكراد الذين ينشطون فيها بصورة مكثفة، وذلك على عكس مناطق شمال غرب سورية التي كانت محور عمليتهم الأخيرة لتصفية القرشي، والخالية بطبيعة الحال من أي وجود فعلي وعملياتي للقوات الأمريكية على الأرض.
في النهاية، جميعنا يدرك أنه وأينما وجدت أمريكا وعملاؤها في المنطقة وجد الإرهاب أيضاً بأشكال ومسميات مختلفة، فحينما فرضت أبجديات الصراع البارد والمحتدم الناشب ما بين إمبراطورية اليانكي من جهة وكل من روسيا والصين وإيران من جهة أخرى، حاجة الأمريكان الملحة لذراع تكفيري «مساند» لها في خوض هذا الصراع، فإنهم، أي الأمريكان، لم يجدوا صعوبة في تحويل حربهم واحتلالهم العسكري لأفغانستان الذي دام عقدين إلى هزيمة صورية ومفاجئة بصورة أسفرت بين عشية وضحاها عن عودة حركة طالبان التكفيرية وإن بقوالب جديدة وبكامل عتادها وعدتها إلى سدة الحكم، هكذا دفعة واحدة ودون مقدمات وبشكل يتنافى تماماً مع طبيعة المنطق العقلاني.
والأمر ذاته ينطبق أيضاً على الولادة الأولى لتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام والمنبثقة بصورة غير مفهومة من رحم المشروع الرجعي التآمري الذي ضرب أوائل العقد الفائت كلا من سورية والعراق، والذي مكن «داعش» وخلال فترة زمنية وجيزة، عقب ولادتها المفاجئة، من السيطرة الفعلية على مناطق جغرافية في شرق سورية وشمالي وغربي العراق توازي مساحة أربع دويلات خليجية مجتمعة.. فيما لم يسجل التاريخ قبلاً وجوداً «داعشياً» واحداً على امتداد مراحل الحكم الثوري الوطني المستقر للنظام البعثي في سورية الذي كان قد تمكن في مرحلة مبكرة من تاريخه من استئصال خطر التكوينات الإرهابية في ما عرف بـ»عملية حماة» التي شنها الرئيس الراحل حافظ الأسد في 1982، وهو الوضع ذاته الذي كان سائداً أيضاً إبان حقبة حكم صدام حسين البعثية، والتي وإن كنت شخصياً لا أستسيغها بسبب ساديتها، إلا أنها كانت خالية من أي مظاهر ملتحية و»داعشية»، بعكس ما هو قائم اليوم ومكرس على إيقاع المسعى التحرري المزعوم الذي تقوده وتروج له إمبراطورية اليانكي ومحظياتها في الخليج صوب الحضارة والحداثة المدنية والديمقراطية التي يتوق لها بشدة مواطنو الخليج دون استثناء قبل غيرهم.

.jpg)









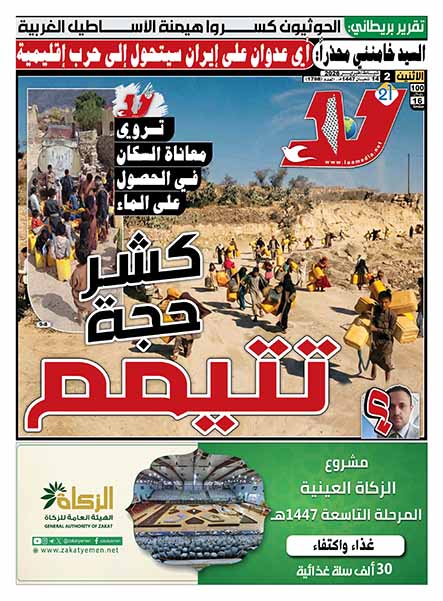






المصدر محمد القيرعي
زيارة جميع مقالات: محمد القيرعي