ثورة أيلول 2014..بين شد وجذب الحداثة والانغلاق
- محمد القيرعي الأثنين , 18 أغـسـطـس , 2025 الساعة 12:21:58 AM
- 0 تعليقات

محمد القيرعي / لا ميديا -
الحوار المتلفز الذي أجراه مؤخراً الشيخ سلطان السامعي، عضو المجلس السياسي الأعلى وعضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي اليمني، عبر قناة "الساحات" الفضائية، حوى وتخلله تفاصيل كثيرة مهمة ومخجلة في الوقت ذاته، سواء تلك المتعلقة باستشراء كثير من مظاهر الفساد المبطنة في بدن الثورة أو تلك المتعلقة بالشلل الوظيفي لبعض أهم الهيئات السيادية والتنفيذية الحاكمة، وعلى رأسها المجلس السياسي الأعلى، كهيئة جماعية مناطة بإدارة الشؤون العامة للبلاد.
وبالنظر إلى ذاك المستوى العالي والراقي من الصراحة والشفافية النادرة التي تخللت الحوار، خلف زوبعة من الجدل السياسي والنظري المفتوح الذي لا يزال مشتعلاً بمستوياته السياسية والجماهيرية الوطنية.
وإذا ما وضعنا بعين الاعتبار حقيقة أن الشيخ سلطان السامعي كان مصيباً ودقيقاً في مجمل النقاط التي تطرق إليها في حواره المتلفز ذاك، رغم أنها لم تكن صادمة البتة، وبالأخص بالنسبة لمن قدر لهم معاصرة الثورة (أيلول 2014) في مراحلها الأولى والمبكرة، على شاكلتي أنا (كعضو سابق في اللجنة الثورية العليا)، ممن كانوا على دراية عميقة بمدى تلك الشروخ الكامنة والمستشرية في بدن العملية الثورية، والتي شكلت في الواقع، ولا تزال حتى اللحظة، أحد أهم وأبرز العوائق الماثلة أمام إمكانية إلباس الثورة طابعها المدني - الدراماتيكي المثمر.
وهذا مرده بطبيعة الحال إلى طغيان واستفحال نزعة التعطيل والاستحواذ الإلغائي، المتغلغلة في وعي بعض صناع القرار الثوري، والعديد منهم من متنمري الصف الأول، ممن اعتقدوا خطأ ولأسباب ودوافع ثأرية مذهبية وطبقية أن العملية الثورية برمتها كانت في الأساس نتاج جهد وتضحيات سلالية أو مذهبية معينة بمعزل عن غيرها من القوى والطبقات الاجتماعية والجماهيرية والثورية، ما يعني أن الثورة من منظورهم الانهزامي المعتل تبدأ وتنتهي عند أقدامهم فقط.
لكن الأمر الذي لا يمكن إنكاره في هذا الصدد يكمن في حقيقة أن ذلك اللقاء الحواري مع الشيخ سلطان السامعي، ومن خلال تفاصيله المخجلة تلك، كان باعثاً للعديد من الأسئلة الحائرة والملحة حول ما إذا كانت القوى الاستحواذية نفسها لا تزال هي ذاتها المتسلطة والمهيمنة على مفاصل القرار الثوري والسياسي في البلاد.
صحيح أن ثورة الواحد والعشرين من أيلول/ سبتمبر 2014 نجحت وبدرجة مثيرة للإعجاب في تخطي العديد من العوائق والعثرات الشائكة، رغم ضراوة الظروف المحيطة بها منذ انطلاقتها الأولى، ليس أقلها الحرب الغاشمة والعدوان الخارجي البربري والمصحوب بدوامة مروعة من الخيانات والمؤامرات التخريبية المستمرة والمتوالية لقوى الثورة المضادة والمتعددة في الداخل؛ لكن تبقى المعضلة الأبرز والأكثر شيوعاً وتشعباً، والتي تضع الثورة ربما، وهذا مؤكد، أمام امتحان أخلاقي فعلي مع مبادئها، ماثلة في معضلة الفساد المستشري في بعض جوانبه المبطنة، رغم انحساره، أي الفساد، وتقلص مظاهره كظاهرة هدامة خلال سني الثورة ذاتها في العديد من جوانب الحياة اليومية للمجتمع، وبالأخص في سياق الهيئات والإدارات الخدمية الحكومية المختلفة والمناط بها إدارة وتسيير الشؤون اليومية والعامة للبلاد والمجتمع.
لكنه، وفي جوانب أخرى ومخفية عن الأعين، آخذ في التمدد والاستشراء في حواصل العديد من المراكز الثورية والسلطوية المحصنة بشكل يجعلها عصية على أي جهد تطويعي وخارج سياق المسألة القانونية، إن جاز التعبير، بالنظر إلى قدرتها وبراعتها في إدارة ماكينة الفساد بأشكال مبطنة وعالية الدقة والتنظيم، ما يجرد الثورة في ظلها ليس فحسب من أبرز سماتها الحداثية والمدنية، وإنما أيضاً من خاصيتها الأخلاقية كحدث ثوري أنتجته في الأساس الحاجة الاجتماعية والوطنية الملحة للخلاص من براثن الفوضى والفساد والتخلف الاثني الماضيوي الراسخ والمعمم بقوالبه (العسكرتارية، المشيخية، الدينية)، التي شكلت وعلى امتداد مراحل العملية الثورية الوطنية الأم سبتمبر 1962 أبرز حجرات العثرة أمام إمكانية تحقيق الظفر الثوري الحقيقي في خلق شروط السلام والتقدم والاستقرار الحضاري المأمول.
النقطة الأخرى، والمتصلة بالشلل الوظيفي الكامن في مفاصل عمل هيئات سيادية حيوية على غرار المجلس السياسي الأعلى، فإن من الأهمية بمكان على قادة أيلول 2014، وعلى رأسهم القائد الأعلى للثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، أن يدركوا في هذا المنحى أن "اتفاقية السلم والشراكة" التي تبناها "الحوثيون"، تُعد واحدة من أهم الخصائص اللوجستية لانتصار ثورة الواحد والعشرين من أيلول 2014.
وما لم يدركوا المعنى الثوري والأخلاقي البليغ لمسعاهم التحرري والتكافلي ذاك (مشروع السلم والشراكة)، وما لم يعملوا على تعزيزه كأهم الروافد الأيديولوجية الداعمة للحمة العمل الثوري والوطني الجماعي، دون إقصاء أو تفضيلات اثنية وعرقية ومذهبية، فإن الثورة ستظل مشلولة في بعض أهم جوانبها الفلسفية واللوجستية، ما قد يسهم في تعزيز الذرائع والمبررات العدوانية التي يروجها جلاوزة العدوان للنيل من وقار الثورة وشرعيتها الجماهيرية والوطنية، في سياق المزاعم ذاتها، المناطقية والفئوية والمذهبية، التي ارتكز ولا يزال يرتكز عليها مشروعهم التآمري والعدواني أصلاً منذ بدايته.
مثلما ينبغي عليهم أن يدركوا حقيقة أن الأمر الذي منح أيلول 2014 وقارها وصلابتها الحالية يكمن بالدرجة الأساس في مضمونها الحداثي المنطلق ربما وللمرة الأولى في تاريخنا الوطني الحديث من أبجدية تقديس دعوات الشراكة الجماعية العادلة والمتكافئة (مبادرة السلم والشراكة) بصورة تجاوزت فيها كل التحولات الثورية الوطنية السابقة والمنطلقة في مجملها من عقلية وعقيدة الشطب والإلغاء الكلي للآخر في سياق النزعات الاستحواذية المستعرة، بدءاً من سبتمبر الأم 1962 إلى أكتوبر التقدمي 1963 إلى شبابية فبراير 2011، وذلك مقارنة بثورة أيلول 2014 التي كانت مهمتها المقدسة تنطلق في الأساس من فرضية دفع طبقة مظلومة، مُفقرة، مُضطهَدة، مُستغلَّة، إلى صدارة الظفر الثوري والسلطوي الحقيقي، لدك دعائم الدولة العميقة التي اضطهدت أجياله على مدى عقود مظلمة انقضت.
فلماذا لا نسعى لتتويج مسعانا الثوري بتعزيز هذا المفهوم في الشراكة والعمل الجماعي الوطني كمبدأ ثوري يقوض كل تراتبية الماضي وفوضويته وتخلفه العرقي والاثني إلى غير رجعة؟!
ملاحظـــة: اتفاقيـــة السلـــم والشراكة تم التوقيع عليها في اليوم نفسه، يوم ثورة 21 سبتمبر/ أيلول 2014.

.jpg)








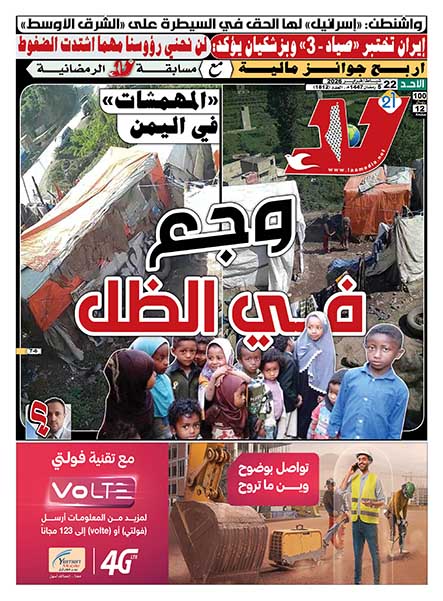
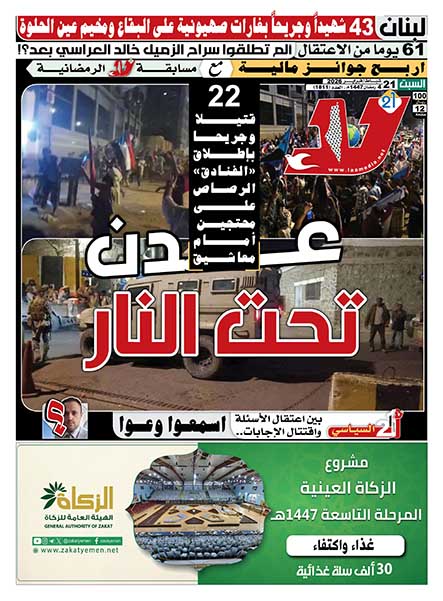





المصدر محمد القيرعي
زيارة جميع مقالات: محمد القيرعي