«الكوكلوكس كلان» على الطريقة الخونجية
- محمد القيرعي الأثنين , 10 فـبـرايـر , 2025 الساعة 12:07:03 AM
- 0 تعليقات

محمد القيرعي / لا ميديا -
(كل ما هو أسود مقدس. ولا نامت أعين الجبناء).
ذات مرة سألني أحد معارفي ما إذا كنت ملحداً بالفعل. رددت بالإيجاب. وحينما سألني عن السبب، أجبته بأنني لا أرغب البتة في أن أتشارك ديناً ومعتقداً واحداً مع هذا المجتمع البربري؛ ليس فقط لأنه جردني أنا وأقراني قسراً كـ«مهمشين» من أبسط شروط ومقتضيات الحقوق والعدالة والمساواة الإنسانية، بسبب لون بشرتنا الداكنة كـ«أخدام»، وإنما أيضاً بسبب إساءته المريعة كشعب همجي للمشيئة ذاتها التي جردها هي الأخرى وعبر مجونه التفوقي والإرهابي من أسمى قيمها ومعانيها السامية، المبنية أصلاً على مبادئ السلام والألفة والمحبة والتراحم والعدالة الإنسانية المطلقة.
وهذا ما يدفعني إلى الاعتقاد والجزم بأن القدير سيتفهم أسبابي ودوافعي الإلحادية، حين أمثل بين يديه في يوم سأتساوى فيه بالتأكيد كما يشاع مع كل جهابذة الحداثة والإرهاب معاً، وخصوصاً منظري الإرهاب الديني والفقهي والعشائري، أمثال الحزمي والزنداني والحجوري وجميع آل الأحمر شيوخاً وعساكر.
وذلك من منطلق حقيقة ثابتة، وهي أن الإرهاب الديني الذي عمموه، والذي يغتال الوطن والمجتمع منذ عقود دون هوادة، لا يختلف بأي حال عن نمط الإرهاب العبودي الذي يطالنا «معشر الأخدام» على مدى خمسة عشر قرناً مضت؛ باستثناء الفارق التكتيكي الوحيد الذي يميز ما بين تلك الأشلاء التي تتناثر بين الحين والآخر على وقع صرخات التكبير وهدير الفتوحات المنطلقة من حناجر القتلة العقائديين المندفعين بثبات من حواصل القاعدة والإخوان، وبين وسائل السحق التي تطالنا وبانتظام أيضاً «معشر الأخدام»، والتي لا تتطلب في الواقع مثل تلك الصرخات التكبيرية الممهدة لزمجرة المفجرين الانتحاريين؛ إذ يكفي في هذا الصدد أن يوقِع سوء الحظ أيّاً منا في طريق قبيلي جائع يحتزم جنبية ويتمنطق بندقية في طريق مهجور، ليجد أن نهايته في هذه الحالة كمهمش قد تكون أسوأ بكثير من نهاية أولئك الذين يقضون تباعاً باسم المشيئة على يد أتباع ومريدي الزنداني والحجوري ومن والاهم.
وفي حين أن معضلة الإرهاب الديني (التي تعد حديثة العهد إذا ما قورنت بمحنة العبودية التي تمتد جذورها لما يقرب من خمسة عشر قرناً مضت)، والتي يمكن حلها بصورة جذرية ومؤكدة (أي معضلة الإرهاب الديني) متى ما امتلكت الأمة وعبر صناع قرارها السياسي الجرأة الكافية لتجفيف منابعها النظرية والفكرية، عبر تكميم أفواه الحزمي والحجوري وبقايا أتباع الزنداني ومريديه، واجتثاث منابرهم الدعوية والتكفيرية على غرار جامعة الإيمان مثلا وما شابهها؛ إلا أن مثل هذا التفاؤل لا ينطبق ولا يمكن أن ينطبق بأية حال على أي جهد أو مشروع وطني محتمل (مع أنه غير وارد البتة) حيال مأساتنا التاريخية كمهمشين بغية الحد من آثار ورواسب المعضلة العرقية والعنصرية الموروثة، والتخفيف من عناء العبودية التي تزداد عنتاً وتشعباً.
لأن مفهوم الكراهية العرقية المتجذر في وعي الجميع (سلطة ومجتمعاً ونخباً سياسية ومدنية وفكرية وعشائرية ودينية) هو الذي يفوز دوماً بكل بساطة، لدرجة أن بعض أدوات الاستبداد المكرسة والسائدة ضدنا كفئات مقصية ومستضعفة، باتت تشكل اليوم تجسيداً مشابهاً للأنماط والوسائل الاستئصالية ذاتها التي كرستها على سبيل المثال منظمة الكوكلوكس كلان ضد أقراننا من زنوج الولايات المتحدة منذ منتصف القرن الثامن عشر، بالنظر إلى فورة الجرائم العرقية المرتكبة تحديداً، وبصبغتها الخونجية الخالصة خلال سني الحرب الراهنة، على غرار تلك التي طالت العديد من ناشطينا ورجالاتنا، أمثال الشهيد سعيد شكير الزعزعي، والشهيد حمادي الصوملي، وهذان تحديداً من القيادات الميدانية الرائدة لحركة الدفاع عن الأحرار السود في اليمن، بالإضافة إلى العشرات غيرهم ممن لا يتسع المجال هنا لذكرهم.
وتجدر الإشارة إلى أن جل ضحايا طفرة الإرهاب العرقي الخونجي تلك كانوا تواقين أساساً للارتقاء بفئاتنا المهمشة إلى مشهد إنساني أفضل، ولم يكونوا من صنف بلاطجة الإصلاح. كما أن أيّاً منهم (أي الضحايا) لم يسبق أن أدين قبلاً بارتكاب أية جنح جنائية، أو تورط حتى بمخالفات أنظمة السير، كذريعة بررت انهمار نيران الكراهية الخونجية عليهم بتلك الصورة الموغلة في الوحشية، فيما السلطات القضائية والأمنية في المحافظة والمديرية مشغولتان من جهتهما بإعداد لوائح بأسماء من ينبغي اعتقاله، ومن ينبغي قمعه وإخراسه، من شباب وأفراد هذه الفئة المهمشة التي لا وزن لها ولا حول ولا قوة ولا قيمة معيارية إن جاز التعبير.
إنه في الإجمال قتل مجاني متعدد الأوجه وقائم على الهوية، ذاك الذي يطالنا اليوم بجرم لون بشرتنا الداكنة، وبسبب تلك القيود الدونية اللعينة المتدلية من أعناقنا منذ لحظات ولوجنا الأولى والمقيتة لهذا العالم الموبوء بوسخ القبائل وكراهيتهم اللامتناهية لإنسانيتنا المستضعفة.
فنحن نقتل لأسباب نجهلها، ونحرم في الوقت ذاته من الحق في اكتساب ذواتنا ومكانتنا العادلة في المجتمع، ومن حق الرعاية الصحية والخدماتية الحكومية والأهلية، ونجرد من حقوق الحماية والإنصاف القانوني العادل، ولأسباب نجهلها أيضاً.
إننا مجتمع تأسس في الأساس على أبجديات العنصرية. وإذا كانت وقائع استهداف شبابنا ورجالنا وناشطينا بتلك البربرية التي تتسق تماماً مع هذه الحقيقة التي تؤرخ لنماذج الإلغاء الحية التي ما ننفك نعانيها «معشر الأخدام» جيلاً بعد جيل منذ خمسة عشرة قرناً مضت، وإن اكتست في بعض مراحلها التاريخية (أي العنصرية) بنوع من الحداثة الدينية تاريخياً مع انبلاج عصر الإسلام والمدنية حالياً، بكل ما يعتريها من زيف وابتذال وتشوه يعجز في الواقع عن حجب وإخفاء الخصال والتفاصيل الكارثية لوسائل التنكيل العرقي التاريخي الذي يستهدفنا على صعيد العلاقات العنصرية السائدة والموروثة.
إلا أنها، ومن الناحية الموضوعية، تؤكد صحة التأويل النظري الذي لخصه الرفيق لينين في موضوعاته الماركسية حينما أشار إلى أنه «ليس للأعراق والفئات الاجتماعية الأدنى والضعيفة وطن بالمعنى المجاز في ظل أنظمة الاستبداد السياسي والاجتماعي».
* كوكلوكس كلان: جماعة عنصرية متطرفة برزت بعد الحرب الأهلية الأمريكية، قامت على الإيمان بتفوق العرق الأبيض، ونفذت هجمات دامية ضد السود والمتعاطفين معهم على مدى 151 عاما، وكانت قد تأسست كجماعة عنصرية في العام 1866 في مدينة بولاسكي بولاية تينيسي بالوسط الشرقي من الولايات المتحدة. ويعود أصل مصطلح أو تسمية الكوكلوكس كلان إلى الحضارة اليونانية، وتعني حرفيا «الطوق» أو «الدائرة».

.jpg)









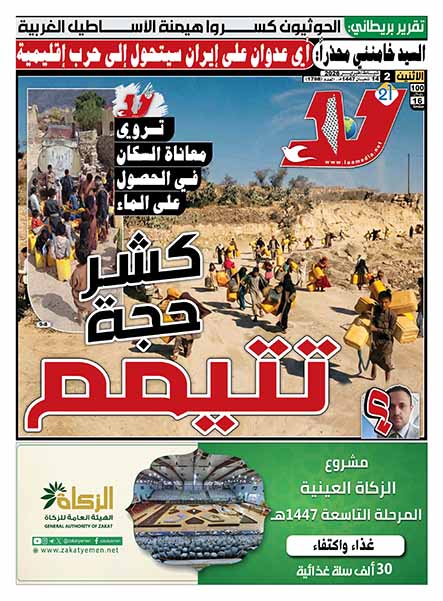






المصدر محمد القيرعي
زيارة جميع مقالات: محمد القيرعي