دمشـــق.. غيمة عطـر شقراء وموال نشيج أخضر
- رئيس التحرير - صلاح الدكاك الأربعاء , 15 فـبـرايـر , 2017 الساعة 8:33:16 PM
- 0 تعليقات
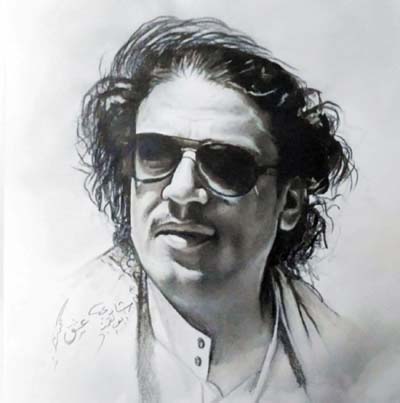
صليل السيوف ودحرجة العجلات وصهيل الجدائل
دمشـــق.. غيمة عطـر شقراء وموال نشيج أخضر
صلاح الدكاك / لا ميديا -أجاهد للخروج من دوامات ضفائر الحرير المنقوعة بالسحر والجدائل اللاهثة كسنابل (تُركت بغير حصادِ)، والشموس المندلقة بغطرسة على الأرداف والمسترخية بفتور قاتل على وسائد وثيرة من الصدور الدمشقية المتوثبة كمقدمات الجيوش العربية الفاتحة في العصر الذهبي.
أجاهد للخلاص من دوامات (الجينز) وسراويل الـ(سبورت) الطويلة والقصيرة والأسود المكشوف من كتفيه وأقواس قزح المعقودة حول الخصور والصدور والأقدام الدافقة كجداول من الحنين في الأحذية المقصبة.. أركض بحثاً عن لحظة هدوء بعيداً عن صليل الأساور المتزلجة على معاصم أشبه بمقابض سيوف حمدانية.. وبعيداً عن هسهسات الحَلَق الطويل من الآذان المُقوَّسة كالأهلَّة .
كيف أستطيع أن أكتب عن قباب الجامع الأموي، وقباب الياسمين تعترض طريقي وترشقني بألف دعوة مُغرية للكتابة عنها، والنهود تتقاطع من حولي كما تتقاطع حبات الكرز والمشمش حول عود نحيل؟!
في دمشق يجب أن تكون عاشقاً لكي تكتب! وفي دمشق يصبح المرء عاشقاً بالضرورة، وتصبح الكتابة حالة عشق، وتجبرك المدينة على أن تنظر إليها بعيون تَعْمَى عن الشوك وتتسع لحقول الورد والدِّفلى ومزارع الدرَّاق والأجاص وغابات الصنوبر فيها..
ودمشق هي امرأة حسناء مستبدة تصفف شعرك الأشعث، وتغسلك من بداوتك، وتعلمك كيف تبدو أنيقاً، ثم تأمرك بأن تنحني لها لتُسمعها عبارات الإطراء وقصائد الغزل.. فتنحني طوعاً أو كرهاً، وتغدو شاعراً ومحباً رغماً عنك...
ودمشق هي (وَلَّادةُ بنت المستكفي) الأميرة المسكونة بالعشق والشعر والغرور، وسليلة المعالي التي تتيه في مشيتها غنجاً ودلالاً، ولا يمنعها ذلك من أن تمنح ورد خدها لأول دعوة قطاف يتقدم بها عابر طريق، ومن أن تُسَلِّم ثغرها لمن يشتهي التقبيل، لكنها تحتفظ دائماً بقلبها لها، وتضنُّ به على الجميع، ومن بينهم (ابن زيدون)!
ودمشق هي (الموناليزا) التي يُبرعم الحُزن على شفتيها ابتسامة آسرة، ولا تشفُّ ابتسامتها عن حُزنها، وهي الأنثى التي تَرَبَّى على ذراعيها أول وآخر الذكور، ولقنتهم أبجديات الكتابة والزراعة والفن والسياسة، وأعطتهم الدروس الأولى في الحب والحضارة، وذوى على جسدها لهب منجنيقاتهم، وأبقت على راية الأنوثة مرفرفة عبر العصور.
قبضات نتفت أهداب القمر
أصحو على إيقاع موال مترع بالشجن يمطر أثير الغرفة من مكان ما كنت عاجزاً عن فك حروف اللغة التي يصدح بها الصوت، وتبين أنه قادم من تلفزيون صالة الاستقبال في الفندق الذي أنزل فيه.. موال يشيع في نفسك الحزن.. حزن لذيذ وعميق عرفت في ما بعد أنه موالٌ كُرْدِيّ، وخلال الأيام التالية صار من المألوف أن أصحو على إيقاع موال مشابه تبثه القناة الكردية قبل الشروع في برامجها اليومية، ويواضب (محمد) العامل في الفندق، والذي ينتمي إلى منطقة القامشلي، حيث أغلبية الأكراد، على سماعها كوجبة صباحية يتناولها بإطراق وخشوع، مفتَتِحاً يومه بها. إنها نشيده الوطني غير الرسمي.
في الجزيرة العليا وإقليم دجلة ومدينة القامشلي من محافظة الحسكة لواء الخابور على حدود سوريا مع تركيا والعراق، تقطن غالبية أكراد سوريا، كما تعيش مجاميع منهم في جبال الأكراد محافظة حلب، وهم يدينون بالإسلام، وينتمون إلى المذهب السُّني، ويشكلون حوالي 8% في مقابل 65% من العرب السنة و12% من العلويين و8% من المسيحيين؛ بينما يشكلون حوالي 5.4% من مجمل تعداد الأكراد في سوريا والعراق وتركيا مجتمعين.
وعلى الرغم من النظر إلى المسألة الكردية على أنها قنبلة آيلة للانفجار في أية لحظة، مهددةً أمن 4 دول يعيش الشعب الكردي مبعثراً على أطرافها، إلا أن احتمالات انفجارها تبدو ضئيلة جداً في سوريا، ليس فقط لأن الحكومات السورية المتعاقبة كانت أكثر مرونة في التعاطي مع المسألة الكردية، وأكثر قدرة على احتواء القومية الكردية في النسيج العربي السوري، مع عدم إلغاء خصوصياتها وثقافتها الأصلية، بل لأن الأكراد هناك كانوا ولايزالون يرون في سوريا الملجأ الذي هربوا إليه دوماً من اضطهاد الأتراك والفرس لهم؛ علاوةً على أن حلم قيام دولة كردية مُكَرَّسٌ في الأساس على كردستان في تركيا التي شهدت في مراحل متفاوتة حملاتِ إبادة للأكراد على أيدي التُّرك، في حين كان وقوعهم ضمن حدود سوريا حصيلة لاتفاق فرنسي - تركي، إبان انتداب الأولى لسوريا عقب الحرب العالمية الأولى عام 1921م، والمعروف باتفاق (أنقرة).
وتشير أدبيات (حزب البعث السوري) على حقِّ الأكراد في تَعَلُّم لغتِهم، وأكثر من ذلك حقهم في الحكم الذاتي إذا كان هناك ما يسنده، وحسب مقالة لخالد فياض في مجلة (السياسة الدولية) العدد 135 يناير 99م، فإن الممارسات السلبية التي مورست ضد الأكراد في سوريا (في بعض العصور) تعرضوا لها بوصفهم معارضين لا أكراداً... وعرف النضال ضد الاحتلال الفرنسي لسوريا أسماء كردية بارزة طالبت بالاستقلال ضمن الوحدة السورية، وفي الانقلابات العسكرية الأولى لمعت أسماء مثل (حسني الزعيم وفوزي سيلو وأديب الشيشكلي)، في خمسينيات القرن العشرين، وجميعهم من أصول كردية.
إن وضع أكراد سوريا قد يكون مطمئناً للأسباب السابقة، غير أن ضمانات أكبر تبدو مطلوبة، لاسيما عقب أعمال العنف التي شهدتها مدينة (القامشلي)، مطلع العام الحالي، بين مشجعين عرب وأكراد في (ستاد المدينة الرياضي)، والتي أثبتت أن من غير المستبعد استخدام ورقة الأكراد في الضغط على سوريا - على نحو ما- مباشر أو غير مباشر، مهما كان أكراد سوريا يتمتعون بوضع أفضل بكثير منه في دول أخرى؛ كما ليس مستغرباً أن يتم ذلك بالتزامن مع فرض العقوبات الأمريكية رسمياً على دمشق.
أُمعن النظر في وجه (محمد الكردي).. بماذا تختلف هذه الملامح عن ملامح السوريين؟! لو لم يخبرني بأنه كردي لما اكتشفت ذلك.. إنه دمشقي الوجه واليد واللسان.. في إحدى المرات سألني إن كنت قد زرت ضريح (الناصر صلاح الدين)، فأجبته: نعم زرت ضريح هذا الكردي الذي وحَّدَ العرب واسترد (القدس)، كما تجولت في شارع الملك العادل الأيوبي الكردي أيضاً، وآخر ملوك دولة بني أيوب.
إنني أنتمي إلى ذلك العصر الذي يستيقظ الآن كالعنقاء في ذاكرتي، ويشتعل عنفواناً في دمي مع كل خطوة أخطوها في ثرى الشام، ذلك الزمان الذي كانت فيه القوة عربية والثقافة عربية والعدل عربياً والظلم عربياً والأرض عربية والسماء عربية، وكان الانتماء إلى العربية غايةً يَزِنُ العظماء بذؤابات سيوفهم لحظات الشرف في سبيل نيلها.
إنني أنتمي إلى ذلك العصر الذي يَكْبُرُني بمئات السنين.. أنتمي إليه بكل أمجاده وحماقاته، بكل نبله وانتهازيته، وبكل حضارته وبربريته.. أنتمي إلى تلك القبضات التي نتَّفت أهداب القمر، وزرعت سيوفها في عيون الشمس بدعوى الفتح أو بدعوى التوَسُّع، وبـ(قميص عثمان أو بدم الحسين).. إنني أُمَوِيٌّ كما أنا عباسيّ.. هكذا تَأكَّد لي في دمشق وأنا أطالع صفحات الماضي على ثرى حاضرٍ محاصرٍ باحتلالين: أمريكي في الشرق وصهيوني إسرائيلي في الجنوب، ومهددٍ باحتلال وشيك.
مثاوي الموتى تتنفس حياةً
دمشق المكان مدينة لا تزال تعيش في جلباب الأمس العتيق، على الرغم من حواجبها المُزَجَّحَة وأحمر الشفاه على شفتيها، وعلى الرغم من أطنان الجينز التي تمشط شوارعها وأزقتها على مدار الساعة، ووسائل وأدوات العصر التي تسرَّبت لتأخذ مكانها في كل ناحية من نواحي الحياة فيها.
وحين أتحدث عن دمشق الأمس، فإنني أعني تلك المساحة المدروزة بسور روماني تتخلله 7 أبواب: باب شرقي؛ باب الجباية؛ باب كيسان؛ الباب الصغير؛ باب توما؛ باب الجنيق؛ وباب الفراديس؛ ويمنح المدينة شكلاً مستطيلاً تبعاً لنمط الرومان في تصميم معسكراتهم وتسويرها. إن هذه المساحة تحديداً هي الماضي الذي تنتشر دمشق الجديدة خارجه في حلقات تتسع يوماً عن يوم؛ انتشار الحجيج حول الكعبة.
لقد اندثر سور المدينة تدريجياً بمرور العقود، وتحت ضراوة الضربات التي تعرض لها، ولعل أشهرها تلك التي صاحبت اجتياح العباسيين للمدينة سنه 750م؛ كما أُدخلت عليه بعض التعديلات، فأخذ شكلاً بيضاوياً إبان الحُكم العُثماني، وكل ما تبقى منه اليوم هو واجهةٌ بطول 500 متر، في حين لا تزال مُعظم بواباته باقية حتى اللحظة، علاوة على بابين اسْتُحْدِثا في عهد الدولة الإسلامية، هما باب السلام وباب الفَرَج.
إن اندثار القلاع والحصون والأسوار قد يعني اندثار التاريخ بِرُمَّته بالنسبة لمدينة ما.. لكن ذلك لا يسري على دمشق، هذه المدينة التي لا يقتصر تاريخها على تلك التركة الرسمية التي يخلفها الحُكام والقادة وراءهم في العادة... فعلاوة على هذه التركة، هناك تركة شعبية خلقها إنسان دمشق البسيط، ونفخ فيها من جمال روحه، فَضَمِن لها ديمومتها وتَجَدُّدَها في الزمان والمكان، لذا فإن الحديث عن تاريخ دمشق هو حديث عن بائع العرقسوس ذي البنطال الأسود الفضفاض والقميص المُذهَّب والطربوش والشوارب المفتولة، بإبريقه الضخم الذي يتمنطقه على ظهره وينحني معه ليصب لك كأساً..
وكما هو حديث عن الوليد بن عبدالملك، هو حديث عن البيوت الدمشقية بِفُسْقِيَّاتِها ونوافيرها وأشجار الليلك المُعرِّشة في بهوها، وبزجاج سقوفها الملوَّن، كما هو حديث عن قصور بني أمية. إنه حديث عن تاريخ يتجوَّل حافي القدمين في أزقة حي مئذنة الشحم والشاغور وسوق الحميدية ومدحت باشا، وفي الخانات والحمامات العتيقة، ويجلس ليلعب (النرد) ويدخن (الأركيلة) في مقهى ينزوي بتصوُّف تحت قوس حجريٍّ معقود عند مدخل حارة دمشقية معمورة بحميمية الوقت وبالألفة والدفء.
من هنا مر الأمويون والعباسيون والفاطميون والسلاجقة والأتابكة والأيوبيون والعثمانيون والمماليك والفرنسيون.
لا يزال الوقت مُترعاً بصليل السيوف ودحرجة عجلات المنجنيق وعرق الخيل المنهكة، وبتهامس المتآمرين ولهاث الهاربين وغطرسة الغالب وبؤس المغلوب. من هنا مَرَّ جميعُهم، وانقشع غبار فلولهم المنسحبة عن دمشق قديمةً وصَبِيَّةً، وظلت الجدران المشغولة بالمنمنمات والتكايا والقباب وشرفات القصور ملف ذكريات وماركة مسجلة باسم المدينة. تآكلت قبضات المحاربين، وظلت قبضةُ هذا العجوز الذي ينقش بالمطرقة والإزميل تفاصيل روحه على جسد آنية نحاسية مُوَقِّعَاً لحنَ حياةٍ لا تشيخ.
أتسكع بالساعات في شوارع وأزقة وأسواق دمشق القديمة، بقدمين تتهجَّيان أبجدية المكان؛ تلثغان وتتعثران وتخبطان بلا غاية سوى التسكع ذاته.. يحدث أن يفضي بي تسكُّعي إلى مقبرة.. حتى مثاوي الموتى هنا تتنفس حياةً، وتمتزج فيها الرهبة بالجمال.. جمال يطالعك من الأضرحة المسقوفة بعناية، ومن الشواهد الرخامية المحمَّلة بِسِيَر موجزة عن حياة الراحل وبقصائد رثاء وكلمات نعي حُفِرَتْ عليها بخط جميل ومنسق، وتحثك على زيارة سكان هذا العالم. إنها مقابر تُغِيِّر فكرتك عن الموت، وتجعله يبدو بمثابة استجمام قصير في مصيف مؤثث بالهدوء تتشوق لقضاء إجازتك المقبلة فيه.. من السهل أن تلاحظ أثر الثقافة المسيحية على تصميم المسلمين لمقابرهم واضحاً في هذه العناية التي يرجع إليها السبب - ولا ريب - في أن أولى الصور التي التقطُتها في دمشق كانت لمقبرة تقع عند الباب الجنوبي للمدينة، وعنه أخذت التسمية مقبرة (باب الصغير)، وفيها ترقد جثامين الأمويين، في تجاورٍ وادعٍ مع جثامين آل البيت.. ففيها - كما يذكر ابن بطوطة - دُفِنَ معاوية بن أبي سفيان وعبد الملك بن مروان وبلال الحبشي وأبو الدرداء والسيدة سُكينة بنت الحسين صاحبة أقدم وأشهر صوالين الأدب النسوي العربية، وفي المقبرة يرقد أيضاً علي بن عبد الله العباس وجعفر بن الحسن وخديجة بنت زين العابدين.. أسماءٌ ملأت الدنيا ضجيجاً وترقد الآن بسكون. أنسحبُ أنا حتى لا أفسد عليها سكونها...
عند مدخل البوابة يجلس قَيِّمُ المقبرة العجوز على مقعد حديدي نخره الصدأ.. أدُسُّ في راحة يده المعروقة قطعةً نقدية فئة 10 ليرات.. تُرى كم دينارٍ ذهبيٍّ كان سيطلبه الحاجب مقابل تسهيل دخولي إلى بلاط أمير المؤمنين معاوية.
في الخارج ينتظرني نهارٌ صيفيٌّ طويل وسؤالٌ حائر: ما هي المحطة القادمة؟ ولكن هل كانت هناك محطة سابقة لتكون هناك لاحقة؟ لقد كنت أتسكع فحسب، ولا خيار إلا أن أواصل التسكع! فمنذ البدء تركت لهذه المدينة حرية اختيار الأسماء والأمكنة التي ترغبُ هي في أن أزورها! والمشاريب التي تُفضل أن أشربها! تركتها تتعرى في حدود ما ترغب هي في أن تُريني منها، لا في ما أتوق أنا لرؤيته وبلا حدود! لم أخطط لاقتحام المدينة كما فعل (خالد بن الوليد والجَرَّاح)، ولم أحاصرها بالخيارات العربية الثلاثة الشهيرة: الإسلام أو الجزية أو الحرب. كنت ديمقراطياً للغاية معها، وكانت دكتاتورية للغاية معي.. كنت مكاشفاً وكانت باطنية تماماً كبيوتها. يقول الروائي السوري (خيري الذهبي) إن توالي النكبات والصراعات التي شهدتها دمشق، جعلت من إنسانها باطنياً، وقد عكست باطنيتُه تلك نفسها على معمار البيت الدمشقي؛ هذا البيت الذي يطالعك من الخارج بجدران قاتمة عبوس لا تُفصح عما يَدَّخِرُه خلفها من جمال باذخ وإشراق وثير، و.. هذا تماماً ما لمسته في منزل (نزار قباني)؛.. تعرفون هذا الرجل، أليس كذلك؟
في ضيافة قباني
من فضلك كيف أصل إلى حي مئذنة الشحم؟!
والله ما بعرف!!
هيدا الإسم أنا سامع فيه بس وين ؟ ما بتذكر ؟!
حي مئذنة شو ؟!
إنه الحي الذي ولد فيه الشاعر نزار قباني!!
أيوه أيوه بعرفه هيدا الزلمة كان بيكتب كلام حلو.." .
يحضرني وأنا أتلقى هذه الردود مثل شعبي يقول "العود عند أهله حطب" لذا فلا غرابة أن تجد في دمشق من لا يعرف شيئاً عن "نزار قباني" سوى أنه " زلمة بيكتب كلام حلو"..مجرد كلام لا يختلف كثيراً عن ذلك الذي يتغنى به "علي الديك الشهير بعلُّوش" وبالمناسبة فقد حدث أن اقترب مني أحد الأطفال لا يتجاوز عمره الثامنة بينما كنت أطالع صوراً لفنانين في فاترينة محل كاسيت وسألني وهو يشير إلى صورة أحدهم بتعرف هيدا مين!؟ كان كمن يتحداني ويختبر علاقتي بجديد هذا العصر وبدا غير مُصدِّق حين أجبته بأني لا أعرفه وكانت تلك هي الحقيقة التي أستحق عليها سُخريته وشماتته وهو يرد عليَّ بإعتداد هيدا "علوش إش لون ما بتعرفه!؟". يا لها من معلومة ثمينة يقدمها هذا الطفل لي وفي وقت لاحق أضاف إليها سائق تاكسي معلومات أخرى ثمينة عن هذا الفنان: إنه مُعَاقٌ وقد خضع لعملية باهظة القيمة ليتمكن فقط من أن يقف على قدميه أثناء تصوير فيديو كليب أغنيته الأخيرة؛ ويمكن للمشاهد أن يلحظ أنه لا يغادر موقعه ولا يتنقل خلال مشاهد الأغنية التي قفزت به إلى مصاف المشاهير بعد أن كان مجرد فنان شعبي يحيي حفلات العرس في أرياف سوريا .أما المعلومة الأثمن فهي أن "علي الديك" بدأ حياته مُهرباً وقد تعرَّض لطلقات نارية في إحدى المرات كانت السبب في إعاقته الحالية!
لكن من يدلني إلى حي مئذنة الشحم حيث منزل نزار قباني؛ هذا الطفل الذي أحبَّ دمشق كما لم يحبها أحد وحملها معه في كل أسفاره أينما حل وحيثما إرتحل:
"مضى عامان يا أمي على الولد الذي أبحرْ
برحلته الخرافيةْ
يخبئ في حقيبته صباح بلاده الأخضرْ
ويحمل في ملابسه طرابيناً من النعناع والزعترْ
وليلكةً دمشقيةْ
مضى عامان يا أمي
ووجه دمشق عصفورٌ يُخَرْبِشُ في جوانحنا
وينقرنا برفقٍ من أصابعنا
كأن مآذن الأموي قد زُرعت بداخلنا.. ".
تلك هي مئذنة الشحم أشار العجوز الجالس على مقهى شعبي في الشارع الذي تقع المئذنة فيه على مبعدة خمسين متراً منا وقال: عمن تبحثون هناك ؟! عن منزل قباني أخبرته أنا ورَدَّ بأن أسرة قباني كبيرة ومتشعبة لكنّنا في المكان الصحيح. شكرته وانصرفت. لم أرغب في أن أستدل على العنوان دفعةً واحدةً. أحياناً يروق للمرء أن يتوه أن يسأل ويتحرى ويطرق الأبواب المغلقة ويستوقف عشرات المارة ويتلقى الإجابة على شكل نِتَف صغيرة وقُصاصات يجمعها في الأخير ليحصل على وجه المعرفة التي يلهث خلفها. أمقت الإجابة التي تشتريها من أقرب بقالة كما تُشْتَرَى مساحيق الغسيل وعُلب السجائر المستوردة؛ كما أمقت المعرفة المبيعة بالجملة ومنذ البدء قررت أن استسلم لشعوري بالتوهان وأن أغرق في شبر ماء هذه المدينة التي تبدو للوهلة الأولى غير متوهة في سبيل أن أحصل على معرفتي الخاصة بها .
هذه هي مئذنة الشحم...مئذنة عتيقة بنيت مستقلة عن المسجد وتفصلها عنه حوالي ثلاثة أمتار هي تماماً عُرْضُ الزقاق المؤدي إلى الحي الذي أخذ عنها تسميته وعلى يسار الداخل بعد مئة متر تقريباً منزل "نزار" في زقاق ضيق لا يدل عليه. أبحث عن الحيطان التي ملأها الشاعر بفوضى من كتاباته وعن القطط الكسولات التي تنام على مداخل الحارة وعن الَّليْلَك المعرش على شبابيك الجارات.. بهذه المفردات يؤرخ الشُعراء للأمكنة التي ينتمون إليها وبهذه الفنتازيا يشدونك من أصابع روحك لزيارتها.. لا أستطيع أن أتصور دمشق بمعزل عما كتبه الشُعراء عنها:
"فرشت فوق ثراكِ الطاهر الهُدُبَاْ
فيا دمشقُ لماذا نبدأ العَتَبَاْ
حبيبتي أنتِ فاستلقي كأُغنيةٍ
على ذراعي ولا تستوضحي السببَاْ
أنتِ النساء جميعاً ما من امرأةٍ
أحببت بعدك إلا خلتها كذباْ
هذه هي دمشق نزار التي تغدو دمشق المكان بدون سلالته من الشعراء والفنانين مجرد طوب يتكدس فوق بعضه البعض بلا روح ولا نبض..
دعانا "عصام- 35عاماً "إلى فنجان قهوة في المحل الذي يملكه ويعمل فيه على بيع العطور المستوردة في الزقاق نفسه. لم يعد المنزل في ملكية قباني اليوم وكان عصام قد طلب من سكانه الجدد تسهيل دخولنا لتصوير المنزل من الداخل وخلال ذلك جلسنا نتناول القهوة... أخبرنا أن صحفيين من جنسيات مختلفة يفدون لزيارة المنزل وإلتقاط الصور له
كما سألنا عن أخبار بن وعنب اليمن وسألناه عن بلح الشام... أحاديث قصيرة ومتنوعة وغايةٌ في الود تبادلناها مع عصام قبل أن ندلف لتصوير منزل نزار قباني الذي بدا شبيهاً بإنسان دمشق القديمة في تواضع مظهره الخارجي الموارب على جوهر مشرق وأعماق مزهرة .
في هذا المنزل ولد الشاعر لأسرة يقول في كتاباته عنها إنها أسرةٌ يولد معها الحب كما يولد السكر مع التفاحة. أسرة تحترف العشق. جده أبو خليل قباني أبو المسرح الذي فرَّ بهذا الفن من اضطهاد السُلطة العثمانية الديني والسياسي وإنتقل به إلى مصر وهناك قدَّم مسرحيته الأولى "عُطَيْل" على خشبة مسرح "بني سويف" وكان من بين مشاهديه " يوسف وهبي" الذي كان صبياً يومها وكان لهذا العرض أثره في اتجاهه للمسرح والتمثيل ولعل القليلين فقط يعرفون أن نزار كان موسيقياً جيداً ورساماً وخطاطاً جيداً في مقابل الكثيرين الذي يعرفون فيه شاعراً ممتازاً عَمِل عقب تخرجه من كلية الحقوق سفيراً لبلده في عواصم عربية وأجنبية متعددة لكنه قرر إعتزال السياسة والتفرغ للشعر عام 1966م
وفي عام 97م توقف قلب الشاعر عن النبض في أحد مشافي لندن ونُقِل جثمانه ليُدفن في دمشق حسب وصية يُذَيِّلها بعبارة:" اليوم يعود الطفل إلى أحضان أمه" كانت بمثابة إسدال الستار الأخير في حياة لا آخر لفصول عظمتها
لورانس ينقذ دمشق
تحاصرك في ساحة المرجة أرتال من السماسرة والدلالين بعروض مغرية وخدمات لا حصر لها يهمسون بها في أذنك فيما يشبه الفحيح ..
فيما مضى كانت المرجة مركز المدينة أو هكذا خطط العثمانيون لتكون ففي العام 1807م إنتقل الوالي العثماني "كنج يوسف باشا" إلى المكان وبنى قصراً لسُكناه فيه ومع نهاية القرن التاسع عشر الميلادي كانت الساحة تضم سرايا الحكومة ودار البلدية و دار البرق والبريد ودار العدلية ومبنى السِكة الحديدية التي ربطت الحجاز بالشام بتركيا بأوروبا وأنفق العثمانيون في إنشائها مائتين وثلاثة وثمانين ألف ليرة ذهبية وعمل عليها فريق مؤلف من ألمان ونمساويين وعرب؛ وعلى شمال ساحة المرجة حيث يقع سوق "ساروجا" اليوم كانت تقطن الطبقة الراقية بالحي الذي عرف حينها بـ"استانبول الصغيرة" كما ضمت ساحة المرجه آنذاك كشكاً لبيع الطوابع المالية والتبغ وقد أخذت تسميتها التي تعرف بها إلى اليوم عن المرج الأخضر الذي كانت جزءاً منه وعلى هذه الساحة نفسها أعدم الكثيرون من روَّاد اليقظة شنقاً في عهد الوالي العثماني جمال باشا .
لقد تغيرت ملامح "المرجة" اليوم إلى حدٍ كبير ولم يعد هناك ما يشير إلى المكان عدا بناية أو بنايتين ربما وعدا هذا العمود البرونزي الشاهق والمنتصب في قلب المكان والذي يراودك المصورون لإلتقاط صورةٍ مدبلجة تضعك في ذروته وعبثاً تقنعهم أن مشهداً كهذا سيجعلك أضحوكة الموسم في نظر رفاق يجهلون أن هذا العمود هوَ في حقيقة الأمر نصب تذكاري أقامه العثمانيون إحتفاءً بإنجاز سكة الحديد عام 1907م و تسيير "قطار الشرق الشهير" الذي كتبت عنه "أغاثا كريستي" روايتها المعروفة "جريمة في قطار الشرق" ويحمل أعلاه نموذجاً لمسجد سراي أو قصر ((يلدز)) في إسطنبول وهذا ما ظللت أنا و رفيقي "محمد الجرادي" نجهله طوال أيام من إقامتنا هناك كما ظللنا أيضاً نجهل أن هناك فنادق مجاورة للفندق الذي ننزل فيه يحصل النزيل فيها على غرفة بثلاثة أَسِرّة وحمام مستقل مقابل مائتين وخمسين ليرة ؛ في حين عضضنا نحن بالنواجذ على غرفة بالمواصفات نفسها ولم نغادرها إلا إلى المطار معتقدين أن ستمائة ليرة قليلة في حقها. لقد اكتشفنا بعد فوات الأوان أن نصف ما أنفقناه كان يكفي لقضاء ضعف عدد الأيام التي قضيناها هناك فالمسالة تتعلق بقدرة المرء على المساومة . إن معظم الوافدين على دمشق لاسيما من العرب يقصدون ساحة المرجة في العادة نظراً لإنخفاض أسعار النزل والفنادق فيها عنها في أماكن أخرى من المدينة إذ أن أغلبها نزل شعبية وفنادق غير مصنفة علاوة على توافر عدد كبير من المطاعم التي تقدم مأكولات بأسعار مناسبة إلا أن الحصول على مثل هذه الميزات يبقى مرهوناً بالقدرة على المساومة مع الكثير من سوء الظن.
إن المحظوظين فقط يغادرون سورية بمَحافظ فيها القليل من الدولارات وبمخيلات متخمة بالذكريات عن هذه الدولة التي تبرع في فن تطهير زائريها من رجس العملات الصعبة. إنها "أكبر بلد صغير في العالم" على حد وصف البعض لها وبإستبعاد طوق الحصار السياسي الذي يضغط على خاصرة هذا البلد فإن السياحة على تنوعها ترسم بالوردي مستقبل سوريا الى جانب صناعة وطنية تشق طريقها بقوة نحو حضور مميز في الأسواق المجاورة.
لقد أسهمت سنوات الحصار الطويلة – بالأمس - في تعزيز ثقة إنسان سوريا في نفسه وفي قدراته وإمكانياته ويرجع إلى هذه الثقة الفضلُ في ما تحقق له من إكتفاء ذاتي نسبي و إذ هو يتأهب – بحذر - اليوم للتعبير عن قدراته على نطاق أوسع فإن حصاراً مقبلاً يجهض مثل هذا الطموح الحذر الذي هو أحوج إلى الاستقرار اليوم؛ أما المعجزه فستكون أن يتحقق هذا الاستقرار دون تنازلات ، أو دون الكثير منها. لقد قال وزير خارجية أمريكا الأسبق "هنري كيسنجر" إنه:لا سلام دون سوريا و لا حرب دون مصر" لكنه – ولاريب – كان يتحدث عن ذلك السلام الذي تريده أمريكا لا ما تريده المنطقة.
إن الليلة في حساب الزمن العربي تشبه البارحة فهنا بين سوريا والعراق كان "لورانس العرب" يتسكع قبل أكثر من مئة عام وينبش الصحراء العربية بحثاً عن أدلة أثرية يثبت بها تبعية الحضارة الشرق أوسطية لشعوب البحر الأبيض المتوسط الأوربية وبعد أن فرغ من مهمته كعالم آثار عاد إلى الصحراء نفسها جاسوساً في ثياب بطل وخلال ذلك أصدر أحد أهم مؤلفاته "منقذ دمشق"؛ ولم تمض سنوات على إنقاذه المزعوم حتى كانت سوريا جميعها ترسف تحت الاحتلال الفرنسي .
في أحد جوانب ساحة "المرجة" يقع مبني سرايا الحكومة العُثمانية وهو المبنى نفسه الذي شهد أول إجتماع للحكومة العربية تحت إشراف "لورانس العرب" مطلع القرن الماضي وهو الذي قاد الثورة العربية ضد الأتراك كما تحكي فصول كتابه "ثورة في الصحراء" ويُظهر فيلم "لورانس العرب" مشهداً لمجموعة من الغوغاء والسُذَّج في الاجتماع السابق يحاول "لورانس" تعليمهم أدب الحوار وإلتزام حدود اللياقة في التخاطب فيفشل.
كمواطن عربي من الصعب أن تقرأ الأمكنة مجردة من الأحداث وهذه الآثار الشاخصة والبليدة ليست سوى هزائمك وانكساراتك وإرثك المُرّ يطالعك من كل زاوية ... ينساب نهر" بردى" هادئاً وحزيناً فتشاهد في إنسيابه نهر دموع لا يكف عن الجريان. إنه جرحك القديم لم يتخثر بعد. تحضرك بيت شعر قديم لشوقي:
سلامٌ من صَبَا بردىَ أرقُ
ودمعٌ لا يُكفكف يا دمشقُ
هل يمكن للعربي أن يكون سائحاً بالفعل؟! إن سياحة العربي لا يمكن أن تكون إلا بكاءً على الأطلال؛ بكاءً على مُلك مُضاع ومُلْكٍ يضيع، مخاوفُ مُحنَّطة قديمة ،و مخاوف تتناسل.
أدخل دمشق بين آلاف الداخلين من العرب. يلهث الكثيرون منهم خلف الشُقق المفروشة وألهث خلف لاشيء يطاردني صخبُ أحذيةٍ "المارينز" القادم من "نينَوى وبابل" في الشرق ومن الغرب تغمرني أحزان بحيرة "طبريا". أشاهد طوابير السيارات العربية .. يدخل أصحابها دمشق كما دخلوا بيروت ذات يوم - بأشداق يسيل لعابها – قبل أن يفروا ويتركوها للحصار يذبحها كالدجاجةِ في الطريق .
وحدهم الإيرانيون يدخلون دمشق بمناديل دموع و موّالات نشيج.. يجلسون في حلقات نساءً ورجالاً عند ضريح "يُوحنا المعمدان - نبي الله يحيى" الواقع في قلب الجامع الأموي ويشرعون في مهرجان بكاء حار يجرح صمت المدى. أشاهد أيضاً مجاميع من طائفة "البُهرة" يمطرون المعمدان بالقبلات وعملات نقد ورقية يحشرونها في فَتحات صُممت لهذا الغرض في المقام المُحيط بهذا الضريح والمُؤلف من صفائح قُضبان مُذَهبة وزجاج سميك شفاف. تقفز إلى مخيلتي وأنا أشاهد ذلك صورةٌ لسياحة أُخرى ؛ سياحة غير دينية لكنها تشبه هذه في كونها تقوم على إنفاق القُبلات والعملات الورقية بغزارة مع إختلاف الأضرحة .
سفارة مندي
عشرون ليرة كافية لتأخذك إلى هناك!!إلى حيث تتحول إلى فراشة وتنفح روحك نسائم لا يمكن أن تكون قادمة إلا من الجنة . ينزلق بنا الباص بين التلال والمروج الصاعدة كسلالم طيفية بمحاذاة الغيم. على بعد خمسة وأربعين كيلومتراً غرب الشام تنتظرنا ضاحية "بلودان" على إرتفاع 1500متر عن مستوى سطح البحر وفي الطريق إليها استسلمتُ لحديثٍ شيق دار بيني وبين "علي حمُّو" أحد أبناء "بلودان" ؛ شاب في الخامسة والعشرين ذو بشرة لبنية وشعر ناعم غزير ويميل إلى الشقرة عاد مؤخراً من العمل في السويد ويخطط للعمل في فرنسا تَحدث بإعتداد عن نبوغ الشعب السوري وتفوُّقه وعن العقلية السورية ألتي تُساير أسوأ الظروف لكنها لا تموت حسب قوله:" نحن الشعب الوحيد الذي عجز اليهود في اختراقه لذا لم يمكثوا بيننا طويلاً"... في القرن التاسع عشر 1883م كان لليهود حيُّهم الخاص في دمشق القديمة وإلى هذا الحي نفسه استدرجوا "الأب توما - مسيحي فرنسيسكاني" يعمل بالتطبيب وهناك قاموا بذبحه وغمسوا فطائر عيدهم بدمه. إنها حادثةٌ شهيرة أقامت الدنيا ولم تقعدها آنذاك ولا ريب أنها أحد الأسباب القوية التي عززت كراهية اليهود في نفوس مسيحيي سوريا ومسلميها على حدٍ سواء. لمستُ هذه الكراهية في حديث "علي حمُّو" عنهم .في لهجته شيء ما يجعلها تختلف عن لهجة الدمشقيين وتقترب من لهجة أهالي لبنان وعرفتُ منه أن بلودان كانت جزءاً من الريف الُلبناني وفي طبيعة الحال فإن سوريا وبـ المثل الشام كانت أسماً جامعاً لكلٍّ من الأردن وفلسطين ولبنان قبل أن ينفرط عقد الدول الأربع في مؤتمر التقاسم الشهير مطلع القرن الأول ..هاهوَ التاريخ المُر يلاحقني حيثُ سرت وبلودان تقترب أكثر.
قبل آلاف السنين كانت هذه الضاحية مُستعمرة يونانية وفيها جبل اليونان كما هي تسميته إلى اليوم كما تحولت إلى مستعمرة رومانية أقام عليها الرومان معابد كثيرة إندثر جميعها تقريباً وبلودان هي في الأساس مفردة يونانية تعني أرض اللوز والتفاح ومن السهل أن تلاحظ كم أن المكان مدروز بأشجار هذا النوع من الفاكهة وتمتاز بلودان بهواء لطيف على مدار السنة وفي الشتاء تكتسي تِلالها حُلةً من الثلوج تبلغ سماكة طبقتها ثلاثة أمتار تقريباً كما تمتاز الضاحية بأنها مُلتقى الفصول الأربعة إذ يمكنك أن تُشاهد الزهور في الربيع و هي تتفتح في تلال لم تخلع معطف الثلج بعد. أطالع من التلال المُشرفة على المكان مشهداً عِشتُ تفاصيله في أغاني فيروز قبل أن أفتح عيني عليه الآن. منازل بلون الثلج تتوجها سطوح قرميدية حمراء تنزلق عليها قطرات الضوء؛ أزهار بألوان الطيف ونواقيس تتأرجح بالقرب من مئذنة صاعدةٍ نحو الله وعلى ربوة محاذية للتلال يتربع مُهيباً فندق "بلودان الكبير" هذا الفندق الذي بناه الفرنسيون عام 1935م وفيه عُقدت أول قمة عربية والأهم من ذلك أنه كان نُزلاً لعدد من مشاهير السياسة والفن من "ريتشارد نيكسون الرئيس الأمريكي الأسبق إلى جمال عبد الناصر وتشارل ديغول الرئيس الفرنسي إلى أم كلثوم وعبدالحليم حافظ ومحمد عبد الوهاب" الذي أُطلق إسمه على أحد أجنحة الفندق . يمنعنا الحرس من الدخول لتصويره إنه قيد الترميم وتشرف على ترميمه شخصية عسكرية كبيرة حالياً. يمكنكم أخذ تصريح من وزارة الثقافة بالتصوير يقولون.. لكننا نكتفي بتصويره من الخارج ونغادر بلودان ينحدر الباص بنا بتوقيت الجوع كانت الشمس قد بدأت تترنح غرباً كفتاةٍ ثملة أمالت رأسها النشوة وجدائل شقراء ثقيلة ومرهقة ..في الأسفل على مستوى النظر تقع ضاحية "الزبداني" التي ينبع منها نهر" بَرَدَى" وتنتشر فيها حقول الدُراق والأجاص والكرز والمشمش وبين "الزبداني وبلودان" يجري نبع "بِقِيْن" العذب الذي تغطي القناني المعبأة به الأسواق السورية .نقرر أنا ورفيقي محمد الجرادي أن يكون الغداء وجبة مندي.. سئمنا "فراريج المرجة" وساندويتشات الطعمية وعلى الطريق تمرق أمامناً أكثر من لافتة مطعم: هذا مندي المكلا وذاك مندي حضرموت والآخر مندي اليمن.. إنها سفاراتنا الحقيقية وغير المُعتمدة في مُقابل سفارة مشغولة جداً... بمتابعة أسعار العُملات!
كُتبت هذه المادة عام 2004

.jpg)


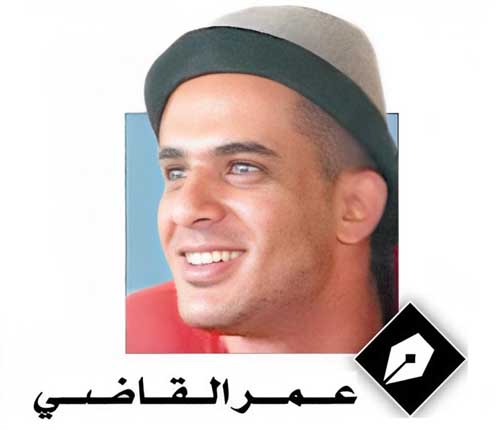





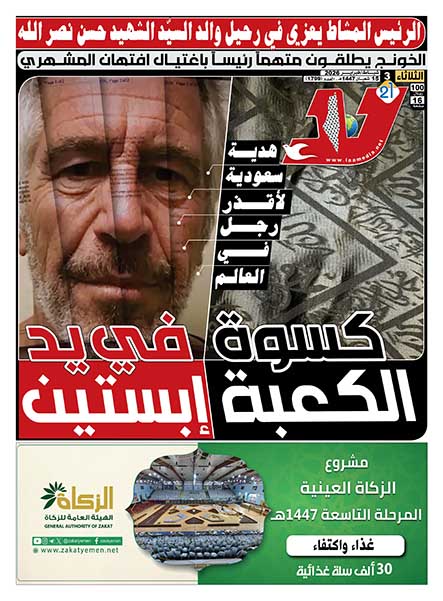
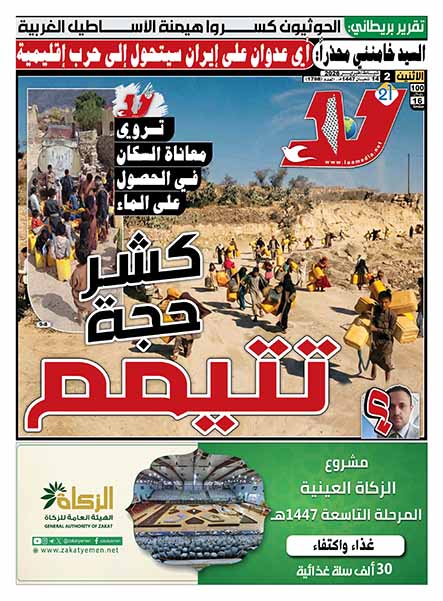



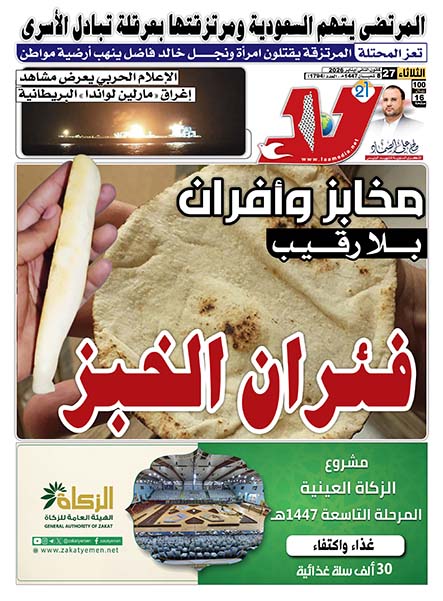

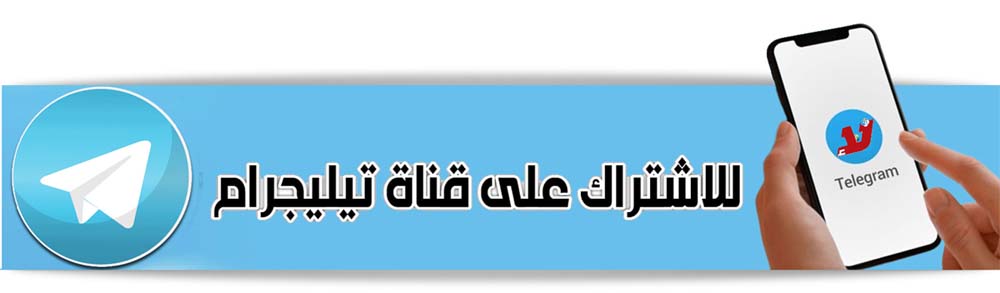
المصدر رئيس التحرير - صلاح الدكاك
زيارة جميع مقالات: رئيس التحرير - صلاح الدكاك